
بأقلامهم
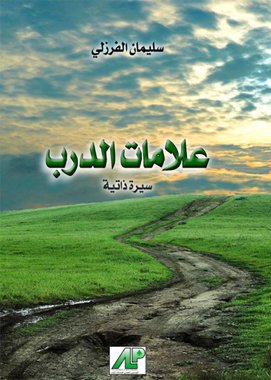
غربة ميشال عفلق
بقلم الكاتب الكبير الراحل أنسي الحاج
تعليقاً على كتاب سيرتي الذاتية “علامات الدرب”
جريدة “الأخبار” البيروتية
30 آذار / مارس 2013
خلال مطالعة السيرة الذاتيّة «علامات الدرب» للصحافي العريق سليمان الفرزلي (صدرت في لندن عن «اللبنانيّون المتّحدون للصحافة والنشر»)، استوقفتني محطّات يرفع فيها الكاتب الستار عن أسرار تاريخيّة خطيرة. عاصر الفرزلي أغنى العقود بالأحداث وعرف أبطالها عن قرب، ولا سيما منهم أركان حزب البعث ابتداءً من مؤسّسه ميشال عفلق. آخر مرّة اجتمع فيها الفرزلي إلى عفلق في قصر الرشيد ببغداد كانت عام 1975. كان مؤسّس البعث قد غادر لبنان عقب انفجار الحرب بعدما غادر سوريا عقب صدور حكم بإعدامه. وصول البعث إلى الحكم في العراق وسوريا عن طريق الانقلاب العسكري كان من مضاعفاته تلطيخ صورة عفلق. يقول الفرزلي: «أُسيء فهم أو تشويه فكرة عفلق الأمّ حول مبدأ «الانقلابيّة» لاستنهاض الأمّة. فقد خلط كثيرون وما زالوا يخلطون بين الانقلاب العسكري للوصول إلى السلطة، و«الفكرة الانقلابيّة» التي نادى بها عفلق منذ خطابه المشهور على مدرج جامعة دمشق في الخامس من نيسان 1943 بعنوان: «في ذكرى الرسول العربي». «وغنيٌّ عن القول إنّ مضمون هذا الخطاب هو من المرتكزات الفكريّة الأساسيّة لحزب البعث، إنْ لم يكن المرتكز الأساسي». ويضيف مدافعاً: إنّ «الحملات المغرضة التي استهدفت عفلق للنيل من شخصه أو من حزبه أو من أفكاره، أو حتى من السلطة التي حكمت باسمه، لم ينقطع سيلها منذ بروزه على المسرح العام ككاتب في مجلّة «الطليعة» مطلع الثلاثينات من القرن الماضي، ثم كوزير للمعارف في سوريا أواخر الأربعينات، مروراً بالوحدة (مع مصر) والانفصال، وبالسلطة البعثيّة في دمشق وبغداد، إلى اليوم بعد مرور عقدين على وفاته». ويذكر من عناوين تلك الحملات قول أخصام الرجل إنّه لم يأتِ بجديد وإنّ أفكاره مستوردة من النظريّات اليساريّة والماركسيّة، وإنّه «اغتصب اسم الحزب من المؤسّس الحقيقي للبعث وهو زكي الأر سوزي وإنّه استلهم أفكاره من تعاليم الأر سوزي (…) وبعد اتهامه بأنّه سطا على أفكار الأر سوزي (في أغلب الظنّ أنّ الأر سوزي نفسه هو الذي روّج هذا الافتراء) قالوا عنه إنّه سطا على شعبيّة الدكتور عبد الرحمن الشهبندر». وعن موقف عفلق من صدّام حسين يستخلص الفرزلي من لقائه الأخير في قصر الرشيد بمؤسّس البعث أن «عفلق كان ينظر بخوف وقلق إلى ما يجري في الحزب وعلى صعيد السلطة في العراق، ولم تكن لديه الرغبة أو الجرأة في مواجهة الأمر علناً وعلى رؤوس الأشهاد (…) كان يريد من آخرين أن يتولّوا المهمة ليقف وراءهم. وهذا ما لم يكن أحد مستعدّاً أن يفعله، خصوصاً في وجه صدّام حسين». وعن اعتناق أو عدم اعتناق عفلق للإسلام، الأمر الذي ما زال ملتبساً لمعظم المهتمّين، يقول الفرزلي، الذي تحاور مع عفلق في الموضوع مراراً في بيروت، إنّ الأخير في كلامه على الإسلام «لم يكن يقصد هذا الإسلام القائم بكلّ تفرّعاته ومدرجاته وطقوسه، بل كان يعتبر هذا الإسلام في واقعه الراهن مرضاً من الأمراض العديدة المستشرية في الأمّة. فالإسلام عنده هو الحالة المحمّديّة التي استنهضها الرسول العربي في روح الأمّة (…) أمّا الإسلام الراهن فهو صيغة للعيش في الماضي ولا تعبّر عن مستقبل الأمّة (…) كان عفلق يحلم بأن يكون البعث العربي الاشتراكي هو الإسلام الجديد ليؤدّي الرسالة التي عبّر عنها في مرحلة سابقة دين محمد. فالإسلام له ما قبله في التعبير عن روح الأمّة، وسوف يكون له ما بعده، بل تَجَسَّد فيه من ضمنه ما بعده في فترات معيّنة، وكان يعتبر أنّ البعث هو واحدٌ من هذا الما بعد من ضمنه». على صعيد المسألة اللبنانيّة، يوضح الفرزلي أنّ عفلق كان يعتقد «أن مشكلة العروبة في لبنان هي مشكلة تقدميّة العروبة»، خاتماً بالقول: «إنّ إسلام ميشال عفلق هو هذا الذي فهمته منه، سواء صحّ أم لم يصحّ ما ادّعاه نظام صدّام حسين عن اعتناقه الإسلام تبريراً لجنازة إسلاميّة على الطقوس البغداديّة، لأنّ ذلك يبقى في الشكل ولا يلامس الجوهر». يخرج سليمان الفرزلي بانطباع مؤلم هو أنّ عفلق كان يعيش غربةً روحيّة داخل حزبه. ويخرج القارئ بانطباع أشدّ إيلاماً هو أنّ عفلق كان يعيش غربةً روحيّةً داخل حزبه وداخل أمّته. وقد لا نبالغ إذا قلنا وداخل ذاته. بصرف النظر عن إسلامه أو عدمه. غربةُ المثاليّ الحالم في واقعٍ فظّ وانتهازيّ، وغربةُ المفكّر والمُنظّر في جغرافيا من الدسائس والدبّابات. لا نعتقد أنّ هناك بين عقائديي العالم العربي مَن انتشرت عقيدته وحكمت أكثر من البعث ولا مَن كان منفيّاً في انتصاره أكثر من ميشال عفلق. في «علامات الدرب» نزهاتٌ طويلة عبر التاريخ العربي المعاصر. من المنشأ اللبناني إلى رحاب الصحراء إلى مصر وروسيا وليبيا ولندن إلى حنايا الصحافة وجلاجلها. كتاب يُستحسن أن يطالعه طلّاب الإعلام وأساتذتهم والمهتمّون بالتاريخ العربي المعاصر. سليمان الفرزلي برهانٌ شائق على أنّ الصحافي يستطيع أن يكون شاهداً شريفاً ومؤرّخاً موضوعيّاً كبيراً.
صدمات المشهد السياسي والصحافي في “علامات درب” سليمان الفرزلي
بقلم بكر عويضة
موقع “إيلاف” 18 / 5 / 2013
“صيف عام 1996 كنت في جب جنين” (…) ثم إن رفيق سفر للراوي “اقترح في طريق عودتنا الى بيروت أن نعرِّج على عنجر للتحدث مع غازي كنعان، الذي كان رئيس جهاز الاستطلاع السوري في لبنان آنذاك، لكننا لم نجده في مكتبه فالتقينا بنائبه العقيد عدنان بلول” (…) وإذ دخلا عليه (وجدناه يقرأ جريدة “النهار” وبيده قلم يعلم فيه على بعض المحتويات. ولما جلسنا نتحدث طوى الجريدة ووجَّه اليَّ سؤالاً صعباً بقوله: ماذا برأيك يجب أن نفعل لكي نكسب المسيحيين الى جانبنا؟ فقلت له بصراحة، كما أصرَّ أن يكون الحديث: إنكم لن تستطيعوا ذلك مهما فعلتم). ما ورد بالفقرة السابقة مُقتَطف من خاتمة الصفحة 708 وبداية 709 بكتاب (“علامات الدرب “- سيرة ذاتية -; الطبعة الأولى: يناير 2013) للكاتب الصحافي اللبناني سليمان الفرزلي، صاحب التجربة الصحافية والمعرفية، الممتدة لأكثر من نصف قرن، والمُحلِقة في فضاءات تعددت أطيافها، أجواؤها، أزمانها، أماكنها، نجاحاتها وانكساراتها، لذا ليس مفاجئاً أن يضع كتاباً من نوع يندر أن يتكرر ما بُذل لإنجازه من جهد استغرق عامين، يقع في سبعمائة وأربع وأربعين صفحة، من دون صفحات فهرس الأعلام، ومن دون أية صورة حتى لمؤلف الكتاب ذاته. لست أدري إلى أي مدى أصبت إذ بدأت بالمقتطف الوارد أعلاه، إنما قصدت الاستهلال بأسطر من كتاب حافل بالكثير مما يمكنني اعتباره قنابل ضوئية، بما تكشف من معلومات وخفايا، أو تُذكّر بخلفيات، فتنقل القراء المتابعين لما يجري في العالم العربي منذ عامين إلى أجواء ما حصل وما قيل على مسرح الأحداث قبل سنين، وبما يشكل، في تقديري، إضافة تعين على الفهم، أو أنها، بأقل تقدير، وهذا مهم في حد ذاته، تفتح باب الاجتهاد أمام آخرين لتشريح ما أورد الكاتب، أو الرد على ما تضمن الكتاب بتوضيح يضيف فيصحح، أو يرفض فينفي، وكلا الأمرين ضروري طالما جرى اعتماد مبدأ التوثيق والابتعاد عن الغرض الشخصي. عَودٌ على بدء، هذا لبنان اليوم، كما الأمسين القريب والبعيد، يكتوي باشتعال نيران الحرائق في داخله ومن حوله، وبالمد والجزر في علاقات الجيران الأقربين وعن بعد، خصوصا في مثلث إيران- سوريا- إسرائيل. صاحب اقتراح زيارة غازي كنعان، أعلاه، هو السياسي إيلي الفرزلي، ابن عم مؤلف الكتاب. سبق الزيارة كلامٌ مهم يعود إلى العام 1981 تضمن ما يلي: (أوفدت القوات اللبنانية إلى لندن مبعوثاً خاصاً للاتصال بالجاليات اللبنانية هو المهندس ريشار جريصاتي، الذي دُعيت الى لقاء معه. وفي نقاش معه حول مسألة العلاقة مع سوريا، سألته لماذا يعادون سوريا مع أنها يمكن أن تكون أقرب الحلفاء إليهم من الناحية الموضوعية، فقال إن هذا صحيح من حيث المبدأ، لكن هذا التحالف المُقتَرَح لا يمكن أن يتم إلا إذا تقسمت سوريا وقامت فيها دولة علوية واضحة المعالم، فنكون عندئذٍ أول حلفائها. وسألته عن أسبابهم لهذا الطرح التقسيمي، فقال إن السوريين الحاكمين حالياً لديهم خطوط دفاع ليس لنا مثلها، ولا نستطيع أن نقول بها. فالحكم العلوي الراهن في سوريا، حسب قوله، بإمكانه إذا حُشر أن يرفع راية العروبة والوحدة والاشتراكية، وبإمكانه في حالات أخرى أن يرفع راية الإسلام ويجاهر بإسلاميته متخلياً عن قناعه العلماني.) كلمات المهندس ريشار جريصاني، العائدة إلى ما قبل أكثر من ثلاثين سنة، كما أوردها سليمان الفرزلي، هل تقرع أية أجراس بشأن التطور الراهن للأحداث على أضلاع المثلث السوري-اللبناني-الإسرائيلي؟ نعم، أو كلا، أمر يتوقف على أكثر من اعتبار، وبالتالي يتباين الرأي كما تباين البنادق والأفكار في المشهد الحالي. إنما لافتٌ أيضا الرد السوري على جريصاني آنذاك. يقول الفرزلي أنه روى للعقيد عدنان بلّول ما سمعه من مبعوث القوات اللبنانية، فرد بالتالي: (خطوط الدفاع التي تحدثت عنها يمكن أن تكون نافعة لهم لأننا نستعملها لصالحهم إذا اقتضى الأمر. أما بالنسبة الى المسألة العلوية فأقول إننا نحن سوريون ولست أستسيغ أن أعرف عن نفسي بأنني علوي. أنا سوري عربي ولا أحد يستطيع أن يصفني بأي صفة أخرى. لكن إذا أصرّ بعضهم على سوء نيته بإطلاق هذه الصفة، فإنني علوي على رؤوس الأشهاد ولا يغير ذلك من الأمر شيئا. إن هذه المنطقة، منطقة المشرق، ليس فيها أكثرية وأقلية، كلنا أقليات، نعم هناك أقلية أكبر من أقلية، لكن لا أحد يستطيع أن يدعي أنه أكثرية تخوله حرمان الآخرين من حقوقهم عن طريق العصبية الدينية أو التعصب العنصري.). على صعيد المشهد السياسي، تلك واحدة من روايات عدة تضمنها كتاب سليمان الفرزلي جديرة بالتوقف أمامها ومحاولة فك رموز مدلولاتها. حالة أخرى ليست تقل أهمية وما تزال تأثيرات الحدث المتعلق بها حاضرة، تلك التي تخص بشير الجميّل، الرئيس اللبناني المُنتَخب، ثم المُغيّب باغتيال لا تزال بعض أسراره غامضة، وترد في شأنه على صفحات كتاب سليمان الفرزلي “علامات الدرب” غير رواية تلفت النظر، من ذلك، ما يخلص إليه الفرزلي من لقاء فريق التحرير بمجلة “الحوادث” مع الصحافي الأميركي جوناثان راندال في لندن سنة 1983 وكان صدر له كتاب بعنوان “المسيحيون، والمغامرون الإسرائيليون، وحرب لبنان”. يقول الفرزلي إن راندال تحدَّث مطولاً عن معرفته ببشير الجميل وحركته بمزيج من الإعجاب والشك، ثم إن الكاتب سأل راندال عن لقاءاته مع بشير الجميل، ومنها لقاءات ساخنة، تردد قليلاً ثم قال:
، إن فيه سمات قيادية مميزة، لا تخلو من رعونة، وأنه صادق فيما يؤمن به، لكن فيه أيضا عرقا من السذاجة يشكل مطباً له، وما أصابه ليس مفاجئاً، لأنه لاعب صغير في لعبة كبيرة ويتوهم أنه من الكبار. ويلحظ الفرزلي ذلك السطر الأخير، فيقول لمدير التحرير، ريمون عطالله: إن ما قاله عن بشير الجميل يلقي شبهة في قتله على الأميركيين، ثم يستدرك: ” لكن ذلك يبقى من قبيل الحدس”. واقعة أخرى ذات أهمية أيضا في أمر بشير الجميل تلفت النظر، إذ تسلط ضوءاً على علاقته مع ياسر عرفات. يقول الكاتب إن القيادي الفلسطيني عطالله عطالله (أبو الزعيم) أبلغه عام 1983 “أن الرئيس ياسر عرفات كلفه بأن يكون ضابط ارتباط مع بشير الجميل خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي، ثم إن آخر مهمة قام بها في هذا الإطار أنه خلال حصار بيروت من قبل القوات الإسرائيلية اتصل ببشير الجميل لأمر عاجل، فتولى قائد القوات اللبنانية نقله عبر الخطوط الإسرائيلية إلى منزله حيث تناول معه طعام الغداء لوحدهما (…) ثم في ختام هذا الحديث قال أبو الزعيم إنه يكن احتراما كبيرا لبشير الجميل، وأن التاريخ سوف ينصفه في المستقبل، وكذلك الرئيس أنور السادات، لأنهما كلاهما تصرفا بروح وطنية عالية خلافاً لصورة الخيانة الشائعة عنهما، والتي أدت الى اغتيالهما الواحد تلو الآخر. ذلك كلام مفاجئ، بل صادم، من دون شك، لكثيرين، كما يقول الفرزلي نفسه “وثد فاجأني أبو الزعيم بتوصيفه لبشير الجميل والصورة التي رسمها له”. أما من جهتي فليس يفاجئني أي شيْ من ذاك القبيل، إنما ذكرني بسؤال لمراسل بي بي سي خلال الحرب ومجازر صبرا وشاتيلا فحواه “فماذا عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟” فيرد بشير: “ليست مشكلتي، خذوهم الى بيكا ديللي في لندن”! كذلك، ليس من السهل إعطاء “علامات الدرب” ما يفي الكاتب والكتاب حقهما لجهة عرض وقائع عدة تلقي الكثير من الضوء على المشهد السياسي. أما في الشأن الصحافي، فالأمر ربما أكثر صعوبة. من بدء المشوار مع الصحافة في لبنان، إلى الاغتراب بين باريس ولندن، ثم الاستقرار في الثانية، يروي سليمان الفرزلي من القصص اللافتة ما يبقى من حيث الأهمية في الإطار الخاص، ومنها ما يتجاوز الذات إلى العام، وهذه في منتهى الأهمية التأريخية، وهي بلا شك تندرج في سياق إسهام مهم ضمن التوثيق المطلوب لظاهرة الصحافة العربية في المهجر. وكما أشرت في مقالة سابقة بعنوان: “مسؤولية تأريخ صحافة لندن”، فإن هذا التأريخ مسؤولية كل من عايشوا التجربة وشاركوا في صنعها، ولا شك أن سليمان الفرزلي أحد النجوم البارزين بينهم، ثم إن علاقة المودة التي جمعت بين الفرزلي وعدد من كبار المسؤولين العرب، ومن هؤلاء – على سبيل المثال – الدكتور فاضل البراك في العراق، وميشال عفلق في سوريا، أتاحت له الاطلاع على تفاصيل لم يكن ليطلع عليها غيره، ما يعطي لما أورده في كتابه عن صحف ومجلات أهمية خاصة، وأختم، من دون قدرة على أن أفي الموضوع حقه، فأقول بألم، وبلا مبالغة، أن بين ما قرأت بين صفحات “علامات الدرب” لكاتب بعمق تجربة سليمان الفرزلي، عن المشهد الصحافي العربي من بيروت، إلى باريس، ثم لندن، ما كان له وقع صدمة قست عليَّ أحياناً حد أنني تمنيت لو لم أكن جزءاً حالة الصحافة العربية عموما، ثم خصوصا في المهجر. لكن ذلك حديث آخر.
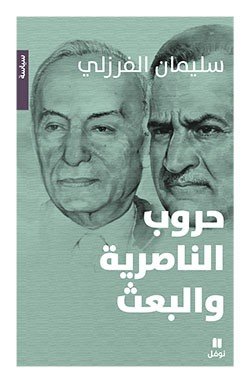
سليمان الفرزلي في ‘حروب الناصرية والبعث‘:
عبد الناصر لم يدرك دوافع قبول أمريكا بوحدة عربية مكبلة
بقلم سمير ناصيف
“القدس العربي” – لندن
16 / 1 / 2016
أهم ما في كتاب الصحافي والكاتب اللبناني المخضرم سليمان الفرزلي «حروب الناصرية والبعث» الصادر مؤخراً، نظرته الواقعية لنظام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، ونقده الموضوعي لفكرة الاعتماد المبالغ فيه على القائد «البطل المنقذ» الذي لا يخطئ، ورفعه إلى موقع شبه الإله المدرك لكل الأمور برغم أخطاء قد يرتكبها. يركز الفرزلي، الذي ترأس تحرير صحف عربية بارزة، معظمها مؤيد لحزب البعث العربي الاشتراكي، قبل ان ينضم في المراحل الأخيرة من حياته المهنية إلى مجلتي «الصياد» و”الحوادث» في مناصب فاعلة، على الأخطاء التي ارتكبها عبد الناصر وأعوانه في الاعتماد المفرط على طروحات قُدمت إلى نظامه من جانب القيادة الأمريكية السياسية بعد خسارته حرب الأيام الستة عام 1967، واعتقاده ان هذه الطروحات تُقدم عن حسن نية. وفي الوقت عينه، لم يغض الفرزلي الطرف عن رفاقه السابقين في حزب البعث العربي الاشتراكي في انتقاداته، وعلى رأسهم مؤسس الحزب ميشال عفلق وبعض كبار أعوانه، وخصوصا في تعاملهم مع عبد الناصر. ولكنه، وفي أكثر من مكان في الكتاب، شن حملة قوية ضد الصحافي المصري البارز محمد حسنين هيكل، أحد كبار أعوان عبد الناصر موجهاً إليه شتى الاتهامات ومنها الترويج لسياسات ناصر على حساب حزب البعث. يتحدث الفرزلي في الفصل الثالث من الكتاب بعنوان «أتباع لا شركاء» عن الموقف الأمريكي تجاه عبد الناصر والوحدة العربية، والأنظمة العربية في العقود التالية بعد مرحلة عبد الناصر وحتى الساعة،. ويقول: «ليس دقيقاً القول ان الولايات المتحدة كانت تقف ضد الوحدة العربية بشكل مطلق إذ أنها كانت تفضل نوعاً من الوحدة المحدودة بمعنى ان لا تكون معادية لإسرائيل وان تكون قابلة للاحتواء فلا تخرج عن الحدود المقبولة الكفيلة بعدم احداث اهتزازات كبرى وارتدادات بعيدة في منطقة حساسة مثل منطقة الشرق الأوسط. كان ذلك في صلب «مبدأ ايزنهاور» في اواسط الخمسينات تحسباً لمضاعفات الموجة الوحدوية العارمة التي انطلقت في سوريا باتجاه مصر.. إن معظم التجارب الوحدوية المحدودة والقابلة للاحتواء كانت تحظى بدعم الولايات المتحدة ومنها ما كانت تشجعه وتدفع باتجاهه مثل وحدة ليبيا التي كانت مجزأة إلى ثلاثة اقاليم (بنغازي، طرابلس، فزان) ولو ان دافعها إلى ذلك كان المصالح النفطية». فالرئيس الأمريكي ايزنهاور ووزير خارجيته جون فوستر دالس، حسب المؤلف، لم يقبلا اصلاً بالحياد الايجابي المصري العربي واعتبرا معتنقيه اعداء لأمريكا. وقد أربك هذا الخلط بين المبادئ الاخلاقية والجيوسياسية بقيادتهما دولاً كثيرة وفي مقدمتها الدول العربية، حسب الفرزلي. وبالتالي فان هذا «الغموض الخلاق» انتقل، بنظر المؤلف، إلى مبدأ «الفوضى الخلاقة» التي أطلقتها نظيرة دالس (بعد نصف قرن) كوندوليزا رايس بهدف تشكيل شرق أوسط جديد.. وبالتالي، يعتقد المؤلف أن العلاقة التي تصوّرها عبد الناصر مع أمريكا كانت ملتبسة عليه فكرياً وعملياً. ففي البداية، كان الهدف من التعاون المصري ـ الأمريكي ضبط أي ثورة اجتماعية حقيقية، ولكن عبد الناصر لم يقتنع به كلياً ولم يجد له أي تأييد في الرأي العام المصري. ويستشهد بقول لصلاح نصر، مدير مخابرات عبد الناصر، بان عبد الناصر اخفق في تصوره لأمريكا، بمعنى ان صورة أمريكا في ذهنه لم تكن واقعية. فهو كان يتصور انها ما زالت تعيش بمبادئ الماضي، حسب مواصفات مبادىء الرئيس الأمريكي الثامن والعشرين وودرو ويلسون، التي شاعت بعد الحرب العالمية الأولى، وان أمريكا دولة تقدمية حضارياً وقوية وبلا أطماع استعمارية، لكنه عاد واكتشف بالتجربة ان الأمر ليس كذلك عندما تضاربت سياساته مع مصالحها. ومن الأمور اللافتة في هذا الكتاب الشواهد والأسانيد التي أدرجها المؤلف في نهاية كل فصل. ففي الفصل الثالث الذي ربما هو الأهم في الكتاب، نجد في جزء الشواهد (ص84) تحت رقمي 10 أو 11 مقطعين هامين يقول أولهما: «كشف عضو مجلس قيادة الثورة السابق خالد محي الدين في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه محطة «الجزيرة» في 2 آذار/مارس 2011 انه انتسب هو وجمال عبد الناصر إلى التنظيم السري لـ”الإخوان المسلمين” في عام 1943، وحلفا اليمين على القرآن أمام رئيس التنظيم. ويضيف: «وهناك من يقول أن انتساب عبد الناصر إلى الإخوان سابق لهذا التاريخ ويعود إلى عام 1940». ويقول محي الدين في المقابلة ان «مشروع الانقلاب العسكري ضد النظام الملكي هو في الأصل مشروع المرشد الأول للجماعة حسن البنا.. وان عبد الناصر اجتمع بالبنا أكثر من مرة». وفي الاسناد الثاني ينسب الكاتب قولا للقيادي الإخواني سيد قطب يقول فيه: «أعمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة يوميا تقريبا مع رجال الثورة (المصرية) ومن يحيط بهم”. وسبب خلاف عبد الناصر والبعثيين في سوريا، حسب الكاتب، كان ان ميشال عفلق، مؤسس حزب البعث لم يكن راضياً عن سير الأمور في دولة الوحدة، وان حكم عبد الحميد السراج في دمشق باسم جمال عبد الناصر استهدف البعثيين وأقام في سوريا حكماً بوليسياٍ كان من شأنه ان يؤدي إلى كارثة. فيما اتهم عبد الناصر قادة البعث الثلاثة ميشال عفلق وأكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار بانهم يريدون التفرد بحكم سوريا ويؤثرون المصلحة الحزبية على العامة. وفي تفسير قدمه محمد حسنين هيكل في مقالاته في صحيفة «الأهرام» بعد ستين يوما على رحيل عبد الناصر عن أسباب خلاف ناصر مع قيادات بعث العراق والذي أورده الكاتب مع انتقاد لاذع لهيكل قال: «حاول (هيكل) بعد رحيل جمال عبد الناصر المفاجئ ان يظل يقتات من مائدته.. فلم يكن مضى ستون يوما على رحيل عبد الناصر المفاجئ، حتى استل هيكل قلمه وطرز صفحات «الأهرام» بمقالات هدفها تدبيج تبرير معلل لقرار الرئيس المصري الراحل قبول ما سُمي بمبادرة وليم روجرز (وزير الخارجية الأمريكية آنذاك) التي اوقفت حرب الاستنزاف وغذت الميول إلى التفاوض على تسوية سلمية بين العرب واسرائيل.. وانزلق هيكل إلى النيل من البعث وقومية السلطة الحاكمة في العراق فاتهمها بالتقصير المتعمد على الجبهة الشرقية ثم بمحاولة وراثة زعامة جمال عبد الناصر وسرقة دور مصر من بعده”. وفي الفصل الثاني من القسم الثاني في الكتاب بعنوان «بؤس الصراحة» يقول الفرزلي: «ان دولة الوحدة (بين مصر وسوريا) لم تسقط يوم 28 ايلول/سبتمبر 1961 (يوم سقوطها مادياً) بل سقطت تاريخيا عندما احجمت عن الانتشار لملاقاة حركة النضال العربي في الأقطار الأخرى، وعندما تهيبت العدو فأشاحت بوجهها عنه.. ان الاستاذ هيكل قد بسّط الأمور عندما قال ان دولة الوحدة سقطت لأنها استنفدت أغراضها». ويضيف: «ان نظرة حزب البعث إلى مصر، وإلى الشعب المصري، تبدو أكثر احتراماً لمصر وللشعب المصري من أي نظرة أخرى قائمة على التمايز بين مصر والعرب.. لأنها تنبع من المصير الواحد للأمة العربية ورسالتها الإنسانية». والقول إن هناك شيئين منفصلين هما مصر والعرب يضعف العلاقات العربية، حسب المؤلف. ويضيف: «ان الصورة الوحدوية للرئيس جمال عبد الناصر في أذهان الجماهير العربية، هي وحدها حافظت على ان يبقى حجم مصر بحجم الوحدة وان يبقى دورها العربي أكبر مما كان قبل الوحدة.. على ان غياب الرئيس عبد الناصر لا يلغي القضايا التي تصدى لها والتي صنعت المآسي». ان زعامة عبد الناصر اكتسبت شرعيتها الحقيقية من الوحدة التي جسّدت النضال العربي كله. ولولا الوحدة لما كان ممكناً ان يطلق عليه لقب «رائد العروبة». الأمة تعطي الوحدة من أجل التحرير وتصفية الاستعمار والاحتلال وليس الشخص”. وفي الفصل الثالث والأخير من القسم الثاني من الكتاب، وهو بعنوان: «وهم البطل المنقذ» ينطلق الفرزلي إلى مستوى تحليلي قد يفسر سبب انتقاله من العمل الحزبي المباشر إلى الإنتاج الفكري التحليلي، كما فعل كثيرون غيره من الشخصيات التي انتسبت إلى أحزاب مختلفة في العالم العربي وخارجه وخرجت منها مع الاحتفاظ بمبادئها فيقول: «حاول كثيرون من القادة في العالم العربي وخارجه ان يطرحوا انفسهم بطرق مختلفة على انهم أبطال منقذون لأوطانهم وشعوبهم. وقبلت شعوب عديدة، بشكل أو بآخر، أن تنظر إليهم على انهم كذلك.. وقد برزت هذه الحالة (في منطقتنا) أولاً بشخص الرئيس جمال عبد الناصر في مصر، وفي سوريا بشخص الرئيس حافظ الأسد، وفي العراق بشخص الرئيس صدام حسين. هذه الحالات خيبت الآمال واظهرت الفارق العميق بين صورة «البطل المنقذ» وبين الدولة التي قادها. فلكي يلبس القائد أو الزعيم أو الرئيس شكل «البطل المنقذ» فانه مضطر إلى رفع سقف الآمال اللازمة لتثبيت حكمه ونظامه. لكن ذلك، في كثير من الأحيان، لا يكون متطابقاً مع الواقع فتذر الخيبة قرنها عند الاحتكاكات المصيرية على المفترقات الحاسمة وتنتهي اسطورة «البطل المنقذ» بكارثة فيترك للأجيال الجديدة مشاكل مضاعفة وأكثر تعقيداً ومشوبة بالتناقضات التي تشكل مع الوقت خطراً على وجود البلد ذاته”. ويضيف ما يمكن اعتباره خلاصة الكتاب قائلا «وهنا تبرز المفارقة التي أدت إلى التباعد والتقاتل بين الناصرية والبعث لأن السبيل الوحيد للوقوف في وجهه هو المقاومة الدائمة وباي شكل متاح (كما في فلسطين ولبنان)»، «ومع ذلك فان لهذا العدو أساليبه الخاصة في مقاومة المقاومة داخل بيئتها وحواضنها. وفي هذا السياق تدخل معركة الوعي» … قائلا بأن «المتحفظين على المقاومة هم حلفاء العدو.» وهذا «يسهل على العدو اذكاء الحروب الأهلية داخل الأقطار العربية كما شاهدنا أخيرا في العراق وسوريا ومصر، وسابقاً في لبنان بفعل وجود المقاومة الفلسطينية على أرضه. ويخطئ من يظن ان العدو الإسرائيلي لم يكن طرفاً فاعلاً في تلك الأحداث، أو مؤججاً لها أو حتى مطلقا لشراراتها”. وقد تستفيد القيادات العربية والإسلامية الحالية مما قاله الفرزلي في كتابه وتدرك ان صراعاتها وخلافاتها وحروبها الميدانية والعقائدية المتصاعدة تصبُ في النهاية في مصلحة العدو الإسرائيلي المغتصب لفلسطين ولحقوق شعبها. ويختتم الفرزلي بالقول: «يبقى بصيص من الأمل وسط هذا الركام وهو ان تقوم في العالم العربي قوى حية تتصدى للمواجهة مع العدو الحقيقي التاريخي للأمة وداعميه وقوفا صلباً ومتفوقاً”.
“حروب الناصرية والبعث لسليمان الفرزلي:
عن الماضي الذي لا يمضي
بقلم الكاتب المصري شادي لويس بطرس
22 / 9 / 2016
ينطلق الكاتب والصحافي اللبناني، سليمان الفرزلي، في كتابه «حروب الناصرية والبعث» (من إصدار «نوفل»، 2016) من سلسلة من أربع عشرة مقالة له، بعنوان «بؤس الصراحة»، نشرها في جريدة “الكفاح” البيروتية، عام 1970، تعقيبا على أربع مقالات نشرها الكاتب المصري، محمد حسنين هيكل، في جريدة «الأهرام» المصرية في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بعنوان «لمحات من قصة المعركة الأخيرة»، تناول هيكل في اثنتين منها حزب البعث العراقي بنقد شديد. لكن كتاب الفرزلي، الصادر هذا العام، لا يبدو معنيا بانتقاد هيكل وناصريته أو الدفاع عن البعث، بقدر محاولته إعادة تناول الصراع بين الناصرية وحزبي البعث السوري والعراقي، الذي لا يراه أمراً في ذمة التاريخ، بل إن تبعات ذلك الصراع يعدها محوراً للتطورات التي يشهدها العالم العربي على مدى الأربعين عاما الماضية، والتي ربما سيشهدها في المستقبل أيضا. يخصص الفرزلي القسم الأكبر من كتابه لتتبع مسارات صراع الناصرية وحزب البعث السوري، بدءا من قيام الجمهورية العربية المتحدة، مرورا بالانفصال، وحتى التورط المصري في حرب اليمن والهزيمة في نكسة 67. لكن الفرزلي لا يكتفى فقط بالعودة إلى «كوامن الماضي الذي لا يمضي»، بل ينقله إلى «المستقبل الذي لا يقبل»، رابطا ثورة يناير/كانون الثاني، وسقوط مبارك ومرسي من بعده – التي يصفها بأنها نمط من الماضي- ببنية الدولة المصرية الموروثة من الحقبة الناصرية. ويأخذ الفرزلي محاولته لمد الماضي على استقامته، إلى تحليل ظاهرة الإسلام السياسي وصعود الحركات الجهادية المسلحة، رابطا إياها بالتباس علاقة القومية العربية بالإسلام، محيلاً إيانا للجوهر الإسلامي الأصولي المبطن والانتهازي لكل من الناصرية والبعثية، التي إن بدأت مع علاقة الضباط الأحرار بجماعة الإخوان المسلمين، ودور سيد قطب في التنظير لثورتهم، فإنها لم تنته بإعلان صدام حسين اعتناق ميشال عفلق للإسلام فور وفاته. لا يكتفي الفرزلي بكشف الغطاء العلماني المدعى عن الناصرية والبعثية، بل يتبعها بتأطير الطبيعة الاستئثارية والنخبوية لكل من مثلث الناصرية والبعثية والإسلام السياسي، ودور تلك الطبيعة الاستئثارية في هدم المشروع الأكثر تقدمية في مسيرة القومية العربية، وهو الوحدة المصرية – السورية، ولاحقا في تدمير البني الاجتماعية والسياسية للدول العربية. يستعين الفرزلي بالماضي الأبعد لتفسير الماضي الأقرب، فينطلق من مقارنة بين حملة إبراهيم باشا العسكرية على سوريا، وحروب محمد علي في الحجاز، وبين تجربة الوحدة السورية المصرية ومعها الحرب الناصرية في اليمن، للتدليل على البعد الجيوسياسي والتاريخي الحتمي للاتصال المصري السوري، وتصدي الاستعمار والأنظمة العربية الرجعية لمشروعه الوحدوي عبر تفشيله داخليا وزرع دولة إسرائيل على خطوط تماسه. هكذا، يجادل الفرزلي بأن فكرة إنشاء الدولة الصهيونية بدأت مع صعود المشروع التوسعي لإبراهيم باشا ووصوله إلى سوريا، وأن الحرب بين نظام ناصر والسعودية على الأراضي اليمنية ليست إلا امتدادا لحروب محمد علي ضد الوهابية في الحجاز. وفيما يعود الفرزلي ليغوص في تفاصيل المفاوضات السابقة لإعلان الوحدة، ورضوخ البعث السوري لمطالبات ناصر بحل الحزب كشرط مسبق للوحدة، ولاحقا للأزمات والملابسات التي أدت لانفصال عراها، فإنه يؤطر سقوط الوحدة المصرية السورية، كنقطة البداية للهبوط العربي، ولتحول الناصرية والبعثية بعد النكسة عن مواجهة العدو الحقيقي، إسرائيل، إلى حروب وهمية مدمرة بدءا من حرب ناصر في اليمن، والتدخل السوري في لبنان، والحرب الأهلية اللبنانية، وحرب صدام في إيران والكويت وأخيرا في الاقتتال الأهلي في ســــوريا واليمن وليبيا. يفرد الفرزلي مساحة أقل من كتابه لصراعات الناصرية والبعث العراقي، مركزا على أزمة «الجبهة الشرقية» عام 1968، التي بسببها اتهم النظام المصري البعث العراقي بمحاولة عرقلة قيام الجبهة الشرقية على الحدود الأردنية، وتخليه عن دوره العسكري في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ولاحقا لاتهــــامه بمحــــاولة سرقة دور مصر القيادي في النضال العربي، ليربط صراع الناصرية والبعــــث في النهاية بـ”وهم البطل المنقذ”، ناصر والأسد الأب وصدام حسين، وتبعات ذلك الوهم الكارثية على دول المنطقة ومجتمعاتها. يفتقد كتاب الفرزلي في مجمله للمنهجية البحثية أو التاريخــــية بمفهومها الأكاديمي في تناول مواضيعه، وعلى الرغم من أن الكتاب يزخر بالمراجع الأولية من محاضر اجتماعات رسمـــــية، وخطب ولقاءات ومقالات وغيـــرها، وكذلك بإحالات لمراجع ثانوية من كتب ودراسات عربية وأجنبية، إلا أن فصول الكتاب لا تلتزم بالتسلسل التاريخي للأحداث، ومن الصعب تبين أي خط واضح لتطور الأفكار المطروحة، التي ما يلبث الكاتب العودة إليها مرة بعد أخرى، مما يجعل فصول الكتاب وحتى فقرات الفصل الوحد عصية على التبويب. ومع أن الفرزلي، يقدم لنا تصوراً شديد الجوهرانية عن الصراع في المنطقة العربية، باختزاله في المواجهة مع إسرائيل أو التحوُّل عنه، إلا أن الكتاب الذي يحمل في جانب منه طابع الشهادة الذاتية، يقدم أطروحات شديدة الأهمية عن الأسس الإيديولوجية للقومية العربية في ارتباطها بالإسلام السياسي، وكذلك عن تبعات الصراع الناصري البعثي حتى اليوم، ويطرح أسئلة وإشارات مهمة لا تشغل «أهل الماضي المهزوم والمهزومين معه»، بل هي أليق بأهل المستقبل لتدبر ما يدعوه الكاتب أطروحة كتابه، أي أصول «المقوضات العربية»، والأهم أنه ينبهنا عن تلك العلاقة الحميمة والمفجعة التي تربط الماضي باليوم.
“أخونة” عبد الناصر و”إسلام” ميشال عفلق و”قشرة العلمنة”
بقلم محمد حجيري
موقع “المدن” 16 / 1 / 2016

يعود الصحافي سليمان الفرزلي في كتابه “حروب الناصرية والبعث، إلى تاريخ نشأة الصراع بين قطبي العروبة، حزب “البعث” والتيار الناصري، مفنداً أداءهما، وعلاقتهما بالحركات الإسلامية، لعله يجد في الماضي تفسيراً لما يجري راهناً، وخصوصا بعد عودة الإسلام السياسي إلى الواجهة، مستندا في إتمام هذا الكتاب إلى سلسلة مقالات نشرها محمد حسنين هيكل في صحيفة “الأهرام” طاولت حزب البعث ومؤسسه ميشال عفلق… ويناقش في جزء من كتابه الإشكالية، من خلال التناقض الحاد الذي نضحت به مقالات هيكل، بين دفاعه الموارب عن التوجه الناصري الى السلام، وبين تأكيده أن “من لا يريد محاربة إسرائيل فإنه يريد حربا أهلية بين العرب”….
ثمة الكثير من القضايا المتشعبة التي يتناولها الفرزلي، بعضها يكتب موقفه منها كأنه بصيغة البيان الحزبي الشعبوي، وبعضها الآخر يحتاج دراسات ميدانية وليس مجرد آراء، وهناك مواضيع عفا عليها الزمن وبعضها الآخر يرتبط بالحاضر، خصوصا تلك الحروب المستعرة والمستأنفة بأشكال جديدة وأكثر وحشية. لكن ليس بالضرورة ان تكون حروب الأمس هي حروب اليوم، وهناك الكثير من الأمور الثقافية والجغرافية والاجتماعية، كان يمكن التطرق إليها في الكتاب. لكن يبدو أن الهدف الأبرز بالنسبة إليه كان الرد على ترهات هيكل وخيالاته المترهلة، وكان يمكن للكتاب أن يكون تحت عنوان “صراعات ثقافية وسياسية بين بلاد الشام وبلاد النيل”، فيفتح المجال على أمور أكثر دقة وحساسية، تظهر جوهر العروبة (او العروبات) المفخخة، وسعي البعث الى “بعثنة” الشعوب العربية في عقلية واحدة، وسعي الناصرية الى تمصير أو “مصرنة” العرب على نسق “امبريالي”… وفي بعض الجوانب ثمة تبسيط للأمور ومنها أن المسلمين في غالبيتهم، تعرضوا ويتعرضون لخديعة كبرى باسم الإسلام من قبل حكامهم، وقادتهم، وحركاتهم، وان هؤلاء جميعا خدعوهم وضللوهم عن قصد، او عن ضعف، باستخدام “الإسلام وسيلة للاستقواء”. والأرجح انهم يستغلون ويستقوون بأي شيء، سواء الدين او العدو أو القمع، على أن الشعوب (العربية والإسلامية) أكثر اندفاعاً من حكامها نحو تبني الخطاب الديني. والاستقواء بالقومية والعروبة لا يقل ضراوة عن الاستقواء بالإسلام، هي لعبة السلطة التافهة والاستبدادية….
على أن القضية الأبرز، والتي ما زالت راهنة ويتطرق إليها كتاب الفرزلي، تتعلق بـ “لعلمانية الملتبسة” في العالم العربي، خاصة بين الأحزاب القومية واليسارية. ففي مقدمة كتابه يقول: “هناك إشكالية العلمانية والدينية في تنظيرات الناصريين والبعثيين وممارساتهم على الأرض، حيث كانت للحركتين المتلاشيتين من جراء حروبهما الداخلية والخارجية، قشرة علمانية ظاهرة وجوهر ديني في الباطن”. فالناصرية والبعث في المنظور النقدي، بحسب الفرزلي، “لا يختلفان إلا في الشكل عن بقية الحركات الإسلامية المعاصرة، الاخوانية والسلفية على السواء، او التي تدخل في إطار التقليد الابراهيمي”، وليس أدل على ذلك في “البداية الاخوانية لجمال عبد الناصر، والنهاية الإسلامية لميشال عفلق”. ويعتبر الفرزلي ان التناقض اللاحق بين عبد الناصر وسيد قطب لا يثبت العكس، لأن النظام الناصري بقي يمارس الحكم على القواعد ذاتها التي رسمها سيد قطب في بداية انطلاق ثورة يوليو 1952، كذلك النهاية القسرية التي فرضها صدام حسين على عفلق بعد وفاته، ليست الدليل الوحيد على حشر حزب البعث ضمن “التقليد الابراهيمي”، كما سمّاه عادل ضاهر….
كان يمكن للفرزلي أن يكتب في العلاقة بين ثورة يوليو وسيد قطب بوقائع أكثر دلالة لتبيان الحقائق، فلا يمكن الحكم على عبد الناصر من بدايته الاخوانية، بغض النظر ان كان على خطأ أو صواب. فجوهر الناصرية كان استبدادياً، شعبوياً، وليس دينياً، وإن لعب على الوتر الديني او تذرع به في بعض المواقف. وهو مارس سياسة الاحتواء للدين، خصوصا في بداية علاقته بسيد قطب، وسرعان ما وصل الى الصدام، مع الاخوان والشيوعيين والمثقفين، ويمكن قراءة شخصيته بكثير من الدقة، سواء من حيث علاقته بالسلطة وطريقة حكمه الفاشلة، أو علاقة “الجماهير” به. فليس منطقياً اختصاره بالأخونة أو “اللباس الإسلامي”. واختصاره بالأخونة يشبه توصيفه بالفرعون وتلك العبارات الصحافية الجاهزة.
على أن سيد قطب نفسه، الذي يعتبره الفرزلي سيد أفكار عبد الناصر، عاش مراحل متناقضة ومتعددة ومتقلّبة، من مرحلة قيل انه كان ماسونياً، وكان يقترب من الإلحاد اذا جاز التعبير، ومن دعاة حرية اللباس والعري والذهاب الى البحر، وعرف بنقده الأدبي وقربه من نجيب محفوظ، ثم سافر الى اميركا وعاد الى “ظلال القرآن” والتطرف الفكري والعداء للغرب. وما يقال عن سيد قطب، يقال عن الرئيس انور السادات في مسيرته المتقلبة، ويقال عن صدام حسين… في السنوات الأخيرة، بعد ترهل مشاريع العروبة، وصعود مشاريع الطوائف والانقسامات، صار بعض الأقلام، ومنها الأميركي فؤاد عجمي، يعتبر العروبة سنّية، واقلام أخرى تبحث عن تفاصيل مملّة منها أن والدة جمال عبد الناصر شيعية، بل بات الاهتمام الجذري بتفاصيل طائفية لم تكن في الحسبان.
قصة حزب البعث مع الدين والإسلام تحديداً تبدو أكثر التباساً، على اعتبار انه حزب علماني في الأساس، ومؤسسه (ميشال عفلق) من أصول مسيحية. وفي رأي الفرزلي ظهر البعث إسلامياً بامتياز منذ أن ألقى عفلق أطروحته الإسلامية في “ذكرى الرسول العربي”، وأهم ما ورد فيها الجملة التالية: “كان محمد كلّ العرب فليكن العرب اليوم كلهم محمداً”. وبعد وفاة عفلق أعلن صدام حسين من خلال وثيقة ملتبسة إسلام عفلق، وأكدت رزان عفلق إسلام والدها نقلاً عن صدام حسين، قائلة إن رؤية والدها للإسلام “رؤية إنسانية حضارية ثورية، اقترنت فيها يقظة الشخصية العربية الحضارية وملامحها بالإسلام”. وفي هذا المجال يكتب الصحافي عبد الرحمن الراشد: “الادعاء بأن ميشال عفلق مات مسلماً بالتأكيد مسألة شخصية، وفوق ذلك ربّانية”، ويضيف “ولا يمكن تصديق أن عفلق اكتشف الإسلام في آخر عمره وهو الذي كتب عن النبي محمد أكثر مما كتب حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين”. بل إنّ صدام خطا خطوات أبعد من ذلك ليس أقلها إعلان انتمائه بالنسب الى الامام علي لكسب ود الشيعة بعد التمرد على نظامه، وأضاف كلمة “الله أكبر” على العلم العراقي البعثي، بمعنى آخر انه اعلن اسلام البعث على الأقل في الشكل….
والالتباس الأكبر ليس في سخافة عودة صدام حسين إلى النسب الديني، والشعارات الدينية، بل في النظرة العروبية إلى العلماني من أصل مسيحي. ففي حمأة الصراع البعثي الناصري عزف بالتورية والتبطين، على وتر مسيحية ميشال عفلق، وهو ما عرف عنه الرئيس الناصري للجمهورية اليمنية، عبد الله السلال، بقوله في خطاب له “ميشال… ما لنا ولهذا الاسم”. ونُسب إلى القذافي زعيم الجماهيرية الليبية العظمى القول: “أميشال وقائد مسيرة البعث العربي؟”، وهو نفسه فضل ان يكون اسم جورج حبش، “خضر” حبش… وعلى هامش هذه العبارات، ميشال في الخاتمة الصدامية صار أحمد، أي دخل في الأسلمة، والأرجح أن “أسلمته” تفضح المجتمعات التي يغيب فيها الفرد والحرية الفردية والعلمنة، لمصلحة منطق الجماعة والطوائف والدين.
يروي “القيادي العروبي” جلال السيد، تعليقاً على تولي عفلق رئاسة حزب البعث: “اخترناه لرئاسة الحزب أصلاً لكونه مسيحياً، مع انه يوجد من هو أكفأ منه للرئاسة، لكننا قصدنا بذلك أن يكون عنواناً لعلمانية الحزب”. اختاروه مسيحياً ليقود العروبة البعثية فوجد نفسه في قلب الإسلام. وهنا طرح الشاعر أنسي الحاج سؤالا ذات مرة: “هل تكون مجاراة الأكثريّة المسلمة في إسلامها هي الصورة الفضلى لممارسة المسيحيّة اليوم في العالم العربي؟ وإذا كانت هذه “التضحية” هي حقّاً واجب المسيحي العربي على أساس إمكان اعتبارها تجسيداً لدعوة المسيح إلى الانفتاح والمحبّة، فأين يصبح حقّ الإنسان في المحافظة على تميّزه، أي حريّته، وماذا يكون من أمر الأقليّات..”؟
إسلام عفلق، كما يستنتج بعض الباحثين، له معنى واحد فحسب، وهو أنه في الوسط العروبي القومي، ليس لغير المسلم الحق في تعاطي السياسة بالمعنى الكامل للكلمة، اي ان مسألة الذمّي ألغيت في الواقع وليس في القانون.
(*) صدر عن منشورات نوفل، 2016
عن الطيارين المصريين في سوريا
شادي لويس
الثلاثاء 2016/11/29
(…) “ومن هذه الزاوية تحديداً سنتبيّن أهمية الدراسة المقارنة بين محمد علي باشا وجمال عبد الناصر، بما يتعدى مسألة الأمن القومي المصري في سوريا… واحد هزم الوهابية السعودية في عقر دارها فربح في سوريا، وآخر خسر في سوريا لأن حربه مع الوهابية السعودية جاءت متأخرة وعلى هوامشها” ..
في كتابه “حروب الناصرية والبعث” (2016)، يسعى الصحافي والكاتب اللبناني، سليمان الفرزلي، إلى النظر في مصائر المنطقة العربية ومآلات ثوراتها بالرجوع إلى قيام الوحدة المصرية السورية وانهيارها، متخذاً من صراعات الناصرية مع البعثين السوري والعراقي، مرجعية، لتفسير تاريخ بلدان المنطقة، ومحوراً لمآسيها. وبغض النظر عن رجاحه تحليل الفرزلي ودقته، فإن طرحه ينطلق من فرضيتين جديرتين بالفحص:
أولاً، يركن الفرزلي إلى منطق الحتمية الجغرافية، والتي لا يسعه أن يؤكدها سوى بالاستشهاد برائدها، جمال حمدان، أكثر من مرة في كتابه. فالجغرافيا لدى حمدان والفرزلي، لا تحمل بالضرورة بُعداً سياسياً واستراتيجياً فقط، ولا هي مجرد خلفية مادية للسياسية والتاريخ، بل، والأهم فالجغرافيا، هي الجبرية المحددة والمنتجة للسياسية. هكذا، بحسب “حروب الناصرية والبعث”، فإن الأمن القومي المصري، وبفعل الجغرافيا، يبدأ من الشرق، ويرتبط ارتباطاً مصيرياً بسوريا تحديداً، والتي تمثل عمقه الاستراتيجي الأهم. بالطبع، لا يجد الفرزلي صعوبة في تقديم عشرات الأسانيد والحجج التاريخية والاستشهادات لتدعيم أطروحته عن الأمن القومي المصري وارتباطه السوري، وكذلك المركزية المصرية بالنسبة للأمن القومي العربي.
وتقود فرضية الحتمية الجغرافية إلى الفرضية الثانية، والتي، وإن كانت ثانوية، فإنها لا تقل أهمية عن الأولى، فالتاريخ يصبح تنويعات على المسارات التي تفرضها الجغرافيا، وتضحي أحداثه إعادة لروايات تلتئم عقدتها حول المحدد الجغرافي مرة تلو أخرى. وبالتالي، بالنسبة إلى الفرزلي، فإن حملة إبراهيم باشا في سوريا، وحرب محمد علي في الحجاز، ليستا سوى تمظهر للحتميات الجغرافية نفسها التي قادت إلى الوحدة مع سوريا، وحرب ناصر في اليمن، وأيضاً بالنسبة إلى الموقف المصري من الحرب السورية اليوم.
ما ينجح فيه الفرزلي باقتدار هو قلب التاريخ على رأسه، من دون قصد. لكن كتاب “حروب الناصرية والبعث” نفسه يقدم أيضاً ما يدحض فرضيتيه. فالوحدة المصرية السورية، بحسب الكتاب، تبدو نتاجاً لإيديولوجيا القومية العربية العابرة لحدود الجغرافيا، في نسخها الناصرية والبعثية وغيرها. هكذا، فإن الجمهورية العربية المتحدة، التي يصعب تصور رابط جغرافي بين قُطريها الشمالي والجنوبي اللذين لا يتشاركان حدوداً مادية، تبدو نتاجاً للأيديولوجيا القادرة على تشكيل الجغرافيا وتجاوزها، بل ونفيها أيضاً. وفي مقابل حملة إبراهيم باشا في سوريا عبر فلسطين، والتي جاءت في سياق تمدد جغرافي طبيعي لطموح محمد علي الإمبراطوري، فإن الجمهورية العربية المتحدة تمثل نموذجاً استثنائياً لوحدة سياسية ضد منطق الجغرافيا ورُغماً عنه. يعيد الفرزلي قلب مثلث الجغرافيا والتاريخ والسياسة، على قاعدته مرة أخرى، ربما بلا قصد مرة أخرى.
تأتي الأخبار التي تم تداولها عن وصول طليعة من 18 طياراً مصرياً إلى سوريا، ونفيها على وجل من وزارة الخارجية المصرية، بالتوازي مع تصريحات السيسي للتلفزيون البرتغالي عن ضرورة دعم الجيوش العربية الوطنية، ومن ضمنها جيش “النظام” السوري، لتستدعي الحاجة إلى إعادة فحص فرضيات الفرزلي. فهل يأتي موقف النظام المصري من سوريا اليوم مدفوعاً برؤيته للوضع السوري بوصفه عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، تفرضه الجغرافيا ومركزية “دور مصر العربي”؟ أم أن الأمر يتعلق بإدراك النظام المصري لدور الإيديولوجيا والأفكار- بوصفها عابرة للجغرافيا- في تحديد أولويات سياسته الإقليمية؟
بلا شك، يبدو نظام السيسي، بشكل أو بآخر، إعادة إنتاج للتجربة الناصرية في نسخة مشوهة، أو على الأقل وريثة لها بحكم الضرورة، أو بدافع انتهازي لتراثها. الأمر الذي لا يصعب معه تصور التورط المصري في سوريا مدفوعاً بقناعات شبه ناصرية حول مركزية الدور المصري عربياً، وعمقه الجيو-سياسي السوري. لكن الموقف المصري من سوريا، يبدو بشكل أكبر، مدفوعاً بإدراك نظام السيسي لدور الأيديولوجيا والأفكار في تجاوز الجغرافيا وتخطي الحدود السياسية. فالثورات العربية، ومن بينها الثورة المصرية، التي أشعلتها شرارة السقوط المفاجئ لنظام زين العابدين بن علي في تونس، لم تتمدد جذوتها بفعل محددات الجغرافيا، بل بموجب انتقال الأفكار السياسية وتجاوزها للحدود. فكما كان سقوط بن علي، نموذجاً ملهماً للانتفاضات العربية، فإن نظام السيسي الذي وصل للحكم بغية تحطيم ذلك النموذج ومحوه، يدرك أن مصلحته في الصراع السوري تنحصر أولوياتها في انتصار نموذج الدولة الوطنية السلطوية، ونسختها الأسدية الأكثر وحشية وفجاجة، على سواها من النماذج الممكنة. ويبدو تأبيد النظام الأسدي، أمراً مصيرياً للنظام المصري وأيديولوجيته التي تستند إلى المرجعيات نفسها: ادعاءات محاربة الإسلام الجهادي والإرهاب، والصمود في وجه المؤامرة الإمبريالية الغربية، وأولوية وحدة التراب والاستقلال الوطنيين على حساب الديموقراطية والحريات. وفي تقارب السياسة المصرية الخارجية، مع النظام الجزائري، ودعمه لحفتر في ليبيا، وتأييدها الذي أصبح معلناً لنظام بشار مؤخراً، لا تبدو مدفوعة بحسابات جيوسياسية تحتّمها الجغرافيا وامتدادات الأمن القومي المصري التاريخية، بل بالأحرى برغبة إيديولوجية في تعميم نموذج سياسي بعينه، ومحو فرص غيره في وعي المجتمعات العربية ومخيلاتها. رغبة، تبدو اليوم، مع الأسف، أقرب إلى الانتصار من أي وقت مضى خلال الأعوام الخمسة الماضية.




