
أرشيف

The Transcendence of Gibran
by Sleiman Ferzoli
It is commonly said that Gibran is the best known Lebanese author in the West, or rather in the English speaking world. Seldom a literate household in this world is not acquainted with him through his most popular work The Prophet. By this, Gibran carried the name of Lebanon to almost every household in the West; but so also did the hostage takers of Lebanon of late, and so did the mercantile adventurers simulating the ancient Phoenecians.
Here ends the ‘sameness’ which Gibran broke with before his migration westward, thus creating a fascinating nuance between being the same and not similar. The same countrymen and the same co-religionists he assailed by saying: ‘you have your Lebanon and I have mine; you have your religion and I have mine’. In this dissimilarity lies the secret of Gibran’s Transcendence.
As a man of vision, he realised that transcendence is the only way to transform such dissimilarity into an act of liberation. For a transcendental mind cannot accept the supremacy of mediocrity over talent, of ignorance over knowledge, of bigotry over tolerance, of vanity over humility and arrogance over dignity. To him this is the absolute corruption.
The attainment of liberation by transcendence, to Gibran, is the theme of enlightenment. Only the enlightened can undo the absolute corruption. He transcended the Lebanon into the Levant, and the Levant into the West to discover that even the great civilisation of the West cannot be the final frontier of his transcendence. It can only be delicately worded like a Psalm of Solomon: ‘A handful of corn in the earth upon the top of the mountain; the fruit thereof shall shake like Lebanon; and they in the city shall flourish like grass in the earth; his name shall be continued as long as the sun’ (Psalm 72:16, 17).
Yet the final frontier of his transcendence is not even what may be casually called ‘international’ or ‘global’. It is cosmic.
A cosmic man, a fellow of the cosmic order beyond the tenses.
تسامي جبران فوق الفساد المطلق
لهذا المقال قصة. فقد كتبته باللغة الإنكليزية ونُشر ضمن كتيِّب خاص بحفلة تكريمية لذكرى جبران خليل جبران أقيمت في لندن تحت عنوان «أمسية لجبران» يوم الثلاثاء في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر من عام *١٩٩١
من شائع القول إن جبران خليل جبران هو أشهر أديب لبناني في الغرب، أو بالأحرى في العالم الناطق بالإنكليزية. فلا تجد بيتاً يجيد القراءة في هذا العالم إلاَّ وتعرَّف عليه من خلال كتابه الأشهر «النبي».هكذا حمل جبران اسم لبنان وأدخله الى كل بيت في الغرب. لكن هذا أيضاً ما فعله الخاطفون اللبنانيون في الآونة الأخيرة، وما فعله المغامرون المركنتيليون مقلِّدين في ذلك الفينيقيين القدماء
هنا ينتهي «التشابه» الذي انفصم جبران عنه قبل هجرته غرباً، فخلق بذلك تمايزاً مذهلاً بين أن تكون مشابهاً للشيء وبين أن تكون مثله. فقد ندَّد بأبناء بلده وأبناء ديانته بقوله:«لكم لبنانكم ولي لبناني، لكم دينكم ولي ديني». في نفيه لهذا التماثل يكمن سرُّ تسامي جبران فوق الوجود المادي.
وكونه رجلاً رؤيوياً جعله يدرك زن هذا التسامي هو الطريق الوحيد لتحويل انعدام التماثل الى فعل تحرُّر. ذلك أن العقل المتسامي لا يستطيع أن يقبل سيادة التفاهة على الموهبة، وسيادة الجهل على المعرفة، والتعصب على التسامح، والكبرياء على التواضع، والغرور على الكرامة. فهذا في عقله هو «الفساد المطلق
إن بلوغ التحرُّر عن طريق التسامي في عرف جبران هو كنه التنوير. فالمستنيرون فقط هم القادرون على إطاحة «الفساد المطلق». فقد تجاوز في تساميه لبنان باتجاه المشرق، وتجاوز المشرق باتجاه الغرب ليكتشف أن حضارة الغرب، على عظمتها، لا تستطيع أن تكون الحد النهائي لرحلة التسامي، بما يمكن صياغته بكلام منمنم أشبه بالمزمور الى سليمان القائل:” تكون حفنة برٍّ في الأرض في رؤوس الجبال تتمايل مثل لبنان ثمرتها، ويزهرون من المدينة مثل عشب الأرض. يكون اسمه الى الدهر قدَّام الشمس، يمتدُّ اسمه، ويتباركون به، كلُّ الأمم يطوبونه» (المزمور ٧٢: ١٦- ١٧)
بل إن الحد النهائي للتسامي الذي ينشده لا يمكن أن يكون ما هو متعارف عليه بأنه «أممي» أو «عالمي». إنه كونيٌّ
.إنه رجل كونيٌّ… عضو منتسب الى النظام الكوني الذي لا يحدُه الزمان
سليمان الفرزلي
19/11/1991

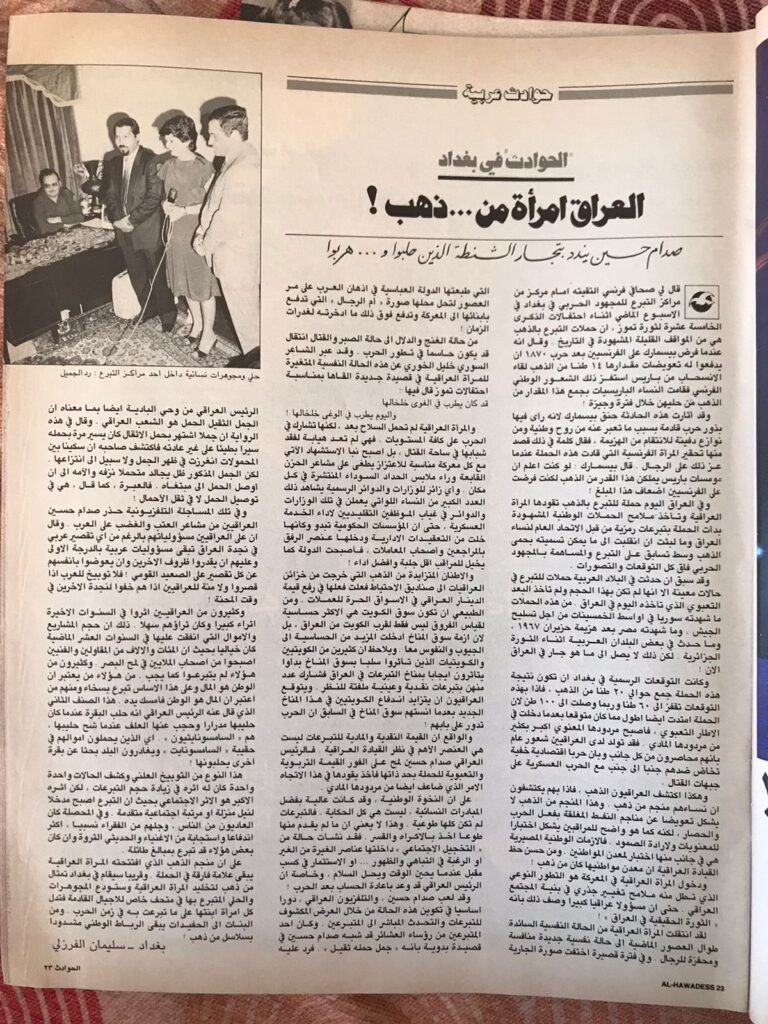
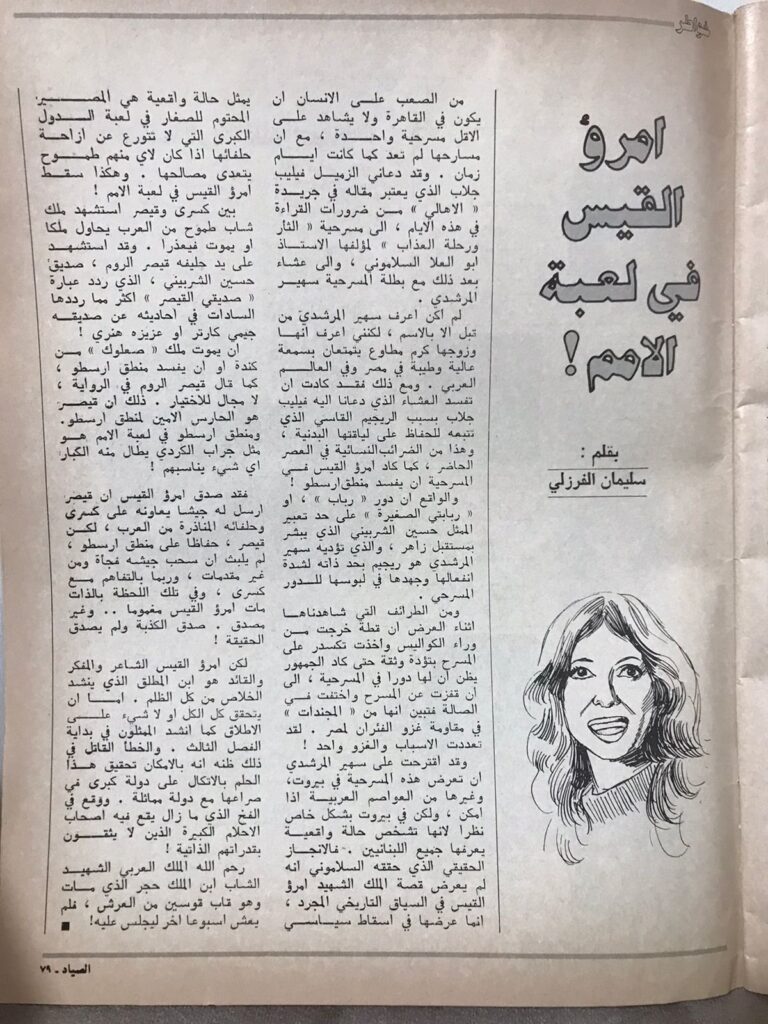
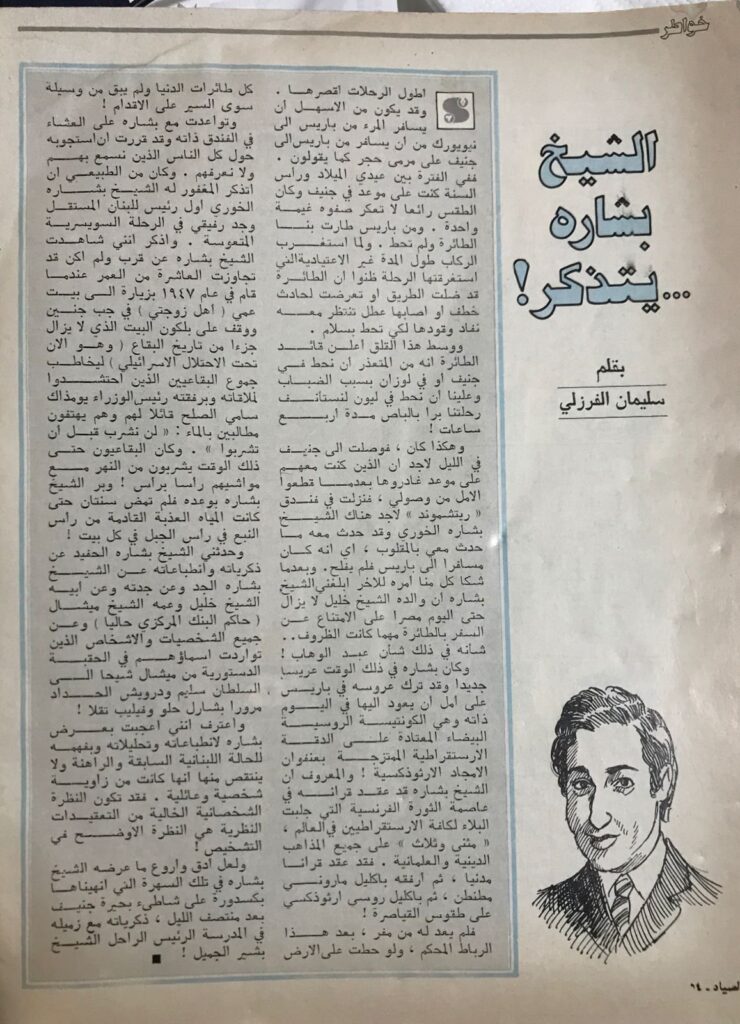
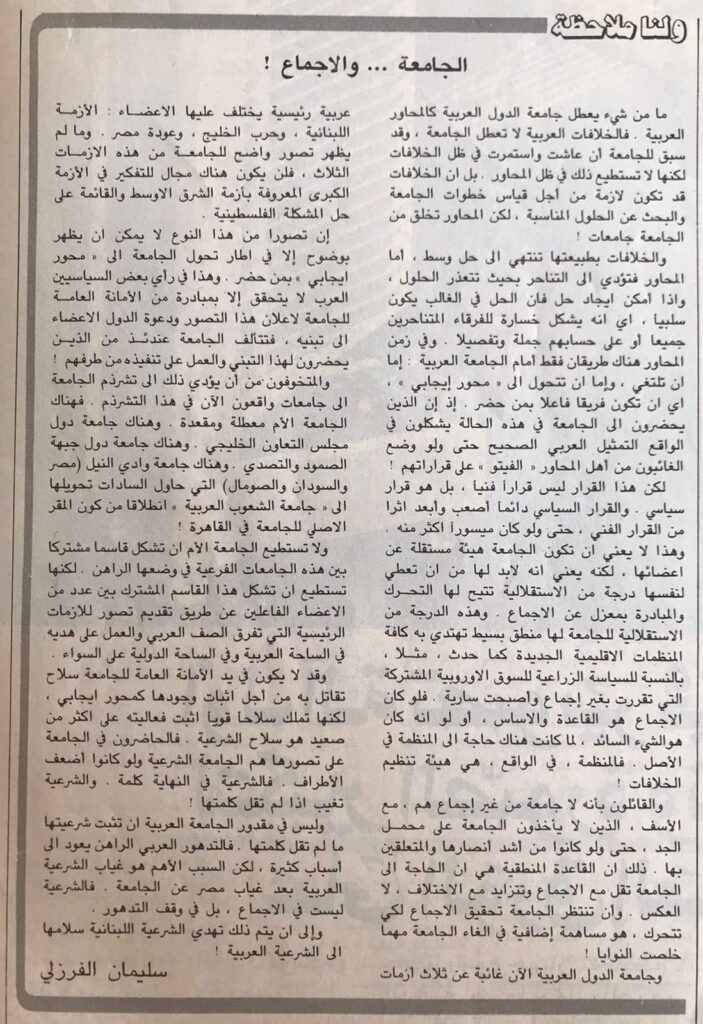
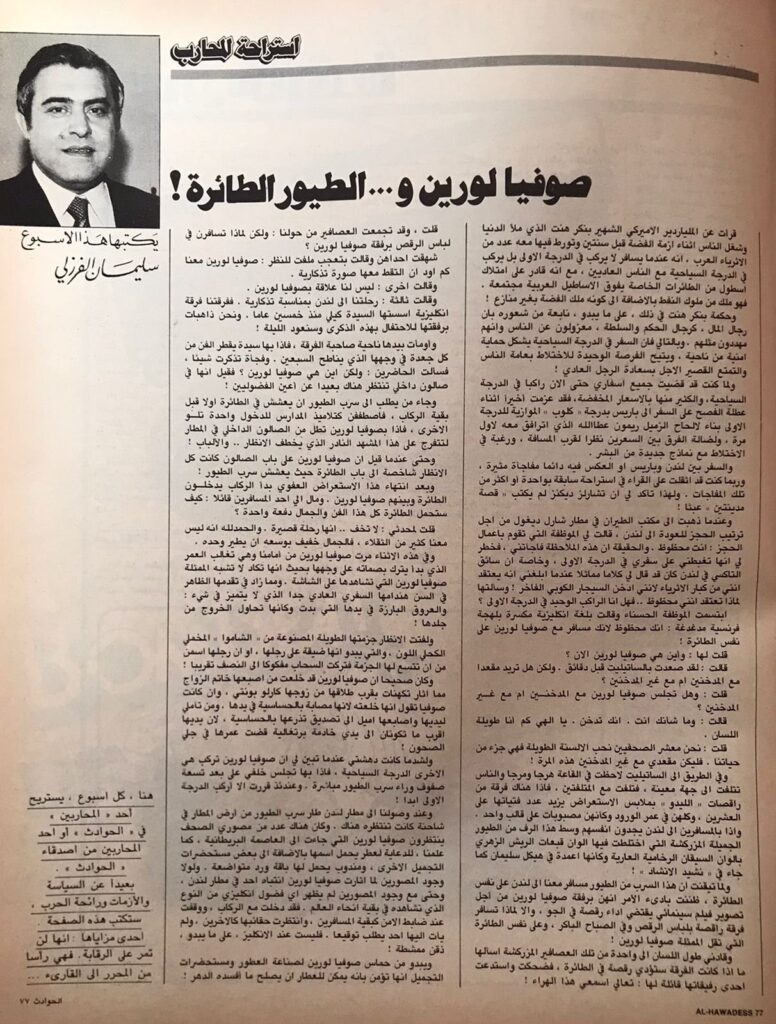
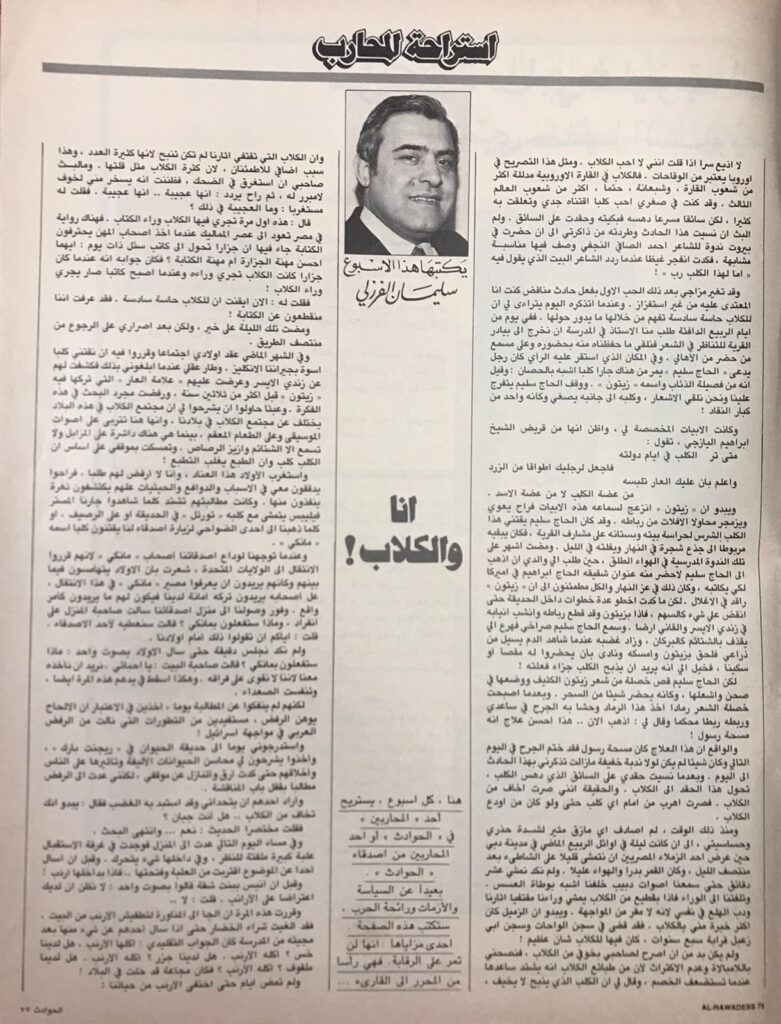
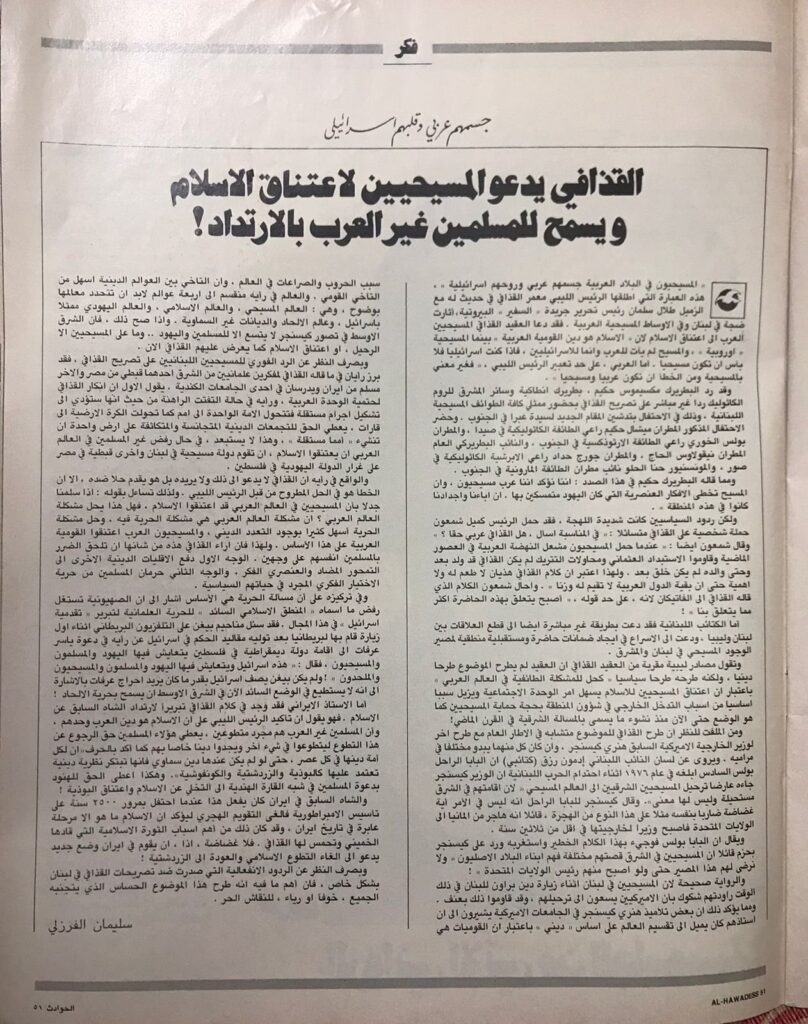
ارشيف جريدة بيروت
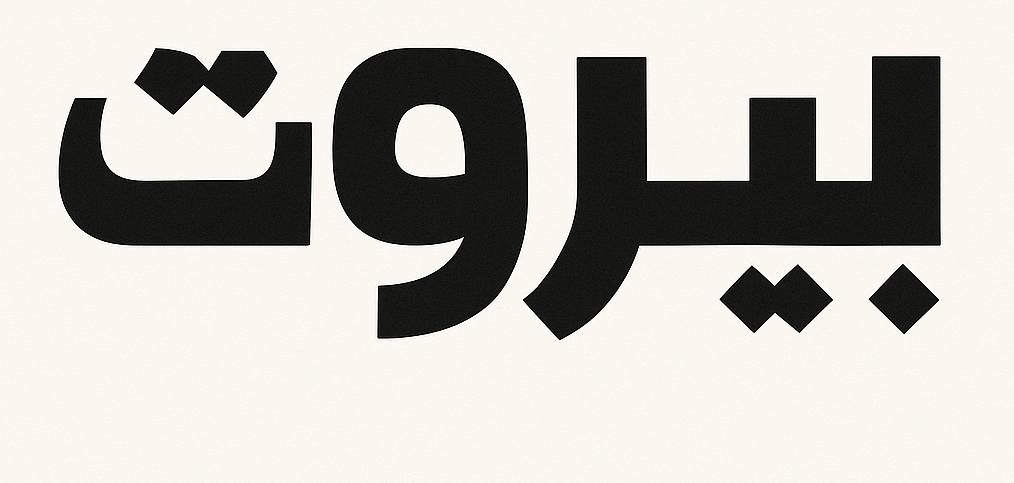

انقر على عنوان “الاحرار” لتجد محتويات الأرشيف

انقر على عنوان “الانوار” لتجد محتويات الأرشيف
قِراءَةٌ مُتَأخِّرةٌ في عَقلِ صَدّام حسين (17)
(الاخيرة)
المَهزُوم!
كان نَقعُ غُبار غزوة الكويت (1991) قد خَفَّ، والعسكرُ المُنكَسِرُ انكَفَأ الى ثكناته، حين نادى صدّام حسين قادةَ ألويته العسكرية إلى لقاء، تَلَبَّسَ فيه شخصية المُربّي والمُنظِّر و… القائد العسكري.
استدارَت وجوهُ القادة إليه، بين استغرابٍ، وإعجابٍ، وتعجُّبٍ، وذهول… فهذا الرجلُ، رئيسُ البلاد، وقائدُهم، ومُخَطِّطُ حروبهم… هو الذي ما درس فنون الحرب والقتال، والعائد من “مغامرة” غزو الإمارة الصباحية، يُجَرجِرُ أذيالَ الانكسارِ والخَيبة، يَقِفُ أمامَهم مُعتَزًّا، ومُتفاخِرًا، ومُتشاوفًا، وهو يُحوِّلُ “الهزيمة” الى “نصرٍ مُبين”… كيف لا، و”أمُّ المعارك” التي خاضها، واستبسَلَ فيها جُندُهُ، هي فريدة من نوعها، فلا قبلها جرى مثلها، ولا بعدها تكرَّرَ ما دار على بطاحِ الصحراء.
دولةٌ صغيرة، مثل العراق، لا تتعدّى مساحتها مساحة “ولاية كاليفورنيا” الأميركية، تجتمعُ عليها جيوشُ ثلاثين دولة، منها دولٌ كُبرى تقودُ العالم، فلم تَرتَعِد أوصالُ قيادتها السياسية والعسكرية، ولا جندُها وَلّوا الإدبار، والمعاركُ التي انكسروا فيها، كانَ لها في الواقع، وفي العلم العسكري، “شيءٌ من عزَّة النصر”، فتباهى صدّام حسين أمام قادةِ جندِه، مؤكداً أنَّ من حَقِّهم اعتبار ما جرى في ميادين القتال هو “نصرٌ مؤزّرٌ”، وتكفي المقارنةُ بين المتحاربين، إن في العدد، والعتاد المتطوِّر، حتى يتأكَّد ذلك!
لا نستغربُ، والحال هذه، ما قاله صدّام حسين لجنرالات جيشه، فذلك دأبُ “الزعماء العرب”، في تحويلِ “الهزائم” إلى “انتصارات”، فتضيعُ نتائجُ وتبعات الهزيمة في زخمِ الخطبِ الرئاسيةِ، والكلامِ الأجوفِ المُزَوَّقِ المليء بالتكابُر، والختل، والأضاليل… ولنا في حرب جمال عبد الناصر مثالًا:
فبعدَ الهزيمة النكراء أمام إسرائيل سنة 1967، التي لمَّا يَزَل العالم العربي، الى الآن، ينوءُ تحت ثقلِ نتائجها وتبعاتها، حاول قائد العروبة الأغَرّ، أن “يُلبِسها هالة النصر”، بالتخفيفِ من وَقعها المدوّي على العرب المفجوعين، فاستبدَلَ محمد حسنين هيكل، الذي كتب خطاب تنحّي جمال عبد الناصر، كلمةَ “هزيمة” بعبارةِ “نكسة”… إلّا أنَّ الشعبَ المصري هو الذي أضفى “هالة النصر” على تلك الهزيمة القاسية، عندما خرج إلى الشوارع، يُنادي الرئيس، ويهتُفُ مُطالِبًا أن يبقى في سدّةِ الحكم لإزالة ما سُمي “آثار العدوان”!
عفا الله عن مُنَح الصلح، حيث كتب في مجلة “الحوادث”، بعدما سحب عبد الناصر تنحّيه وعادَ إلى الحكم: “الأمةُ المهزومةُ والقائدُ المنتصر”!
في “عاصفة الصحراء”، كما في “أم المعارك”، هُزِمَ العراق و… انتَصرَ صدام حسين!
***
مُنذُ أن فتحت السلطات الأميركية خَزانةَ الوثائق العراقية، المُصادَرة بعد حرب 2003، والدارسون في تيهٍ، يبحثون عن شيءٍ واحد، هو “المفهوم” الذي استخلصه صدّام حسين، إن في الحقيقة، أو الوهم، من حرب “عاصفة الصحراء”(1991)، ثم: هل تعامل بهذا “المفهوم” مع “أم المعارك” سنة 2003؟
سؤالٌ آخر، وقف أمامه الدارسون حيارى، ولم يجدوا له جوابًا قاطعًا، في كلِّ ما أُحصِيَ، حتى الآن، من وثائق تتناولُ حروب الرئيس العراقي، وهو: هل كان صدّام حسين قادرًا على تغيير استراتيجيته القتالية عشية حرب المُتحالفين ضدّه سنة 2003؟ أو، في أضعف الإيمان، هل تراه كان يرغب في ذلك؟
الأغلب على الظن، أنَّ صدّام حسين انتشى حتى أغوار نفسه، بنصرِ معركة مدينة “الخفجي” السعودية التي احتلها جيشه سنة 1991، فاستحوذَت على تفكيره… ذلك أنَّ تلك المعركة أذهلت الخبراء العسكريين، والاستراتيجيين، ودخلت في مناهج المدارس العسكرية العريقة في العالم، وسال حولها حبرٌ كثير… فأصرَّ الرئيس العراقي، في مواجهة جيوش ثلاثين دولة، مع سلاحهم المتطوِّر، اعتماد الخطة العسكرية ذاتها، على الرُغم من اختلاف المعطيات والظروف، وأَرغَمَ قادةَ قطعات جيشه على تنفيذها، ولم يجرؤ واحدٌ منهم على المُناقشة والاعتراض.
.”التاريخُ لا يعيدُ نفسه، لكن بالإمكان جعله يفعل ذلك”، قالها بالفم الملآن، وباعتدادٍ مُتكَبِّرٍ وثقة، لجنرالات جيشه، يوم اجتمع بهم في الثالث من آذار (مارس) سنة 1991.
لقد أراد صدام حسين أن يُطوِّعَ التاريخ، ويُرغِمه على إعادة نفسه، فسقط في “حفرة العنكبوت” في بلدة “الدور”.
***
“البصرة”، 27 كانون الثاني (يناير) 1991.
بَدَت حول مركز القيادة العسكرية في المدينة، حركةٌ غير عادية، طَوقٌ من الجنود زنَّرَ المكان. في داخل المبنى الذي حُوِّل الى ثكنةٍ عسكرية، كان يدورُ اجتماعٌ ضمَّ صدام حسين واللواء صلاح عبود محمود، قائد الفيلق الثالث، واللواء أياد خليل زكي، قائد الفيلق الرابع.
أمامَ خارطة مُسمَّرة على الحائط، راحَ صدّام حسين يضع خطةَ هجومٍ مُتَعَدِّدِ الجوانب، وأوكل اللواء محمود بالهجوم الشامل.
ليلة 29 كانون الثاني (يناير)1991 بدأ الهجوم، حامت المقاتلات الأميركية فوقَ المُهاجمين، أنزلت اطنانًا من القنابل. وكان اشتباكٌ مع القوات الأميركية، والسعودية، والقطرية، على طول الخط الساحلي.
صَدَّ مشاة “المارينز” معظم مهاجميهم، إلّاَ أنَّ إحدى الفرق العراقية المهاجمة تمَّ لها التفوُّق، واقتحمت “الخفجي” واحتلتها ليلة 29-30 كانون الثاني (يناير)، وسط ذهول الأميركيين والسعوديين.
الخطة التي اعترف صدّام حسين للمُحَقِّقين الأميركيين، أنه هو الذي وضعها، كانت استحضارًا لما كان يُطوِّره “الحرس الجمهوري”، وهو الفرقة الأقوى عديدًا، وعتادًا، وتدريبًا على فنون القتال. ففي منتصف الثمانينيات اشتدّت الحرب ضدّ إيران، وحمي وطيسها، وراحت الكفّة تميلُ راجحةً إلى الفرس، (بعدما أخذت إدارة رونالد ريغان تخطبُ وِدَّ ملالي طهران وتزوِّد جنودهم بالسلاح عبر إسرائيل)، طرح إبراهيم عبد الساتر محمد التكريتي، من قادة “الحرس الجمهوري”، (أصبح سنة 1999 رئيس أركان الجيش العراقي) فكرةً سمَّاها: “الهجمات الاستراتيجية الاستباقية”، في محاضرةٍ ألقاها في 20 من تموز(يوليو) سنة 1985، وتوسَّع في شرح نظريته العسكرية تلك. كانَ صدّام حسين بين الحضور، فلفتته الفكرة، وأبدى إعجابه بها، باعتبارها، كما نُقِلَ عنه في الوثائق: “هجماتٌ مُضَعضِعةٌ للعدو”… وهذا بالفعل ما حاوله في معركة ” الخفجي”.
مع ذلك كله، خَشِيَ صدّام حسين من تمادي القادة في طروحاتهم النقدية، فضاقَ بها ذرعًا، وأبدى انزعاجه منها، خصوصًا عندما اقترح الجنرال رعد الحمداني، (من الفرقة الثانية في “الحرس الجمهوري”)، في ندوةٍ للقيادات العسكرية لتحليل “الدروس والعِبَر” من معركة “الخفجي”، تخفيف الاعتماد على المعدّات الثقيلة، لأنَّ تدميرَها سهلٌ على الأميركيين، كما اقترح “إعادة صياغة الاستراتيجية للعمليات العسكريَّة”، بالتركيز على المشاة، في تشكيلاتٍ صغيرة، تضربُ وتهربُ، كما كان في “حرب فيتنام”.
لم يَرُق هذا الطرحُ له، بدت على قسماتِ وَجهِ صدّام حسين ملامحُ الغضب والامتعاض، وعندما شعرَ الضبّاطُ انعكاسَ ذلك على تصرّفات الرئيس، تكتّموا على ما عندهم من ملاحظات، وتساؤلات، وطروحات عسكرية، وانبرى كلُّ واحدٍ منهم يؤيِّدُ الرئيس، ويوافقه على كل ما كان يُبديه، وهو في الحقيقة لا يمتُّ بصلةٍ الى العلوم العسكرية، لا من قريبٍ ولا من بعيد.
بعد تلك الندوة، صارَ التملُّقُ والكذب والنفاق هي الاستراتيجية العسكرية الجديدة، الأمرُ الذي انعكسَ سلبًا على العمليات الحربية في ما بعد.
لكن صدّام حسين، عاد إلى ما طرحه الجنرال رعد الحمداني، فأقرَّ أنه كان من الأفضل، في معركة “الخفجي”، الاستعاضة عن استخدام “قوة من الجيش” بفرقةٍ خفيفة، وسريعةِ الحركة، من فرق ” الحرس الجمهوري”، المُدَرَّبة على القيام بالعمليات الخاصة.
***
فَرَضَ “قانونُ حرية المعلومات” على الإدارة الأميركية، سنة 2008 الإفراج عن ملفَّات التحقيق مع صدام حسين، فتهافَتَ الباحثون، والمؤرِّخون، والمُهتمّون بشؤون الشرق الأوسط، الى الغَرْفِ من مُعينِ تلك الملفّات المُتخَمة بما يضيءُ على جوانب مهمّة من جلسات التحقيق الرسمية، التي جرت في” كامب كروكر”، مركز العمليات لقوات الاحتلال الأميركي، بمطار بغداد الدولي، الذي فيه احتُجِز صدام حسين وجرت معه جلسات التحقيق الطويلة.
أشرَفَ على تلك الجلسات، “مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي” (أف بي آي)، وكان عددُها 20 جلسة، (ما عدا المُقابَلات غير المُعلَن عنها، مع المحامين والمستشارين القانونيين، وممثلي أجهزة استخباراتية متعددة الجنسيات حليفة للمُحتلّين الأميركيين).
في الجلسة الحادية عشرة من الاستجواب، أرادَ محقِّقو “مكتب التحقيقات الفيدرالي”، الوقوف على كيفيةِ نجاحِ الجيش العراقي في احتلال مدينة “الخفجي”، التي كانت على مقربة من الحشد العسكري العالمي في المملكة السعودية، (قرابة 15 كيلومترًا فقط)، لأنَّ تلك العملية “بهرتهم وأربكتهم”، كما اعترفَ نورمان شوارزكوف، القائد الأميركي، ولم يخفِ الأمير خالد بن سلطان، قائد القوات المشتركة، “ذهوله” من سقوط المدينة السعودية.
بعد سنة من “عاصفة الصحراء”، ذكر نورمان شوارزكوف، في كتابٍ صدر له عن” دار بانتام، نيويورك”، تحت عنوان “لا تحتاج إلى بطل”، ما مفاده أنَّ احتلال القوات العراقية لبلدة “الخفجي” أذهله، وحيَّره، وأربكَهُ، لأنه في الواقع “مُخالِفة لأيِّ منطقٍ عسكري”. وهذا بالفعل ما كان قَصْدُ صدام حسين من تلك العملية.
لكن القائد الأميركي لم يَعِش ليَطَّلع على كامل ما كشفته الوثائق العراقية حول تلك المرحلة، إضافةً الى تعليلات صدام حسين، وخلاصاته النقدية لعملية مدينة “الخفجي” ذاتها، التي كان يُمكن لها أن “تُضعضِعَ قوات التحالف الدولي”، على الرُغمِ من تفوُّقِها الجوِّي، (توفي الجنرال نورمان شوارزكوف يوم 27 كانون الأول/ديسمبر 2012).
أما الأمير خالد بن سلطان، فقد اعترفَ في كتابه: “محاربٌ في الصحراء” (صادر عن دار هاربر كولين، نيويورك، 1995)، أنَّ “الهجوم العراقي المفاجئ على “الخفجي”، هدَّدَ بإرباك استعداداتِ التحالف.
أرادَ المحقّق الأميركي، في جلسةِ الاستجواب الحادية عشرة لصدام حسين، يوم الثالث من آذار (مارس) سنة 2004، أن يعرفَ مَن الذي خطّطَ لمعركة “الخفجي”؟
سأل، فأجاب الرئيس العراقي الأسير بكلمة واحدة: “أنا”… ولم يَزِدْ
هنا، يخطر سؤالٌ آخر: لماذا أرادَ صدّام حسين تلك المعركة، ثم لماذا أعلنَ أمامَ قادة الميدان في الجيش العراقي، في اجتماعٍ تقويمي لسير العمليات، يوم 29 كانون الثاني (يناير) 1991، “إنه لا يجوز نسيان معركة الخفجي”!
قال صدام حسين لجنرالات جيشه، ربما لرفع معنوياتهم: “نريد أن نُثبتَ أنَّ العراق لا تلوي إرادته أيُّ قوة في العالم مهما عظُمت”.
***
بَعدَ الاحتلالِ الأميركي، قال أحد قادة الدفاع الجوي العراقي لمُراسل جريدة “واشنطن بوست”: “إنَّ النظامَ العراقي مُتَلبِّسٌ بالكذب”. (وليام براننجين، “حرب قصيرة ومريرة لضباط الجيش العراقي” 27 نيسان/أبريل 2003).
وكانَ الرجلُ على صواب… فجميعُ الأنظمةِ والحكومات تَكذُبُ على شعوبها، خصوصًا في أوقاتِ الأزمات الحادة. لكن نسبةَ الكذبِ تكون، بطبيعة الحال، أعلى في الأنظمة الفردية والديكتاتورية، منها في الدول التي تعتمد أنظمة ليبرالية… فالتفرُّدُ بالحُكم، يَفرُضُ السيطرة على وسائل الإعلام، بكلِّ أنواعها. وتجربةُ صدّام حسين مع الأميركيين تؤكّدُ ذلك. هو وَصَفهم أمامَ قادة جيشه، بأنهم “كذّابون وعديمو الكفاءة”، وهم اتهموه بأنه يُخفي عن بقية العالم برامج سريَّة خطيرة.
في أواخر سبعينيات القرن الماضي، سَمَحَ الرئيس حافظ الأسد، بهامشٍ أوسع من الحريَّة للأدباء السوريين، بأن يُشَكِّلوا نوادٍ أدبية، وأن يُقيموا ندواتٍ فكرية، وأُمسياتٍ شعرية… وحَدَثَ، أن قدَّم الشاعر والأديب والمسرحي ممدوح عدوان، مُطالعةً في أحد نوادي دمشق، عن “ممارسة الكذب في الدولة”. فقالَ إنَّ “النظامَ يكذب حتى في درجة حرارة الطقس في نشرة الأحوال الجويَّة من الإذاعة والتلفزيون، فتكون حرارة الجو خانقة فوق الأربعين درجة، فيُكلف المذيعون بالإعلان كذبًا، أن درجة الحرارة أقل من ثلاثين، ظنًّا من المسؤولين أن ذلك يُخفف من ضيق المواطنين”!
وكانَ أن حصلَ الصحافي السوري الراحل قصي صالح الدرويش، على نسخةٍ مُسَجَّلة من تلك المطالعة، عرضها على سليم اللوزي، فتلقّفها ناشر ورئيس تحرير مجلة ” الحوادث”، (كانت في هاتيك الأيام تصدر من لندن)، ونَشَرَ الموضوع، وتربّعَ على الغلاف عنوانٌ صارخٌ، أثار حفيظة نظام الأسد: “لماذا يَكذُب النظام؟”.
أما التغطية الإعلامية المصرية لحرب الأيام الستّة، حزيران (يونيو) 1967، فقد دخلت في التاريخ الإعلامي كحالةٍ خاصَّة، ليس فقط في اجتناب الحقيقة، بل في إعلانِ عَكسِها تمامًا… لكسب الوقت من أجلِ امتصاصِ النقمةِ على الهزيمة!
حربُ 1967، ظلًّت في ذهن صدام حسين، دليلَ مُقارنةٍ على تفوُّقِ استراتيجيته العسكرية، فامتدح سلاح الجو العراقي لدوره في تخفيف الخسائر، حيث قال: “من الناحية العملية، وبالنظر الى جدول خسائرنا الجوية، وحجم، وطبيعة ودوام العدوان الدولي على العراق، فقد استطعنا إنقاذ 75 في المئة من قواتنا الجوية، باستثناء ما دمَّرته قوات التحالف البرِّيَّة، أو ما حدث في الاضطرابات الأهلية”، (إشارة منه الى الانتفاضة الشيعية في جنوب العراق، وهو يقصد هنا الطائرات المروحية، لأنَّ الطيران العسكري من مقاتلات وقاذفات، كان محظورًا بموجب القرار الدولي رقم 688، حيث شمل الحظر الطيران الحربي العراقي من خط العرض 32 جنوبًا الى حدود الكويت والسعودية، ولحماية السكان الشيعة في تلك المنطقة من القصف الجوي، لكنه لم يشمل الطائرات المروحية).
ومضى يُقارِنُ مُعتَدًّا، فقال: “بالمُقارنة، خسر الطيران المصري نحو 70 في المئة من قوته الجوية في حرب 1967، مع العلم أنَّ القوات الإسرائيلية كانت أقلَّ، وأضعفَ كثيرًا من قوات التحالف الدولي الذي قاتل العراق”!
تأكيدًا على ما قاله صدام حسين، أعلن مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، في معرض تقويمه لمعركة مدينة “الخفجي”، أنَّ “الفرقة الخامسة في الجيش العراقي، وحدها، تحمَّلت ضربات جوية من قوات التحالف الدولي، أكبر مما تحمَّله الجيش المصري من إسرائيل في حرب 1967”!
***
مشكلةُ صدّام حسين في حرب “عاصفة الصحراء”، كانت مبالغته في قدرات جيشه على المواجهة الميدانية، ومشكلة جيشه كانت أن قادته لا يستطيعون مواجهته بالحقيقة. وهذا الواقع جعله يعيش “وَهْم”، النجاح المؤقت في معركة “الخفجي”، فظنَّ أنَّ بإمكانه تكرار ذلك في حرب “أم المعارك”، فانهزَم.
هذا الوَهمُ، أو سوء الفهم، أو سوء التقدير، أو التبجُّح، في وقتٍ أصبح العالمُ وحيدَ القطب، وهو مزمعٌ على المواجهة مع هذا القطب المتفوِّق في المجالات كلها، وليس معه أي سَنَدٍ عالمي أو عربي يُذكر، بالإضافة الى أنه كان لتوِّه خارجًا من حربٍ مُضنية وطويلة مع إيران، جعله يتصوَّرُ أنه كسب معركة “الوجود”، لمجرّد بقائه في السلطة، بخسارةٍ محدودة، خصوصًا بعد إجهازه على “الانتفاضة الشيعية” في جنوب البلاد، بغضِّ نظرٍ أميركي. بل هو بعد انسحابه من الكويت، لم يتأخّر، في إعلان انتصاره على أكبر، وأقوى، حشد عسكري في تاريخ المنطقة العربية، كما تبيَّن من الوثائق العراقية المُصادَرة. فقد أعربَ عن شعوره بأنَّ جيشه “واجه حالة فريدة في التاريخ العالمي”. فسأل قادة جيشه، مُعتزًّا: “أينَ جاءَ في كتب التاريخ، أنَّ قصفًا جوِّيًا تمهيديًّا، استمرَّ لمدة شهر ونصف الشهر، بصورة متواصلة؟ في أيِّ كتابٍ كُتِب؟ هل دُوِّنَ في أيِّ سجلٍّ للحروب؟”.
وتعجَّل الاستدراك: “أقصدُ أنَّ هذا الهجوم من غير الممكن قياسه”.
تابع مفاخِرًا: “يجب أن نقول، بصورةٍ قاطعة، إنَّ العراق هو سيِّدُ العالم، عندما يتعلَّقُ الأمرُ بالإيمان، والصمود، والقدرات العقليَّة، وثبات الأعصاب، والطاقة البشرية على التحمُّل، لأنه لم يسبق أن حدثَ مثل هذا الهجوم في التاريخ” (عن الوثائق العراقية، كما ورد في كتاب الباحث الأميركي كيفين وودز “أم المعارك”، تقرير رسمي لقيادة القوات المشتركة الأميركية، منشورات معهد البحريَّة، 2008).
هذا كلامٌ قاطعٌ، في تعريف صدام حسين للنصر، حيث أعلن “انتصاره” وهو، في الواقع، مُنكَسِرٌ ومَهزومٌ.
إن الناظَرَ المدقِّق في هذا الكلام، يخرجُ باستنتاجٍ وحيد، هو أن المفاهيم الخاطئة التي استخلصها صدام حسين من حرب الكويت (1991)، أدَّت في حرب 2003 إلى الاحتلال الأميركي، فكانت قاتلة له ومُميتة لنظامه.
***
لم يَكُن غرورُ صدّام حسين، أو اعتدادُهُ بنفسه، ومبالغته في تقدير قوة جيشه، السبب في انكساره وهزيمته، إنّما السببُ يكمُنُ في “الالتباس الفكري”، (ربما نتيجةً لضعف ثقافته الأساسية)، حيث ينطلقُ في طَرحِ مفاهيم النقاش طرحًا سليمًا، ليستخلص منه العبرة الخاطئة، أو حتى العبرة المُعاكسة. فقد نقل “معهد الشرق الأوسط للإعلام” في واشنطن قوله لجنرالات جيشه: “السياسةُ علمٌ، وفي كلِّ علمٍ هناك اختبارات، والسياسيُّ الناجحُ هو تلميذٌ أبديٌّ، يستفيد دائمًا من اختباراته الشخصيَّة، واختبارات الناس الآخرين. إننا نؤمن بأهمية الرأي العام وتأثيره، ونتعلّم من تجاربنا. إنَّ ارتكابَ الأخطاء فعلٌ بشريٌّ يُمكِنُ تصحيحه”.
فإذا كانَ صدّام حسين يقصدُ “الرأي العام العربي”، فهو قطعًا وَاهِمٌ. فما يُسمَّى “الشارع العربي” أو “الرأي العام العربي”، هو حتى الآن شيءٌ “وَهْمِيٌّ”، ولا تأثير له في السياسات التي يرسمها الحكَّام من غيرِ أيِّ اعتبارٍ لأحد، وهو أدرى الناس بذلك، لانعدامِ أيِّ اعتراضٍ في بلده، أو حتى في نظامه، وقادة جيشه وبين المقرَّبين منه أيضًا. وهو يُجانِبُ الحقيقة، داخل العراق، أو أيّ بلدٍ عربي آخر، إذا تَوَهَّمَ أنَّ شعارات وقضايا، مثل “القومية العربية”، أو “الإسلام هو الحل”، أو “القضية الفلسطينية”، لها أيُّ تأثير يُذكر في صياغةِ السياسات الفعلية للأنظمة العربية، بل على العكس من ذلك، فإنَّ تلك الأنظمة تَتَّخِذُ كلَّ تدبيرٍ مُتاحٍ لها لإجهاضِ تلك القضايا والشعارات. وهذا أمرٌ يعرفه صدام حسين جيدًا، (كما مرَّ معنا)، عندما قال إنّهُ ليس ضدّ الحلّ السلمي (للقضية الفلسطينية) بالمُطلق، ووصف “منظمة التحرير الفلسطينية” بأنها مثل “الصابونة التي تغسل فيها الأنظمة العربية يديها (من القضيَّة)، “بما فيها نظامنا”، حتى إذا باتت “بروةً” لا رغوةَ فيها، تُلقى في سلة المُهملات”!
كلُّ ذلك، جعل القوى المُتحالفة ضدَّ صدام حسين، وفي مقدّمهم الأميركيون، تعتقد بأنه “رجلٌ غامضٌ”، حتى لو تفوَّهَ بكلامٍ صحيحٍ، أو معقول. وبالتالي، اعتبرَ الدارسون والمُحَلّلون للوثائق العراقية، أنه يضعُ على وجهه أقنعة مُتعددة، وغير مُتشابهة. فراحوا ينزعون تلك الأقنعة، واحدًا بعد الآخر، ليتمكّنوا من قراءة ما وراءها. ويمكن القول، من خلال ما صدر من كتب، وتحليلات، ودراسات… أنهم لم ينجحوا تمامًا في تلك المهمّة.
ولذلك، فإنّهُ منَ المُتوقَّع أن يصدرَ في المستقبل، القريب والبعيد، سيلٌ جديد من الكتب، والدراسات، حول صدام حسين “العراقي الغامض”، الذي أخفى ما في عقله وراء أقنعةٍ سميكةٍ استعصى بلوغ كنهها على مَن حاول ذلك.
لكن المُلاحَظ، أنَّ كلَّ كتابٍ صدر، أو دراسةٍ وُضعت، أو تحليلٍ نُشر، قدّمَ جُزءًا من تركيبة ذلك اللغز، وما زال هناك الكثير من الأجزاء غير المُرَكَّبة في مكانها الصحيح لتكتمل الصورة.
***
يقفُ الدارسون للحالةِ العراقية، ونحنُ منهم، حيارى في تفسيرِ انجرارِ صدام حسين الى “الحفرة” التي وَقَعَ فيها… والمُحَيِّر في الأمر، أنه قبل ستة أشهرٍ من غزوه الكويت، أي في 24 شباط (فبراير) 1990، أبلغ حلفاءه الملك حسين، والرئيس حسني مبارك، والرئيس علي عبد الله صالح، في “مجلس التعاون العربي” المُنعَقد في عمَّان، بدورته السنوية الثانية بعد تأسيسه، ما لم يكن مطروحًا على بساط البحث في أيِّ محفلٍ عربيٍّ رسمي، وهو أثر وتأثير تفكك الإتحاد السوفياتي وغيابه عن المسرح الدولي، بحيث أصبح العالم “أحاديَّ القطب”، والمجالُ حكرٌ على الولايات المتحدة وإسرائيل، بكل ما يعنيه ذلك من أطماعٍ في الثروات العربية، والتحكُّم بمسار ومصير الشرق من دون استثناء.
واستفاضَ الرئيس العراقي في شرح رأيه، فاعتبرَ أنّ التوازُنَ الدولي سوف يبقى مُختلًّا لصالحِ الأميركيين والإسرائيليين إلى سنواتٍ عدة مقبلة، حتى يقوم في العالم توازنٌ جديد.
وقالَ مُنَبِّهًا الحلفاء ليسمع كل العرب: “إننا لا نخافُ من هذا الاختلال الدولي، طالما بقينا مُوَحَّدين. إنَّ ضعفنا الظاهري، لا يَكمُنُ في خصائصنا الموروثة، أو خصوصيتنا الفكرية، بل في انعدامِ الثقة بيننا. فليَكُن شعارنا من الآن وصاعدًا: كُلُّنا أقوياء في وحدتنا، وكُلُّنا ضعفاء في تَفرُّقِنا”.
تساءلنا نحن، قبل المُحَلّلين في الغرب: لماذا، إذن، قام قائلُ هذا الكلام باحتلالِ دولةٍ عربيةٍ جارة، بعد أقل من ستة أشهر على تحليله هذا؟
وسبقنا أولئك المحللين الى ما استنتجوه، بعد اطلاعهم على كلِّ ما هو مُتاحٌ لهم من وثائق، ومواد أرشيفية، ودراسات سياسية واستراتيجية، ومذكرات، أنَّ غاية صدام حسين من احتلاله الكويت، لم تَكُن طمعًا “بثروة الكويت النفطية”، كما كانَ شائعًا، إنما هو نتيجة تفسيره للتحوُّل في ميزان القوة الدولي، ومحاولة استباقه بإقامةِ وَضعٍ استراتيجي للعراق أقوى مما خرج به من حرب إيران.
فهو ظنَّ، خطأً، أنَّ مجيء جورج بوش الأب، سنة 1990، إلى المكتب البيضاوي في “البيت الأبيض”، سيكون فاتحةً لفَصلٍ جديدٍ في العلاقة بين بغداد وواشنطن، باعتبار أنَّ الرئيس الأميركي الجديد، رجلٌ عملي براغماتي، ولا يحملُ توجّهات إيديولوجية يمينية شديدة مثل سلفه رونالد ريغان، وبالتالي، فإنه سوف يحترمُ صدارة العراق في الفضاء الخليجي، فاكتشفَ صدام حسين، أن نيَّات الرئيس بوش الأب تجاه العراق، كانت “غير سليمة”، وأنه لن يسمح لأحد، أن يُنازِعَ الولايات المتحدة “الهيمنة” المُطلقة على الخليج.
أَيقَنَ صدام حسين، عندئذ، أنَّ إسرائيل سوف تُحاوِلُ الاستيلاء على كامل فلسطين، في نكبةٍ أفدح من النكبة الأولى (1948)، بالنظر إلى تدفُّقِ المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفياتي السابق، مما يؤذن بموجة “استيطان صهيونية جديدة” تبتلع ما تبقّى من فلسطين.
في ذلك الوقت المبكر، استحوذت على الرئيس العراقي، الخشية من قيام إسرائيل بشنِّ حربٍ توسُّعية جديدة، تُطاوِلُ العراق، فحذَّرَ الدولة العبريَّة من مغبّةِ شنِّ عدوانٍ عليه، كما فعلت في العام 1981 بتدميرها “مفاعل تموز” النووي، وهدَّدَ بحرق نصف إسرائيل إذا ما تجرّأت وقامت بمثل هذا العمل العسكري.
لقد دحضت تلك الدراسات، كل ما شاع، وقتها، عن أنَّ عينَ صدام حسين كانت على الثروة النفطية الكويتية، لمّا أمر بغزو الإمارة الصباحية، وكذلك، تفسير حديثه المُتَشدّد تجاه إسرائيل، بأنه قنبلة دخانية، لكسب الشعبية في العالم العربي، وكغطاءٍ لأطماعه في الكويت والخليج. وأيضًا بالنسبة إلى القائلين بأنه استخدم “الفزَّاعة الصهيونية” ليصرف أنظار العراقيين عن وضعهم الاقتصادي البائس بفعل الحرب الطويلة مع إيران.
أحدُ الباحثين الأميركيين، الذين صرفوا وقتًا في دراسة وتحليل تصوُّر صدام حسين للعالم “الوحيد القطب”، اعتبر أنَّ غزوة الكويت، هي في واقع الأمر، “حربٌ مع إسرائيل، وليست مع جيرانه الخليجيين”، وادَّعى أيضًا أنَّ مخاوف الرئيس العراقي من العدوانية الإسرائيلية كانت مخاوف حقيقية، وغير مُفتَعلة، وأنها جُزءٌ من مخاوفه من التصرّفات الكويتية. (دانيال تشاردل، مجلة “الباحث”، العدد الثالث، المجلد السادس، صيف 2023).
***
سقطت بغداد، توارى صدام حسين، عاد الى منبته “تكريت”، ولجأ إلى “مزرعة الحدوشي” في بلدة “الدور” (لفظة بابلية وآشورية تعني “القلعة”)، وفي منزلِ رجلٍ اصطفاه، ووثق به أقام، وليس في المخبأ تحت الأرض، كما شيَّعَ الأميركيون، للنيل من الرئيس الأسير وتحقيره.
كانَ صدّام حسين يجول، في النهار، مُتَخفّيًا ومحروسًا، في بلدات محافظة صلاح الدين، يتنقل من “بعقوبة”، إلى “سامراء”، و”تكريت”، يجمعُ المقاومين من فلول الجيش، الذي فككه، وسرّحه بغباوة، بول بريمر، الحاكم الإداري للعراق، باعتباره رئيس سلطة التحالف المؤقتة. ويتواصل مع عزّة إبراهيم الدوري، الذي كان شكّلَ فرق مقاومة من أتباع الحركة النقشيندية الصوفية.
كانَ صدام حسين “الهدف رقم 1 الأعلى قيمة”، كما وصفته اللائحة الأميركية للمطلوبين.
“فرقة العمليات المشتركة 121″، قامت بما يزيد على عشرين محاولة للعثور على “الهدف رقم 1″، وبما يزيد عن 600 عملية مُداهَمة في بلدات وقرى العراق، و300 تحقيق مع معتقلين اشتُبِهَ أنهم على درايةٍ بمخبَإِ الرئيس المطلوب.
وكان صدام حسين، بثَّ العيون، ترصدُ تحركات الأميركيين، في القرى والنواجع، المُولَجين بالبحث عنه.
يوم 12/12/2003 وصل صدام حسين، خبر اعتقال العقيد في جهاز الأمن الخاص، محمد ابراهيم عمر المسلط، في منزله ببغداد الذي حوله إلى مركز لمقاومي الاحتلال الاميركي. وتناهى إليه، أيضًا، أنَّ المسلط خلال التحقيق معه، ضَعُفَ، وقد يكون أسرَّ عن مكان وجوده… لكن صدام حسين، كان يثق بالعقيد، ويعرف أنه لن يفشي بسرٍّ ائتمنه عليه، إضافةً إلى أنَّ المسلط من عشيرة “البيكات”، من قبيلة “البوناصر” التي ينتسب صدام حسين إليها.
ليلة الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) 2003 وصلت صدام حسين إشارة، أنَّ رتلًا من المصفّحات الأميركية يتَّجه إلى “الدور”، فترك صدام حسين البيت إلى “حفرة العنكبوت”، كما كان يُسميها، وفي ظنّه أنَّ المُداهمين سيفتشون المنزل، ثم يغادرون.
دخلت “فرقة العمليات المشتركة 121” بدعمٍ من اللواء القتالي الأول، بقيادة الكولونيل جيمس هيكي، بلدة “الدور”، وتوجّهت مباشرة الى المزرعة، وإلى “حفرة العنكبوت” كما قال لهم الواشون، الذين سمّاهم صدام حسين في حديثٍ مع المحامي خليل الدليمي، (تولى الدفاع عن صدام حسين ما بين 2005- 2006)، وهم قيس النامق وإخوانه، واللواء كمال الدوري.
أُخرِجَ صدام حسين من “حفرة العنكبوت”، أعلن عن نفسه للجنود الأميركيين الذين اعتقلوه أنه “رئيس الجمهورية العراقية”، مُضفِيًا على نفسه شرعيةً كاملة، مُقابل احتلال غير شرعي، متوقِّعًا أن يتفاوضوا معه على حلٍّ يقيهم غضب الشعب العراقي، ويقي العراق من دمارٍ محتوم في حال أصرُّوا على الاحتلال، وهذا ما جعلهم يعتبرونه “أسير حرب” تسري عليه القوانين الدولية المتعلقة بأسرى الحرب. ولذلك اعترض الحقوقيون على حكم الإعدام بحقه، لأنه مخالف للقانون الدولي الذي يحظّرُ إعدام “أسرى الحرب”.
وصار ما صار مما بات معروفًا…
كثيرون لاموه أنه “لم ينتحر” لحظة مجيئهم للقبض عليه ليتجنَّب “عار الهزيمة” و”المصير التعس” الذي كان ينتظره. لكن صدام حسين، لم يعتبر نفسه مهزومًا، فهو كان عَزَمَ على المقاومة حتى الرمق الأخير، أو حتى يخرج المحتلّون لبلاده خائبين.
أما “الانتحار”، فإنه في نظر عارفيه، لا يُمكِنُ أن يكونَ قد مرَّ في ذهنه لحظة واحدة، ولو كخاطرةٍ عابرة، لأنه لن يُسَجِّلَ على نفسه في سجلّات التاريخ، أنه “جبانٌ”، أو مستسلمٌ للأقدار أو للصعاب، أو حتى للحياة، فحياته الحقيقية هي في ساحات الوغى، ثم إنَّ “الانتحار” من الآثام في الإسلام، وهو المؤمن، المُتَعَبِّد، الذي أطلق الحملة الإيمانية، (كما مرَّ).
لم يَعِش صدّام حسين ليرى هذا السَيلَ العارم من الورق والحبر، الذي لمَّا يَزَل دافقًا. ولم يقرأ ما يُكتَبُ بكلِّ لغات الأرض عنه، وعن حكمه، ومآثره … وسيظل يُكتَب إلى أمدٍ طويلٍ في المستقبل، المنظور منه وغير المنظور… فكيف، بعد ذلك كله، تنطبق عليه مواصفات “الهزيمة”، مع أنه هُزِمَ في النهاية، بعدما تجمّعت عليه جيوش العالم القريب والبعيد.
إنه المهزوم غير … المهزوم!
(تصدر هذه الحلقات قريباً في كتاب منقح ومزيد)
العراقي الغامض
قراءة متأخرة في عقل صدام حسين
(16)
الخليجي
28/8/2024
سَنَتَها، في أواسط سبعينيات القرن الماضي، حّوَّلَ المطرُ دَربهُ عن المنطقة شبه الصحراوية المُحاذية لحدود المملكة العربية السعودية.
الجفافُ، أكلَ الأرضَ العاشبة، فأصبحت مجدبة، والعيون، التي كانت فوَّارة، باتت شحيحة، نزَّازة.
لعَنَ رعيان تلك القرى والبوادي الماء، والقدر، والأرض المُشَقّقة، ووصلت شكواهم الى آذان صدّام حسين، “نائب الرئيس” وقتها، فاستدعى خبراء الجيولوجيا، والمياه، والري، وسألهم المشورة، فأشاروا عليه حَفرَ آبارٍ ارتوازية لاستخراج الماء الزلال من جوف الأرض.
لم يُكَذِّب “السيد النائب” خبرًا، أعطى الأوامر، فتوجّهَ الفنّيون مع آلات الحفر إلى تلك المنطقة. وفي غضونِ أيام، كان الماءُ يتدفّقُ من بَطنِ الأرض عذبًا، سقى الناس، والمواشي، والأرض العطشى… فأصبح اسم “السيد النائب” يملأُ أفواه وقلوب سكان تلك النواحي.
في القاطع السعودي، كان الرعيان يراقبون ما كان يجري ويدور، وعندما استُخرِجَ الماء، هرعوا بمواشيهم، ونوقهم، لتنهل من الماء العراقي الزلال.
نظرَ العراقيون إلى المُتَوَجِّهين نحو ديارهم، بتبرُّمٍ واشمئزاز، ورفضوا أن يُقاسمهم جيرانهم الماء. والتلاسُن، تحوَّلَ الى مُشادَّات، واشتباكات بالعصي والنبابيت.
استشكلَ الأمرُ على السلطات الأمنية، فحارت كيف التعامُل مع الرعيان السعوديين، فأوصلت الإشكال إلى صدّام حسين، فأفتى وأمَر: ” لا تمنعوهم… قولوا لهم: إننا حفرنا الآبار لنا ولكم”.
تَصَرُّفُ صدّام حسين، يومها، ليسَ لفَضِّ المشكلة، إنما أراد، وهو يطمح الى الرئاسة والسلطة المُطلَقة، أن يُوَطِّئ الدَربَ إلى الخليج، وإرسالَ إشاراتٍ إلى السعوديين أنّهُ حريصٌ على ودّهم، وعلى أفضل العلاقات معهم، ومن خلالهم، مع الدول الأخرى في المحيط الخليجي.
وهكذا كان… فالتواصُل ظلَّ يربط العلاقات، بين الرياض وبغداد، حتى في أحلك الفترات.
***
لقد لمستُ بنفسي، سنة 1969، مدى حرص بغداد على التوادِّ مع الرياض، وعدم تعكير صفو العلاقات معها.
فقد قُرَّ الرأي، على إعادة إصدار “الأحرار”، التي كانت مُتَوَقِّفة، كوسيلة فكرية وإعلامية “لحزب البعث”، تكونُ قريبةً من ميشال عفلق، الأمين العام للقيادة القومية، الذي كان مُقيمًا في بيروت في هاتيك الأيام. وقد زكّاني عفلق لتلك المهمّة، فحوَّلتُ “الأحرار” من جريدة يومية الى مجلّةٍ أسبوعية.
ونحنُ نُحَضِّرُ لإصدارِ العدد الأول، تَجَمّعَت لدينا معلومات عن “محاولةٍ انقلابية” ضدّ الملك فيصل بن عبد العزيز، فنشرنا تحقيقًا مُسهَبًا، مُتخَمًا بالمعلومات من داخل البيت السعودي، عن تلك المحاولة، احتلَّ الغلاف وكان عنوانه: “واشنطن تُعِدُّ الأمير فهد لحُكمِ السعودية”.
بعد صدور العدد، الذي تناقلت موضوع غلافه غير وكالة أنباء عربية ودولية، تناهى إليَّ استياء المسؤولين في بغداد من الموضوع، وكُلِّفَ أحدهم، هو اليوم صار عند ربّه، أن يُبلِغَني ما تراه القيادة في بغداد: “كان من الأجدر أن تتصدّرَ المجلّة، في عددها الأول، مقابلة مع “الأستاذ ميشال”، أو مع الرئيس البكر، لإظهار هويتها، وشدِّ انتباه الحزبيين إليها”.
ظننتُ أنَّ بساطَ البحثِ حول العدد الأول قد طُوي، وأنَّ استياءَ القيادة وامتعاضَها قد محته الأيام، إلّا أنَّ ظنّي لم يكُن في محلّه.
في مطلع صيف سنة 1970، انعقدت في طرابلس الغرب، بدعوةٍ من العقيد معمر القذافي، الذي لم يَكُن قد مضى تسعة أشهر على إطاحته الملك إدريس السنوسي، قمّة عربية مُوَسَّعة، وتلتها قمة دول المواجهة، شارك فيهما الرئيس جمال عبد الناصر، (توفي بعد ثلاثة أشهر من القمّتين)، والرئيس أحمد حسن البكر، الذي التقيته مع رياض طه، نقيب الصحافة اللبنانية آنذاك، في قصر الأمير الرضا السنوسي ولي العهد السابق، وكان مقرَّ إقامته المُخَصَّص له من الحكومة الليبية … سألتُ الرئيس البكر ما إذا كان وقته يَتَّسِعُ لإجراءِ مقابلةٍ معه للمجلة، فبادرني على الفور: “تأخَّرتَ كثيرًا…”
ثم استدرك: “وقتي الآن ضيِّق، فبعد اجتماعات القمّة، سأُغادِرُ إلى الجزائر في زيارةٍ رسميَّة. لكن بإمكانك أن تُرسِلَ لي إلى بغداد أسئلة مكتوبة لأجيب عنها”.
فهمتُ، وقد وصلتني الرسالة من أوّل كلمتين: “تأخّرتَ كثيرًا”، فلا هو، ولا مَنْ معه في القيادة السياسية، تناسوا ذلك التحقيق الذي رَؤوا أنه أحرجَ بغداد أمام الرياض.
كانَ الوفدُ العراقي إلى قمَّتَي طرابلس ملفتًا، لأنه ضمَّ نائبَي الرئيس، حردان التكريتي وصالح مهدي عماش، إلى جانب وزير الخارجية الدكتور عبد الكريم الشيخلي، تاركين صدَّام حسين على رأس الدولة في بغداد، حيث أتاحَ له ذلك، في غفلة، التخلُّص من هؤلاء المسؤولين الكبار.
إنَّ تشكيلَ الوفد العراقي إلى طرابلس الغرب، على هذا النحو، يطرحُ أسئلةً لها معنى في تلك الظروف، حيث من المفترض أن يبقى أحد نائبَي الرئيس في البلاد ليقوم مقام الرئيس الغائب. وأول هذه الأسئلة، هو ما إذا كان البكر، في تلك المرحلة، على تواطؤٍ مع صدّام حسين للتخلُّص من منافسيه الثلاثة، كما حدث بالفعل، أو ما إذا كان البكر يريد ترفيع صدام الى نيابة الرئاسة، فوفَّر له تلك الفرصة.
***
“حبلُ الودِّ” بين الرياض وبغداد، لم ينقطع، لا بعد غزوة الكويت، ولا عندما تجمّعت على أرضِ المملكة العربية السعودية، جيوش ثلاثين دولة بينهم دول عربية، في تحالُفٍ غير مسبوق، لمحاربة عراق صدّام حسين، حرَّضت عليه مارغريت ثاتشر، رئيسة الحكومة البريطانية، وانقادَ إليها جورج بوش الأب، رئيس الولايات المتحدة.
لكن ما كان في الظاهر غير ما كان في الباطن. في العلن كانت الحملات الإعلامية على أشدِّها، وراحت صحفُ البلدَين تتفنَّنُ في “الردح”، على الطريقة التي كانت سائدة في زمن جمال عبد الناصر.
مُشادَّاتٌ، ونبشُ تواريخ، وتجريحٌ في العلن، تُقابلها اتصالات ولقاءات بالخفية. وقد استمرت تلك “الازدواجية” بعد العمل العسكري العراقي ضد الإمارة الصباحية، وبعد الهجمة الدولية، وهزيمة العراق!
الطرفُ السعودي الذي “هندس” تلك “الديبلوماسية السرّيَة”، إذا ما جاز التعبير، هو ذاته الذي بَلوَرَ التفاهُم بين البلدين، قبل، وأثناء الحرب الضروس ضد إيران (1980 – 1988)، يتقدّمه الأمير عبد الله بن عبد العزيز (ولي العهد وقتئذ)، ويضم الأمير سلطان بن عبد العزيز (وزير الدفاع)، الذي زار بنفسه شبه جزيرة” الفاو”، بعد إخراج القوات الإيرانية التي احتلتها في المرحلة الأخيرة من الحرب، وتعهَّد بإعادة إعمارها، والأمير تركي الفيصل (مدير الاستخبارات).
كان الأمير عبد الله، يُحمِّل نائبه في “الحرس الوطني”، عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري، رسائل إلى المسؤولين العراقيين، فكان الشيخ المحنَّك، يتردَّد على العراق، ويُقابل صدّام حسين، الذي أنس له. وفي مرَّاتٍ رافق الشيخُ وليَّ نعمته الأمير عبد الله، في رحلات الصيد، التي كان يقوم بها في البادية العراقية، لم يغب عن لقاءات الأمير مع صدام حسين، بحضور طارق عزيز.
أما على الطرفِ العراقي، فقد كان صدام حسين يُشرف بنفسه على تلك “العلاقات السرّية” التي كان يُحرِّكُ فيها كلًّا من برزان التكريتي، خصوصًا بعدما انتقلَ إلى “جنيف”، ليكون ممثل العراق في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، وطارق عزيز الذي كان أبرز المسؤولين العراقيين العارفين بتلك العلاقات، والمُخطّطين لها، وهو الذي أقنع صدام حسين بالمضي في مساعيه للتفاهم مع السعوديين، “لأنَّ في يدهم مفتاح الخليج”، انطلاقًا من نظرية “تفاهم الضرورة”، التي مَحْوَرَ سياسة العراق الخارجية حولها، وسبعاوي ابراهيم الأخ الآخر غير الشقيق للرئيس العراقي، الذي كان يتردد على الرياض، والاجتماع بالأمير تركي الفيصل.
حدثَ، بموافقة صدَّام حسين، أن طلبَ برزان التكريتي لقاء الأمير عبد الله بن عبد العزيز في “جنيف”، وبعدما تبلغ الملك فهد بهذا الطلب، سمح لولي عهده بمقابلة المسؤول العراقي، فكان اللقاء في فندق “أنتركونتينتال”.
***
كان العراقيون في كل مباحثاتهم السرّية مع السعوديين، يطرحون، أنَّ مَنعَ الحرب، يكمُن في تفاهمٍ سعودي-عراقي حول مستقبل المنطقة. فقد كان صدام حسين يعتبر أنَّ العراق “دولة خليجية”، وإنَّ ما يمنعه من ذلك حرمانه الإطلال على بحر الخليج، كما خطَّط له السير بيرسي كوكس، ورفض الكويتيون تصحيحه برسم حدود الواجهة البحرية بعد نيلهم الاستقلال. (كما مرَّ في فصل “المُنظِّر”).
وحرصُ صدام حسين، على الوجه الخليجي للعراق، جعله يَتَفَهّمُ مُبرّرات قيام” مجلس التعاون الخليجي”، فتوجّه إلى الخليجيين قائلًا: “نحن ممتنون، إذا أردتم التعاون، والأفضل أن تكونوا مُتَّحدين، لأنَّ في ذلك قوةً لنا”.
إمعانًا في خطب ودِّهم، وصف إقامة مجلس التعاون الخليجي بأنه “عملٌ عقلاني”. واستدرك، كأنه عرف أنه لن يُقبَلَ في صفوفهم: “إننا نبارك الاتحاد من دون أن نكون فيه، وقد باركنا به”.
أراد صدام حسين أن يكونَ “سيف الخليج”، وليس كما كان الشاه “شرطي الخليج”، فالشرطي يأمر، ويُهيمن، وحامل السيف يُدافع.
في دردشة صريحة مع أحد الزملاء اللبنانيين في لقاءٍ بينهما في بغداد، أسرَّ طارق عزيز، أنَّ المباحثات التي دارت بالخفية، مع السعوديين، كانت دانية القطاف، لولا تدخّل إسرائيل، “المُتفاهمة” مع طهران، التي وجدت في التوافق العراقي-السعودي ما يتهدَّدُها، ويشكل قوَّةً ضاربةً في وجهها، فحرَّضَ الإسرائيليون الولايات المتحدة للضغط على الرياض لقطعِ حبلِ الودِّ، وسرّعت في التحضير للهجمة على بغداد.
لكن على الرُغم من كل ذلك، ظلَّ هذا المسار مُستَمرًّا من الغزو العراقي للكويت، إلى الاحتلال الأميركي للعراق، وإسقاط نظام صدام حسين.
***
لقد اتَّضحَ، منذ البداية، أنَّ انقضاضَ صدام حسين، سنة 1979، على “ميثاق العمل القومي”، بين بغداد ودمشق، الذي وقَّعه البكر وحافظ الأسد، كانت غايته أن يكونَ “العراق دولة خليجية”. ففي الخيار بين “سوريا” و”الخليج”، اختار صدام حسين “التوجُّه الخليجي”، لأنه كان مُزمِعًا على محاربة إيران دفاعًا عن دول الخليج، ولتصوُّره الذي لم يكن يُخفيه، بأنَّ سوريا تقف في الصف الإيراني، وكانت لديه معطيات كافية لتأكيد صواب ما ذهب إليه.
هذا التصوّر العراقي، الذي استحوذَ على سياسة صدام حسين، بالنسبة إلى إيران وأطماعها في الخليج (ومنه العراق)، نكره، وتنكَّر له، الخليجيون، ولم يعترفوا به، ولذلك أسبابٌ منها خوفهم من “طبيعة” النظام العراقي، وعدم ثقتهم بقيادة صدام حسين. فقد اعتبر السفير عبد الله بشارة، أول أمينٍ عام لمجلس التعاون الخليجي، أن توجُّه صدام حسين هو من الأساليب “غير الأخلاقية”، وجعل الابتعاد الخليجي عنه من الأسباب الموجبة لإقامة “مجلس التعاون الخليجي”.
ويُمكن استخلاص ما قاله عبد الله بشارة، بما مفاده: “إن فكرة تأسيس مجلس التعاون الخليجي، جاءت من استياءٍ تولَّدَ لدى قادة الخليج، من الأساليب غير المعتادة، وغير الأخلاقية، التي اتبعها بعض العواصم، لتأمين الموافقة الخليجية على البرنامج الذي وضعته بغداد ضد مصر (الساداتية)، فضلًا عن نجاح الثورة الإيرانية، وما رافقها من صخبٍ ثوري، شعاراتي، موجَّهٍ ضد الخليج، وانفجار الحرب العراقية–الإيرانية في أيلول (سبتمبر) 1980، والوضع المتوتر بين سلطنة عُمان واليمن الجنوبي، والتبدّلات التي شهدتها الساحة الدولية، على أثرِ غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان، والتهديد الذي رافقه لاستقرار باكستان”. (“مجلس التعاون الخليجي: دواعي التأسيس من وجهة النظر الرسمية”، عمر الحسن، بحثٌ في كتاب “مسيرة التعاون الخليجي: التحديات الراهنة، والمخاطر المستقبلية”، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2015).
نقطتان مهمّتان في هذا الكلام، واحدة ظاهرة، وأخرى مُستترة، وكلتاهما تُنكران أي دور للعراق في الخليج: الظاهرة منهما، هي التنديد بمساعي بغداد لتشكيل حالة عربية رافضة للصلح المنفرد مع إسرائيل، ومحاولتها إرغام دول الخليج على السير في هذا النهج. أما المستور، فهو نكران “خليجية العراق” جملةً وتفصيلًا… وبالتالي، التنكر للمقاصد العراقية المعلنة بأنَّ حرب صدام حسين ضد إيران الخمينية، كانت غايتها الدفاع عن الخليج”.
الدارسون لموضوع العراق والخليج، في المراحل اللاحقة لاحتلال الجيش العراقي للكويت، لا يستطيعون تَجاهُلَ وجهة النظر المُتَضَمِّنة بين السطور في عرض عبد الله بشارة للأسباب الموجبة التي أملت تأسيس “مجلس التعاون الخليجي”. لكن هذا الاستدلال يبقى وحيد الجانب، ما لم يقفوا على وجهة النظر العراقية حول المسألة الكويتية، ليس في عهد صدام حسين فقط، إنما في السياق التاريخي السابق له.
حتى تصوُّر صدام حسين للمسألة (كما مرَّ أيضًا في فصل “المنظِّر”)، قبل خمس سنوات من الحرب مع إيران، كان يرفضُ أمرين لا يعترف بهما الخليجيون:
الأول، هو أنه لا يضع إشكالية رسم الحدود مع الكويت، في “الإطار التوسُّعي” لبلاده.
والثاني، أنه لا يريد التشبُّث بالماضي، (أي المسعى العراقي في العهود السابقة لضمِّ الكويت الى العراق). لقد كان بالفعل يُريدُ حلًّا واقعيًا، هو في نظره، الحلُّ المتمِّمُ لخليجية العراق. أما الخليجيون فقد كانوا عازمين من البداية رفض إضفاء أيّ صفة خليجية على العراق، كما كان يتوخّى صدام حسين، من بداية عهده.
***
على الرُغمِ من صَدِّهم مساعي صدام حسين، فقد حاول الخليجيون، مُجاملته بإجراءٍ شكليٍّ لا قيمة فعلية له، وهو الموافقة على مشاركة وزير الإعلام العراقي في اجتماعات وزراء إعلام الدول الخليجية، وهم عندما سمحوا بذلك، كانوا يعرفون أنَّ المشاركة في اجتماعاتٍ إعلامية، لا تُضفي عليها صفة سياسية جادة ومُلزِمة.
صادف ذات يوم في العام 1983، أن التقيتُ وزير الإعلام العراقي لطيف نصيف جاسم (الدليمي)، فسألته عن مشاركته في اجتماعات وزراء إعلام الدول الخليجية، وماذا يبحثون فيها، ففاجأني بالقول: .”إنني أخجل أن أقول ما هي الأشياء التي كانوا يتحدثون، أو يتسامرون بها”.
قلتُ مُستغَرِبًا: “ألا يتحدّثون بالسياسة؟”.
ردَّ هازئًا: “لا بالسياسة، ولا حتى بالإعلام. كل الحديث عن “الونسة”، و”السفر وتوابعه”، وما الى ذلك!”.
هذا يعني أنَّ الدول الخليجية، المؤسِّسة لمجلس التعاون، ليست جادَّة حتى بتطوير المجلس في اتجاه التعاون الفعلي المُثمِر. فقد عرض الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، في القمة الخليجية المُنعقدة في الرياض في العام 2011، مشروعًا لتحويلِ مجلس التعاون إلى “اتحاد” بين الدول الأعضاء، فلم يلقَ استجابة.
وفي قمة 2013، جرت محاولةٌ جديدة لتقديم العرض السعودي، فرفضت سلطنة عُمان هذا العرض رفضًا مُطلقًا، وأعلنت أنها ستنسحب من المجلس إذا تحوَّلَ إلى “اتحاد”!
على أنَّ الرفضَ العُماني، لم يكن بغير تعليلٍ منطقي. فقد قال وزير خارجية سلطنة عُمان آنذاك، يوسف بن علوي: “إن المجلس فشل في بناء منظومة اقتصادية حقيقية، فكيف سينجح في الاتحاد؟”.
***
تبيَّنَ بالدليل القاطع، أنَّ الخليجيين ما كانوا في أيِّ يومٍ، قبل صدام حسين، وفي أيامه، ومن بعده، يرغبون في قبول العراق دولة خليجية. وكما ثبت، في شتّى مراحل “مجلس التعاون الخليجي”، أنهم لم يكونوا أيضًا راغبين في تطويره إلى قوةِ إقليميةٍ متَّحدةٍ، لئلّا تُسيطرُ عليه المملكة العربية السعودية، المؤهّلة لتحمُّل مثل هذه المسؤولية.
فعندما اقترحَ العراق، مشروعًا أمنيًا يتضمّنُ خطةً للدفاع عن الدول الخليجية المُعرَّضِ أمنها للاهتزاز، كجُزءٍ من تشكيل قوة ردع عربية، لم يترك الخليجيون حجّةً إلّاَ وطرحوها لرفض كلِّ ما يتعلق بالموضوع. منهم مَن أثار مسألة التفاوت الاقتصادي بين العراق والدول الخليجية، ومنهم مَن تذرَّعَ بتفاوت الأنظمة السياسية، ومنهم مَن شكَّك بنيّات النظام البعثي في بغداد، وآخرون بالخوف من نشوء صراع سعودي–عراقي على زعامة الخليج، وما إلى ذلك…
ظنَّ بعضُ العراقيين الذين جاؤوا إلى السلطة في بغداد، على محملٍ أميركي، بعد إطاحة صدام حسين ونظامه، أنَّ وجودَ العراق والخليج معًا تحت المظلة الأميركية، يُشكلُ ظرفًا مؤاتيًا للدخول في الفضاء الخليجي، فعادوا خائبين:
إبراهيم الجعفري، رئيس مجلس الحكم الانتقالي، في السنة الثانية من الاحتلال الأميركي (2004)، طالبَ بالانضمام الى “مجلس التعاون الخليجي”، فلم يردّ عليه أحد.
وزير النفط آنذاك، إبراهيم بحر العلوم، اجتهدَ في صياغةِ تعبيرٍ لطيف “لتطرية” الأجواء، سمَّاه “الوطن الخليجي الموحَّد”، فزاد في الطين بلَّة!
بعد أربع سنوات من تلك المحاولة البائسة، تحت الراية الأميركية، تقدّمَ وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، باقتراحٍ الى دول الخليج بضمِّ العراق الأميركي إلى مجلسهم، مُعلِّلًا ذلك بأنَّ دعمَ دول الخليج للعراق يُساعد على احتواء إيران، فلم يُعيروه بالًا. كانت الحجة أنهم لا يريدون التورُّطَ في أيِّ نزاعٍ بين العراق وإيران.
في العام 2019، شكَّلت الحكومة العراقية ما أسمته “لجنة الحوار الاستراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي”، بمُنطلقات تؤكّدُ أنَّ حكومة بغداد حينها تسعى إلى “الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي”، وأنَّ “العراق يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلى جانب مواقفه الرامية إلى خلق التوازن فيها”.
كما ناقشت اللجنة الإجراءات والأنشطة المُقتَرَحة المُتَّفَق عليها بين الجانبين، والمُثبَتة في خطة العمل المشترك (2019 – 2024)، التي تركزت على “المشاورات السياسية حول قضايا المنطقة، والتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرّف، ودراسة فُرَص ومعوّقات التبادل التجاري، بالإضافة إلى جُملةٍ من الأنشطة الأخرى”.
دخلت البلبلة في أذهان الخليجيين لأنَّ الدعوةَ العراقية تلك جاءت بعد يومٍ واحدٍ فقط من استضافةِ بغداد اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن، الذي أكد على “العُمقِ العربي للعراق”، مما ذكَّرهم بما قام به صدّام حسين، مع الملك حسين وحسني مبارك وعلي عبد الله صالح، بتشكيل “مجلس التعاون العربي”، الذي اعتبره الخليجيون موازيًا لمجلسهم، وأنه يضمُّ دولًا مُفلِسة طامعة بأموالهم!
والحقيقة، أنَّ “مجلس التعاون العربي”، كان فكرةً طرحها الملك الحسين بن طلال، على الرئيس العراقي، وتقضي بإنشاءِ ما سمَّاه “الفيلق العربي”، لكن صدام حسين اقترح اسم “مجلس التعاون العربي”، لكيلا يُفهَم بأنَّ للتجمُّع طابعًا وأهدافًا عسكريَّة.
على الرُغم من قُصرِ عمر هذا المجلس، فقد تمَّ عقدُ 17 اجتماعًا رسميًا على مستوى القمة، وعلى مستوى وزاري في سنة ١٩٨٩ وحدها…
مع ذلك كرًّرَ وزير الخارجية العراقي في العام 2021، فؤاد محمد حسين، طلب الحوار الاستراتيجي مع “مجلس التعاون الخليجي”، شارحًا أهدافه، وأوّلها ما كان الخليجيون ينفرون منه على الدوام، وهو “عقد اتفاقية استراتيجية متكاملة مع مجلس التعاون الخليجي”، (أسامة مهدي، موقع “إيلاف”، لندن، 17 أيلول/سبتمبر 2021).
في محصلةِ الأمر: إنَّ العراقَ غير مقبول في النادي الخليجي، تحت أيِّ رايةٍ جاءها، وإنَّ كلَّ عراقي، في نظر الخليجيين، مهما تغيَّرَ جلده، فيه شيءٌ من صدام حسين، من قبل ومن بعد!

