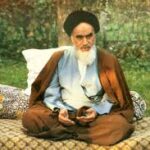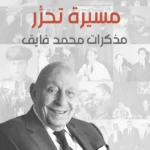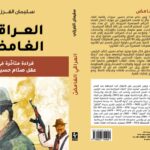
من نافذتي
آراء الكاتبة الجزائرية علجية عيش
(الأمير عبد القادر كان همزة وصل بين الجزائر والمشرق العربي)
(كارل ماركس شوّه الكثير من الحقائق التاريخية أثناء إقامته في الجزائر)
في شهادته يقول الإعلامي اللبناني سليمان الفرزلي إن الجزائريين ما كانوا في يوم من الأيام، قبل الاستعمار وبعده، بحاجة إلى هوية أو البحث عن هوية مفقودة. ومن يعتقد ذلك فهو يحمل في طيَّاته انحرافاً تاريخياً، لأنه يسعى إلى تشويه حقيقة الثورة الجزائرية. الملاحظ في ورقة هذا الإعلامي، أنه ربط صورة المشارقة للثورة الجزائرية بنظرة الفيلسوف كارل ماركس لها، بحيث تحفَّظ عن ذكر بعض الحقائق، ولم يذكر الرسائل التي كان يرسلها كارل ماركس من الجزائر، وموقفه السلبي من معاملة الاستعمار الفرنسي للجزائريين، وإدانته الشيخ بوعمامة.
معرفة المشارقة بالجزائر، وبآفاق دورها التاريخي سابقة كثيراً لبقية العرب الذين تعرفوا عليها من خلال ثورة الخمسينات من القرن الماضي، فقد عرفها المشارقة، وبخاصة سوريا ولبنان، من خلال الأمير عبد القادر الجزائري، الذي أقام في دمشق منفيَّاً، وكان له دور فعال في إطفاء الصراعات الدينية (الإسلام والمسيحية)، والطائفية (السُّنَّة والشّيعة)، والحرب الأهلية اللبنانية في منتصف القرن التاسع عشر. وها هو صَوْتٌ مشرقي أبى إلا أن يؤرخ لهوية الجزائر وعروبتها، ويقول إن عروبة الجزائر كانت سابقة للتعريب بأجيال. فقد سالت الكثير من الأقلام العربية المشرقية، بالخصوص، في الكتابة عن ثورة الجزائر بمنطلقاتها الأصلية، فكانت موقعاً حصينا مانعاً لوأد العروبة، ووضعها في الإطار التاريخي الثقافي الصحيح.
هذا الصوتُ القادمُ من بيروت، كان له صدى واسع على مستوى الإعلام العربي، وهو يؤرخ لأحداث الجزائر منذ الاحتلال الفرنسي لها، إلى غاية الاستقلال، وما حظيت به من دعم مادي ومعنوي، بلغ حد التقديس، في ورقة له تحت عنوان: ” جذرية العلاقة الجزائرية المشرقية”، ليس من داخل مصر فقط، كما روَّجت له بعض الأقلام، بل من داخل دول عربية أخرى، فعلى غرار العديد من الأصوات العربية، كان الكاتب والمحلل اللبناني “سليمان الفرزلي” واحداً من هذه الأقلام التي قدمت رؤية تحليلية للإشكالات الاستقرائية في الحالة الجزائرية. ما يميزه عن الآخرين هو أنه كان صوتاً عربياً، لكن بخصوصية افريقية، بالنظر الى أن الخصوصية الجزائرية اتسَّمت بالهيمنة الاستعمارية التي خضعت لها الجزائر طيلة 130 سنة، وجعلت منها حالة خاصة في المغرب العربي والمشرق العربي.
وبناءً على هذه المفارقات، جاءت قراءة الكاتب والمحلل اللبناني سليمان الفرزلي، كرد على بعض المثقفين السودانيين، وقولهم بأن الاستعمار أقام في البلاد منشآت وبنى تحتية: (سكك حديد)، ومؤسسات التعليم والصحة، وما إلى ذلك، واستمر وجوده في الجزائر طويلاً، أي أن الجزائر تحرَّرت عسكرياً فقط، في حين ظلت مخلفات الاستعمار في شتى المجالات، فعاشت الجزائر مرحلةً جدَّ قاسية ما بعد الاستعمار، وهي التي دفعت إلى ظهور العنف في بداية التسعينيات، حيث ظهرت توجهات عنيفة للحركات الإسلامية، كمطابقة قسرية بين العنف والفكرة الجهادية، من أجل نصرة قضايا الأمة، لاسيما ما تعلق بقضية التعريب، ووضع حد للصراع بين الفرنكوفونية والعروبة. فالملاحظ أن من أبرز ما تميزت به الثورة الجزائرية، تزامنها مع المدّ القومي العربي الناصري، ما جعلها تنتقل من إطار تاريخي إلى إطار تاريخي آخر مختلفٍ عن الأول، كما تزامنت مع ظهور الحركات الاشتراكية العربية التي ساهمت بشكل كبير في إبراز الواقع الجزائري، واعتبار أن الثورة الجزائرية، في جوهرها، هي مناهضة وجودية لفرنسا وللثقافة الفرنسية، أكثر مما هي مناهضة للفكر الاستعماري، كما يقول الفرزلي، وهي حقيقة غير قابلة للنقاش.
إن قضية التعريب في الجزائر، كما يراها الإعلامي سليمان الفرزلي، من أهم وأبقى إنجازات الثورة الجزائرية، كعنوان ثابت للهوية الثقافية والوطنية، وقد تعرضت تلك القضية هي الأخرى لمطابقات قسرية، بحيث جعلتها الحركات الإسلامية هوية عقائدية لغايات سياسية، من خلال مصادرتها تحت عنوان آخر. فعلى الرغم من الدور الذي لعبته مصر الناصرية في دعم الثورة الجزائرية، إلا أن المعرفة المصرية بالجزائر ظلت أدنى بكثير من معرفة اللبنانيين والسوريين بها في منتصف القرن الـ: 19، حتى أن المفكر والفيلسوف ” كارل ماركس”، الذي كان مقيما في الجزائر في ستينيات القرن التاسع عشر (19)، كان يتابع عبر الصحف الأمريكية “نيويورك تريبيون” أحوال بلاد الشام والصراعات الأهلية فيها من الأخبار التي كانت تنتقل إلى الجزائر عن طريق الأمير عبد القادر. فقد أمضى كارل ماركس أزيد من شهرين في مدينة الجزائر، واطلع على أوضاع سكانها، فكان ماركس يراسل صديقه فرمييه من الجزائر، ويزوده بكل الأخبار، ويصف له بشاعة الاستعمار الفرنسي ومعاملته للجزائريين، كذلك كان ماركس يراسل ابنته لاورا من الجزائر، منها رسالة مطولة كتبها بتاريخ 13 نيسان (أبريل) من عام 1882، دوَّن فيها معلومات خاطئة عن إعدام الشيخ بوعمامة، واصفاً لها الواقعة بشكل غير مباشر، مع أنه كان يدرك أن الشيخ بوعمامة لم يُعدم، وأن السلطات الاستعمارية منحته الأمان، بعد مفاوضات، لينتقل بعدها إلى المغرب، وظل فيه إلى أن وافته المنية في 1908، وهذا موقف سلبي منه كونه اقتصر فيه على معاتبة الفرنسيين دون أن يدين جرائمهم.
إشكالية السلم والحرب بين إيران والغرب (13)
“الوطن الشيعي”
قام الرحَّالة البرتغالي، أنطونيو تنريرو، بزيارةٍ الى مدينة أصفهان الإيرانية في العام 1524م، وهي السنة التي توفي فيها الشاه إسماعيل الأول الصفوي، الذي أمر بتشيُّع إيران، والانتقال بها من المذهب السُنّي (الشافعي والحنفي) الى المذهب الشيعي (الجعفري الإثنَي عشري). وفي تجواله هناك، لاحظ وجودَ بُقعٍ خارجها تتناثر فوقها عظامٌ بشريَّة، افترضَ أنها مقابرُ جماعية.
بصرف النظر عن هذه الملاحظة، كدليلٍ على وجود مقاومة شعبية لقرار الشاه إسماعيل الأول الصفوي بالانتقال من السُنِّيَة الى الشيعية، فإنَّ قراره هذا، لكونه قرارًا مُلزِمًا لعموم الشعب، تحت طائلة العقوبات القصوى، هو بحدِّ ذاته سببٌ لاستدراج الاستياء الشعبي العام. فإذا كانت ملاحظة الرحَّالة البرتغالي عن أصفهان صحيحة، فليس ذلك بالأمر المُستغرَب، لأنَّ الثابتَ أيضًا أنَّ مدينة تبريز قاومت التشيُّع، وقُتِلَ من التبريزيين ما لا يقل عن عشرين ألفًا!
لكنَّ الأهم من كل ذلك، فَهْمُ الأسباب التي دفعت الشاه إسماعيل الى اتخاذ قرار التشيُّع وتطبيقه بقسوة وبلا هوادة. فالقرارُ لم يكن في الأساس قرارًا إيديولوجيًا، لكن “أدلجته” تاليًا، كانت ضرورية لتوحيد الأهداف العسكرية والسياسية والدينية. أما السبب المُوجِب الأصلي، فهو قيام الدولة العثمانية السُنيَّة القويَّة الى جوار إيران، وتاليًا ادعاء سلاطينها صفة “الخلفاء”، مما حمل الشاه إسماعيل على اتخاذ خطوةٍ جذرية تتميّزُ بها إيران عن جارتها تركيا، التي وضعت يدها على جميع الدول العربية، مشرقًا ومغربًا، من العراق وسوريا، الى مصر والجزائر، مُتجاوزةً بذلك حدود الدولة الإخمينية الفارسية القديمة التي قادها الملك قورُش. بمعنى أنَّ السلطنة العثمانية المُتاخِمة لإيران، وضعت يدها ليس على العرب فقط، بل على الإسلام أيضًا!
*****
قرار الشاه إسماعيل، وهو أول حاكم لإيران من العائلة الصفوية (حكم من 1501م الى 1524م)، بتحويلِ إيران من المذهب السُنِّي الى المذهب الشيعي، كان قرارًا سياسيًا، فما كان دافعه الاعتبارات الدينية أو الإيديولوجية. إذ إنَّ معظمَ التحوُّلات الإيديولوجية، التي جرت في الدولة الصفوية، تمت في عهد ابنه تَحْمَسْب الأول، الذي حكم طويلًا لمدة تزيد على خمسين عامًا (من 1524م الى 1576م)، وهي مدة كافية لتثبيت الدولة تحت المذهب الشيعي، سياسيًا، وعسكريًا، والأهم من ذلك، دينيًا. وفي ذلك تقول مدوَّنة لجامعة كامبريدج البريطانية: “إنَّ الشيعيّة الفارسية الحديثة، نشأت وضربت جذورها في تربة حكم تَحْمَسْب الأول ابن الشاه إسماعيل”.
كانَ حُكمُ الشاه إسماعيل حكمًا توتاليتاريًا شديد القسوة، لأنَّ عملية الانتقال لم تكن سهلة، لكون التآلف السنّي–الشيعي في إيران كانت له جذورٌ عميقةٌ، في مواجهة الغزو المغولي الذي اجتاح بلاد فارس في العام 1258م، بقيادة هولاكو خان. ويقول المؤرِّخون للحقبة المغولية، إنه خلال تلك الحقبة، “توحَّدت الصفوف، واختفت الفوارق بين السُنَّة والشيعة”.
على أنَّ الكتبَ والدراسات التي أرَّخت لتلك الحقبة في الشرق كانت شحيحة، وأبرزها كتاب علاء الدين عطا – مالك الجفياني (1226م–1283م) بعنوان “تاريخ جاهان غوشاه”، وكتاب رشيد الدين فضل الله الهمذاني (1247م–1318م)، بعنوان “جامع التواريخ”، وقد كتبه باللغة الفارسية. وهذا الكتاب اهتم بجمعه وتحليله بعض المستشرقين البريطانيين والفرنسيين، وأبرزهم الباحث الفرنسي إتيان كاترمير (1782–1857)، الذي نشر، لأول مرة، ما كتبه رشيد الدين عن تاريخ المغول. وقد اشتغل كاترمير، على كتاب أبو العباس تقي الدين المقريزي (1364–1442)، بعنوان “التاريخ العربي لسلاطين المماليك”، وقام المستشرق الفرنسي بترجمة أجزاء منه بين 1837 و1841، (في جُزءَين). وفي العام 1839، صحب أستاذ اللغات البريطاني البروفسور دانكن فوربس معه الى اسكتلندا ممثل “مهراجا ستارا” في الهند الى مقر الكولونيل الراحل جون بايلي في إنفرنيس، الذي كان يُشغل منصب المقيم العسكري البريطاني لدى “شركة الهند الشرقية” (بين 1807 و1815)، وذلك لتفحُّص المستندات والوثائق الموجودة في أرشيف الكولونيل بايلي خلال إقامته في الهند. وقد عثرا على مستندٍ مُهمٍّ لرشيد الدين، جزم الصاحب الهندي بأنه جُزءٌ من كتاب “جامع التواريخ” المُوَزَّعة نتفه الأصلية بين لندن، وباريس، وإسطنبول، وسانت بطرسبورغ.
يقول البروفسور الأميركي، استيفان كامولا، مؤلف كتاب “صُنْعُ التاريخ المغولي: رشيد الدين وجامع التواريخ”: “إن فترة الغزو المغولي، كانت فترة فريدة من حيث المخاض الاجتماعي، والسياسي، والفكري، في الشرق الأوسط. وفي غمار الدمار الهائل الذي رافق الغزوات الأولى، نشأت أفكارٌ جديدةٌ حول الدين والدولة. وقد ساعد رشيد الدين على تطوير تلك الأفكار الجديدة المتعلقة بالدين، كما ساعد عمله على تكوين الدول التي نشأت في ما بعد في جنوب غرب آسيا”.
الملاحظ أنه لم تظهر في البلدان العربية والإسلامية، بوادرُ اهتمامٍ جدِّي بتاريخ الحقبة المغولية في العمق، والسائد منها للعموم أخبار الدمار الذي ألحقته غزوة هولاكو بالعاصمة العباسية بغداد، كما إنه لا يجري تدريسه في المدارس والجامعات إلّاَ للراغبين في التخصص، وهم قلَّةٌ لا تُذكر. واللافت الآن في الغرب، أنَّ سَيلًا من الكتب حول الموضوع نُشر في السنوات الأخيرة، نذكر منها، على سبيل المثال، آخر ثلاثة أعمال جديَّة صدرت في بريطانيا: كتابان صدرا للمؤلف بيتر جاكسون، الأول بعنوان “المغول والعالم الإسلامي” (2017)، والثاني بعنوان “إيران بعد المغول” (2019). وكتاب نيكولاس مورتون بعنوان “العاصفة المغولية” (2022)، وكتابان للمؤلف تيموثي ماي، الأول بعنوان “فن الحرب لدى المغول” (2007)، والثاني بعنوان “الغزوات المغولية في التاريخ العالمي” (2012).
*****
إنَّ خطوة الشاه إسماعيل الأول، في التحوُّل من السُنّية الى الشيعية، ما كان لها أنْ تَتَجذَّرَ، رُغمَ فرضها بالقوة، لو بقيت مجرَّد خطوة سياسية ظرفية، فكان لا بدَّ من إرساءِ أساسٍ لمؤسسة دينية شيعية، يساهم فيها العلماء الشيعة المُهَمشون في البلاد العربية والإسلامية. واللافت أنَّ موضوعَ الديموغرافيا الشيعية خارج إيران، من أفغانستان وباكستان وأذربيجان، الى الخليج، مرورًا بالعراق وسوريا ولبنان، يحظى باهتمامٍ استثنائي في الدوائر الغربية حيث تُصدر “وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية”، بصورة دوريَّة، تقريرًا مُفَصَّلًا عن الموضوع، بعنوان “كتاب الحقائق”، وآخر طبعة منه قبل ثلاث سنوات تُفيدُ بأنَّ نسبةَ عدد الشيعة في لبنان باتت نحو 31 في المئة من السكان.
في بداية التحوُّل، وربما بسبب المقاومة للتشيُّع، اتخذ الصراعُ شكل “الردح”، بفرض “اللعنة” على الخلفاء الراشدين، أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفَّان، قبل أن يجري ترشيد التحوُّل من خلال تشكيل جسم من العلماء المُستنيرين، ومنهم علماء من جبل عامل في لبنان، ومن أوائلهم الشيخ كمال الدين العاملي، الذي أقام في أصفهان، لقرابة في النسب له مع العلامة الشيخ الإيراني محمد باقر مجلسي، الملقب باسم “النطنزي”، (نسبة الى نطنز بالقرب من أصفهان، حيث اليوم المنشأة النووية التي قصفها الأميركيون في الحرب الأخيرة)، أو “الأصفهاني”.
لكن لم يرد ذكرٌ لعلماء جبل عامل في عهد إسماعيل الأول. العاملي الوحيد الذي رافق الشاه إسماعيل هو الطبيب السيد علي الحكيم (الذي نودي بلقب “الحكيم” لكونه طبيبًا، حيث كان الناس في لبنان، وحتى اليوم، يُطلقون على كل طبيب لقب “الحكيم”). وكان الشاه يثق بطبيبه علي الحكيم، ويستشيره أحيانًا في الأمور السياسية، لأنه لم يُعرَف عنه أنه مُتَدَيِّن. فالشيء الوحيد الذي ذُكر عنه وله علاقةٌ بأمرٍ دينيٍّ، هو مرافقته للشاه إسماعيل الى النجف الأشرف، حيث شارك في وضع أول تصميم هندسي لمرقد الإمام علي بن أبي طالب هناك. وقد استأذن علي الحكيم من الشاه أن يبقى في النجف، فأذن له بذلك، وكان أن استوطن هناك، فتأسَّست عائلة “الحكيم” وتجذَّرت في العراق إلى اليوم.
*****
السؤال الذي يُطرَحُ أحيانًا، هل كان الشاه إسماعيل نفسه سُنِّيَّاً وتشيَّع؟
المتداول بين الباحثين، أنَّ الشيخ حيدر، والد الشاه إسماعيل، كان شيعيًّا يدَّعي الانتساب الى سلالة الإمام علي بن أبي طالب. لكن في عهد حكم الشاه تَحْمَسْب الأول، ابن الشاه إسماعيل الأول، تمَّ وَضعُ نَسَبٍ مُفصَّل للعائلة (ما يُشبه وثيقة نسب صدام حسين التي استصدرتها ابنته رغد من “نقابة الأشراف” بعد سقوط نظامه في الغزو الأميركي وإعدامه، وهي منشورة حرفيًا، كما وردت في وثيقة رسمية من نقابة الأشراف” في لندن، في كتابي بعنوان “العراقي الغامض”، الذي سوف يصدر قريبًا في بيروت عن “دار النهار”).
لكنَّ الشكلَ المؤسّسي، للنظام الديني الشيعي في إيران، لم يبدأ بصورةٍ هيكلية فاعلة، وقادرة على الانتشار إلّاَ بعد أكثر من قرن على وفاة الشاه إسماعيل، على يد العلامة محمد باقر مجلسي، ومعه كمال الدين العاملي، حيث بدأ كبار علماء الشيعة من الإيرانيين، وشيعة البلدان الواقعة تحت السيطرة العثمانية، أو اللاجئين من طالبي الأمان في إيران بسببٍ من الاضطهاد العثماني، وخصوصًا من علماء جبل عامل في لبنان، ينشرون التعاليم والتقاليد الشيعية المُتوارَثة خارج إيران. فكان كلُّ علَّامة منهم يقوم بتدريس الفقه الشيعي لعدد من طلاَّب العلم، بحيث تكوَّنَ في السنة الأولى من هذه العملية جسمٌ من رجال الدين العلماء يبلغ نحو 180 علّامة، على يد 21 أستاذًا، ليصبحوا بدورهم أساتذة لتعليم أجيال جديدة، فراح هذا الجسم الديني يتسع سنة بعد سنة. ومن خلال هذه العملية، الهادفة الى نشر العلم (الديني الشيعي) على أوسع نطاق، تكوَّنت فكرة إيران كملاذٍ آمنٍ للشيعة في كلِّ مكان، أو بلغة اليوم “بيئة حاضنة”، أطلق عليها بعضهم اسم “الوطن الشيعي”.
كان العلّامة محمد باقر مجلسي، حسب بعض المصادر، يوقِّع “الإجازات” العلمية لطلّاَبه، بنقل المعرفة، باسم “الأصفهاني، النطنزي، العاملي”.
*****
لكنَّ التشيُّع الإيراني، مرَّ بمراحل صعبة، في عهوده الأولى. خصوصًا بعد وفاة الشاه تَحْمَسْب الأول وصعود ابنه إسماعيل الثاني إلى العرش، الذي حكم لسنة واحدة فقط (1576–1577)، ارتد خلالها عن التشيُّع، لأنَّه كان مُتلازِمًا مع الصوفيَّة السُنيَّة، وقد مات مسمومًا. وهو الشاه الثالث من العائلة الصفوية، لكنه لم يكن على وفاق مع والده الذي أمر بسجنه، فقضى محبوسًا نحو ربع قرن، كان في مرحلة منها مُقيَّدًا بالسلاسل!
لم يكن الجسم العلمائي الشيعي، المتكوِّن حديثًا في ذلك الوقت، ليتحمّل مثل تلك الهزّة الارتدادية التي أطلقها الشاه إسماعيل الثاني، ولذلك أخذت المؤسسة الدينية الشيعية تتجه الى التطرُّف في المحافظة، ما انعكس على عملية انتشار التعليم المشار إليها، في اتجاهين: الطلاق التام بين الشيعية والصوفيَّة، وخنق الفلسفة في التعليم الديني الشيعي.
إنَّ هذَين الاتجاهَين، كان لهما تأثيرٌ سلبيٌّ بالغ الأهمية على التطوُّر المُجتمعي في إيران خلال القرون التالية، من حيث انتشار الأفكار الخرافية، ومعها ممارسات وعادات لم تكن مألوفة من قبل. وكانت تلك الممارسات تلقى تشجيعًا من المؤسسة الدينية، إن لم تكن هي التي أطلقتها، بهدف رصِّ الصفوف، والحشد، بما يُشبه العسكرة، مع تزايُد المخاوف جرَّاء تعاظم القوة العثمانية، واتساع مدى رقعتها وفتوحاتها، في كل الاتجاهات. وهذا الوضع يشبه الى حدٍّ ما الحالة الراهنة في الجمهورية الإسلامية، التي انعكست أيضًا على المجتمعات الشيعية في بعض الدول العربية، وبشكلٍ خاص في لبنان، حيث اتخذ هذا التحوُّل لنفسه صفة “البيئة الحاضنة”، التي تُشكّلُ المظهر الأوضح لفكرة “الوطن الشيعي”، التي ظهرت في إيران، خلال المرحلة الصفويَّة، ولو بمفهومٍ غير واضحٍ، كما هو اليوم، في إطار جدليَّة “الاستقواء والتقوية”. ما يعني استقواء الدولة الشيعية الأم بالبيئات الشيعية الخارجية، المُتَحَوِّلة الى كتل مجتمعية مُتراصَّة، وإمدادها بوسائل القوة من الدولة القائدة.
يمكن تصريف الفارق بين الحالتين، التشيُّع الأول (في عهد الدولة الصفوية)، والتشيُّع الثاني (في عهد الثورة الخمينية والجمهورية الإسلامية)، بأنَّ الحالة الأولى قامت على نشر العلم، كما تقدم، وتقوم الحالة الراهنة الثانية على نشر القوة بالدرجة الأولى، خصوصًا في لبنان، بسبب العامل الجغرافي لكون الكتلة الشيعية الأكبر هناك، على تماسٍّ مباشرٍ مع الدولة الصهيونية المسلحة الى أسنانها في فلسطين المحتلة، والتي قامت بالقوة العسكرية، والدعم الخارجي، وما زالت تخوض الحروب في كلِّ الاتجاهات منذ تأسيسها قبل ثمانين سنة.
لذا، فإنَّ وَضعِيَّةَ الحشد والتعبئة، ومظاهر التنظيم العسكري، وشبه العسكري في المجتمع المدني، هي العمود الفقري للبيئة الحاضنة، التي هي صورة مصَّغرة عن مفهوم “الوطن الشيعي”، بحيث يبدو الجسم الشيعي مُنفصلًا عن المجتمع الأوسع، في الثقافة، وفي العادات، وفي العلاقات الاجتماعية، التي تجعل من كلٍّ منهما على أنه “الآخر” بالنسبة إليه. وهذه الوضعية قائمة في الدولة الأم، ولو أنها صامتة، وتنفجر بين حينٍ وآخر، لكونها عماد “الوطن الشيعي”، ولكونها في حالةِ حشدٍ دائم، يهدف الى رصِّ الصفوف، بسببٍ من الأخطار الخارجية أيضًا. فالمجتمعات الشيعية، خارج إيران، لم تَعُد تختلفُ كثيرًا عن إيران في سماتها العامة، الثقافية، وفي عاداتها، وعلاقاتها الاجتماعية، التي أصبحت تقاليد مميَّزة، ومُميِّزة!
*****
مما لا شك فيه، أنَّ قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بقيادة الإمام روح الله الخميني، شكلت افتراقًا حاسمًا ليس فقط عن إيران الملكية السابقة، إنما أيضًا عن الشيعية الصفوية، التي بقيت مُعرَّضة للانتكاس، وقد انتكست فعليًا في عهد العائلة البهلوية، (الشاه رضا محمد بهلوي، وابنه الشاه محمد رضا بهلوي)، عندما مالت إلى العلمانية وإلى الغرب، والأهم من ذلك إلى تركيا الكمالية وريثة السلطنة العثمانية.
فالملاحظ خلال العقود الأخيرة، بعد قيام الجمهورية الإسلامية، (في العام 1979)، اتساع مبادئ السلوك والممارسة الاجتماعية الخاصَّة في المجتمعات الشيعية المُتأطِّرة تعبويًّا في إطار “الوطن الشيعي”. فلم يسبق للمجتمعات الشيعية في القرون الماضية، أن مارست طقوسَ “الأحزان الجماعية”، كمظاهرةٍ سياسية من أجل الحشد ورَصِّ الصفوف، كما جرى في العقود الأخيرة.
كذلك ليس في الماضي السحيق، ما يدلُّ على أنَّ مثلَ هذه الحالة الجماعية، للمجتمع بأكمله، قامت من قبل في المجتمعات الشيعية. حتى مسألة استشهاد الإمام الحسين بن علي في موقعة كربلاء، لم يكن يجري تظهيرها في السابق على النحو التعبوي الراهن. بل هي، حتى في كتب التاريخ، لم تأخذ الطابع الاستثنائي، الذي يسود اليوم من خلال “مظاهرة الأحزان” السنوية بمناسبة عاشوراء، برفع الرمز الى مستوى الأسطورة.
ذلك أنَّ بعضَ المؤرخين تناولها من زاويةٍ سياسية بحت، في إطار “الصراع على السلطة”، وليس في إطار جدلية “الشرعية واللاشرعية”، التي انطلقت تاليًا، وربما لاعتباراتٍ سياسية أيضًا. فالمستشرق الألماني يوليوس فيلهاوزن، في كتابه “تاريخ الدولة العربية”، ينظر الى الأمر من زاوية “الدولة القائمة” التي، من الطبيعي، أن تقومَ بقمعِ أيِّ تمرُّدٍ ضدها، بصرف النظر، عن أيِّ ذريعة أو دعوى، أو عن أيِّ حقٍّ أو باطل.
على أنَّ المُمَيّزات المجتمعية في “الوطن الشيعي”، أخذت مع التوسُّعِ الإيديولوجي، واتساع دائرة الأخطار المُحدِقة، تتوسَّعُ هي الأخرى لتشمل العادات، وطرق اللباس، وكيفية التصرُّف في كلِّ شؤون الحياة للأفراد وللمجتمع أيضًا. فمظاهر الطلاق بين الشيعية والصوفية، التي انطلقت في إيران الصفوية، تتمظهر الآن في الدول والمجتمعات المشتركة، حيث تبرز بين حين وآخر بوادر طلاق بين الجسم الشيعي، والمكونات الأخرى الشريكة في الدولة الواحدة، مثل لبنان، والعراق، وغيرهما.
في معظم الحالات، العربية والإسلامية (مثل باكستان)، كلما ظهرت ملامح الطلاق بين الشيعية والمكونات المجتمعية الأخرى في الدولة الواحدة، تحوَّلَ مفهومُ “الوطن الشيعي” إلى حالةٍ من التباعُد، بحيث يأخذُ ذلك المفهومُ، أو يُعطى، شكل الانتماء الدائم للشيعة في كلِّ مكان الى المركز الإيراني، لكونه أساس هذا التحوُّل، ثقافيًا، وعقائديًا، وسياسيًا، واقتصاديًا، وعسكريًا.
*****
في ورقةٍ تَقَدَّمَ بها يوم 8 شباط (فبراير) 2023، البروفسور الصيني ليو شونغ مين، في معهد دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، قال فيها: “إنَّ إيران تتمتَّعُ بوضعٍ فريدٍ من نوعه لكونها تُمثّلُ حالةً ديبلوماسية مختلطة، من حيث إنها دولة رئيسية قائمة في الشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته، هي لاعب بأدوات من خارج الدولة (أو اللادولة)، من خلال التنظيمات الشيعية الخارجية”.
وقال البروفسور ليو: ” في النظرية الطائفية، كجُزءٍ من نظرية تصدير الثورة، يجري التركيز على العناصر الإيديولوجية، وسياسات الهويَّة، مع تجاهل وجود مصالح وطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على استراتيجية عقلانية”.
تناول الباحث الصيني أيضًا مسألة الرعاية الإيرانية لوكلائها في الخارج، من أجل الفَهمِ الصحيح لتعقيدات الديبلوماسية الإيرانية، مُفضِّلًا استخدام “نظرية العلاقة بين الراعي والوكيل”، كإطارٍ سليمٍ للبحث، بجعل الوكلاء الموضوعَ الأساسيَّ للتحليل المقارن لعلاقات إيران مع كل منظمة من المنظمات الشيعية السياسية في الشرق الأوسط.
في هذا الإطار المقارن وضع الباحث الصيني “حزب الله” اللبناني في مرتبةٍ أعلى في علاقته بإيران، من حيث إنه ليس مجرَّدَ وكيل للراعي الإيراني، بل وصفه بأنه “شريكٌ استراتيجي” له. واللافت في هذا التحليل، أنه ركّزَ على الوضع اللبناني بأنه عنصرٌ رئيسيٌّ في تمكين “حزب الله” من بلوغ “مرتبة الشراكة الاستراتيجية”. ربما قصد بذلك أنَّ الوضعَ اللبناني المتشرذم، يمثل “حالة اللادولة”، وهذه نقطة مهمة جديرة بمزيدٍ من البحث والتدقيق، لتقرير ما إذا كانت “حالة اللادولة” في لبنان هي الحالة القائمة قبل “حزب الله”، ما سمح له بأن يبلغ مرتبة رفيعة في الاستراتيجية الإيرانية، أم أنَّ توسُّعَه وتمدُّدَه، بفعل الصراع مع إسرائيل، هو الذي دفع الوضع اللبناني إلى “حالة اللادولة”، كما يدَّعي خصومه في هذه الأيام، للتأكيد بأنَّ وجوده المسلّح هو العامل المانع لقيام الدولة في لبنان!
*****
يُشيرُ التحليلُ الصيني المذكور، إلى أنَّ العلاقة المُمَيَّزة بين إيران و”حزب الله” في لبنان، تشكّلُ معيارًا لقياس علاقة الجمهورية الإسلامية مع وكلائها، لأنها قائمة على “التوافق الإيديولوجي”، الأصلب عودًا من أيِّ معيارٍ آخر، لتحديد مواصفات الشركاء المحتملين. وقد أثبت هذا المعيار جدارته وجدواه في أكثر من ميدانٍ إقليمي في وقتٍ واحد، بالنسبة إلى الأهداف الإيرانية، بحيث “أصبح حزب الله بمنزلة دولة”، خصوصًا من خلال دوره في سوريا أيام حكم بشار الأسد.
هناك في هذا التحليل أسبابٌ عدة لصعود “حزب الله” في لبنان إلى “مرتبةٍ عُليا ومُتقدِّمة” على غيرها، جعلته في موقع الشريك، “المسموح له أن يلعبَ ضمن هامشٍ أوسع من الاستقلال الذاتي”، منها: التماسك الإيديولوجي، وضعف سلطة الدولة اللبنانية، والتباعد الطائفي بين المكوّنات اللبنانية، والعدوانية الإسرائيلية المُزمِنة.
يخلص البروفسور الصيني ليو في مطالعته إلى القول: “في الجوهر، أتاح دعم إيران ل”حزب الله”، ضمان وجود تنظيم قوي، مُوالٍ وموثوق، له نفوذٌ طاغٍ في بلدٍ حسَّاس مثل لبنان. ومن الناحية الرمزية، فإنَّ نموَّ “حزب الله”، يمثِّل الإنجاز الإيراني الأكبر لفكرة تصدير الثورة. كما إنَّ تعاظُمَ نفوذ الحزب في لبنان، عزَّزَ بدوره، سمعة إيران في الإقليم، وفوق ذلك، أمدَّ المُنَظِّرين المُتَطَرِّفين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأسباب النجاح الدائم ضد معارضيهم المعروفين باسم الإصلاحيين”!
على أنَّ هذه المقاربة الصينية، على وجاهتها، تبقى غير وافية بعد سقوط النظام السوري السابق، وتحوُّلَ دور سوريا المفصلي من محورٍ إلى محورٍ مُضاد. ذلك أنَّ هذا التحوُّلَ حشر أطرافَ المحور الإيراني جميعًا، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في “عنق الزجاجة”، فضاقت به المخارج أو انعدمت للمدى المنظور.
الحرب الإسرائيلية أدخلت “حزب الله” في عنق الزجاجة، فأدخل معه “شبه الدولة اللبنانية” على النطاق المحلي، وسقوط النظام السوري، حشر المحور الإيراني فأدخله في عنق الزجاجة على النطاق الإقليمي، والضربات الأميركية للمشروع النووي الإيراني، أدخلت إيران في عنق الزجاجة على النطاق الدولي.
هذا الضيق في المخارج، ينعكسُ الآن سلبًا على الأطراف المضادة أيضًا، لأنه في الوقت ذاته ضيَّق الوقت على إسرائيل والغرب، وضيَّع الوقت على الدولة اللبنانية في عهدها الجديد.
إشكالية السلم والحرب بين إيران والغرب (12)
تَسَلُّمٌ وتسليم بين العرب والروم!
قبل سنتين من الثورة الفرنسية في العام 1789، أكمل إدوارد غيبون كتابه المشهور بعنوان “تاريخ انحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية”، وهو كتابٌ لم يصدر له مثيلٌ الى اليوم، بعد مرور نحو 250 عامًا. وليست فرادةُ هذا الكتاب في حجمه (سبعة مجلدات، بحوالي 5000 صفحة)، بل في أسلوبِ كتابته، وفي دقّة معلوماته، وسِعة مصادره. فقد بدأ الإعداد للكتاب في العام 1770، وصدر الجُزءُ الأول منه في العام 1776، والجُزء الأخير في العام 1787.
لكلٍّ من الكاتبِ والكتابِ قصَّةٌ، دَوَّنها غيبون في مذكراته التي كتب منها ست “بروفات”، وحرص أن يذكُرَ على غلاف كتاب تلك المذكرات أنه كتبها بنفسه. وقبل أن ينتقلَ من بريطانيا الى مدينة لوزان السويسرية، حيث أقام ووضع مؤلفه الكلاسيكي المشهور، قضى ثماني سنوات نائبًا في “مجلس العموم البريطاني” (البرلمان)، لكنه طيلة تلك السنوات كان النائب الوحيد الذي لزم الصمت، فلم يُلقِ أي كلمة، أو مُداخلة، أو يدخل في أيِّ مناقشة، فكأنه لم يكن صاحب مقعد في أعلى سلطة تمثيلية. بعضهم اتهمه بالاستعلاء، لأنه أرفع من زملائه في الثقافة، ومنهم من قال إنه كان يعاني من حالة جسدية، خشي أن يهزأ به النواب السطحيون، ويجعلوه مضغةً في أفواه السوء.
هكذا ترك العمل السياسي الصامت في بلاد الإنكليز، وانتقل للعيش في سويسرا، حيث عكف على الكتابة، وعلى بناء مكتبته الخاصة، التي بيعت بعد وفاته بمليون جنيه إسترليني بعملة ذلك الزمان. وقيل إنَّ الشخص الذي اشتراها، ظنَّ أنَّ تلك المكتبة هي التي صنعت من غيبون كاتبًا ذائع الصيت، فحاول أن يقلده، ليكتشف، بثمن باهظ، أنَّ الكتابة ليست في المكتبة، بل في العقل الذي يصنع المكتبة!
وَضَعَ غيبون المجلّد الأول من كتابه باللغة الفرنسية، وأرسل نسخًا منه الى شخصيات فكرية مرموقة في أوروبا بغية استمزاج رأيهم فيه، وإبداء ملاحظات أو تصحيحات موثَّقة عليه، وكان من بين هؤلاء المفكر الأسكتلندي المعروف، السير دايفيد هيوم، وهو صاحب مؤلفات فلسفية رفيعة المستوى، بمضمونها، وأسلوب كتابتها، منها “بحث في الطبيعة البشرية “، و”استفسارات حول الفهم البشري” و”حوارات حول الديانة الطبيعية”، و “حول مبادىْ الأخلاق”. وقد وصلته تعليقات من بعضهم، لكن رسالة هيوم استوقفته وعمل بموجبها. في تلك الرسالة نصحه هيوم بأن يضع كتابه باللغة الإنكليزية، “لأن الولايات المتحدة الأميركية الوليدة، سوف يكون لها شأن عالمي كبير في المستقبل، هذا إذا كنت ترغب لكتابك أن ينتشر على أوسع نطاق، ويفعل فعله المرتجى من هذا الجهد الجبار”. طوى غيبون مخطوطه الفرنسي، وبدأ من جديد يكتب بالإنكليزية!
أكتب هذه المقدمة، للإضاءة على موضوعٍ حسَّاس يتعلق بالمؤرّخين العرب، من أجل أن تكون الحقيقة التاريخية، فوق أي اعتبار آخر. ذلك أنَّ إدوارد غيبون، وهو يُحضِّر المراجع اللازمة لكتابه عن الإمبراطورية الرومانية، كان عازمًا على درس اللغة العربية، ليقرأ كتابات المؤرخين العرب بلغتهم. لكن قبل أن يفعل ذلك، أراد أن يأخذَ فكرةً عن المواضيع التي كتبوا فيها، كما هي مترجمة، في زمانها إلى اليونانية واللاتينية، وكان يُتقنهما الى جانب الفرنسية والإنكليزية.
خاب ظنُّ غيبون، فصرف النظر عن إضاعة وقته في درس اللغة العربية، لأنه اكتشف أن غالبيتهم العظمى لم تكتب التاريخ كتابة نقديَّة أو موضوعية، معظمها كتابات من وجهة نظر الحكام والسلاطين، مُستثنيًا اثنين أو ثلاثة، هم: إبن الأثير (1160م–1233م)، وأشهر مؤلفاته “الكامل في التاريخ” –12 جزءًا- وأبو الفدا (“صاحب حماة” 1273م–1331م)، في كتابيه: “المختصر في أخبار البشر”، و”تقويم البلدان”، الذي قال فيه المستشرق الروسي إغناطيوس تراتشكوفسكي: “إنَّ كتابَين عربيَين فقط أثارا اهتمام الغربيين أكثر من كتاب “تقويم البلدان” لأبي الفداء هما: “القرآن الكريم”، وكتاب “ألف ليلة وليلة”!”، وشمس الدين المقدَّسي (945م–1000م)، في كتابه “أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم” وفيه انتقد كُتُب السابقين، واعتمد على ثلاثِ ركائز: على الملاحظة والمعاينة الميدانية، وعلى ما سمعه من الثقات، وبرجوعه الى أمهات الكتب المرجعية المصنَّفة.
هذا يعني، باختصار، أنَّ الكتب التاريخية العربية التي صدرت بعد الإسلام، لا يُركَنُ إليها لغرض التحليل التاريخي الصحيح لحوادث جرت قبل مئات السنين، للاعتبارات التي جعلت إدوارد غيبون يصرف النظر عن درس اللغة العربية لأغراض البحث التاريخي، ويعتمد على المراجع اليونانية واللاتينية، وعلى تحليله الخاص للمواد التي جمعها من المصادر الموثوقة، ومن الوثائق الرسميَّة المدوَّنة.
*****
من غير المألوف في كتابة التاريخ، أن تبدأ باليقين الافتراضي، بل الأدق أن تبدأ بطرح الأسئلة، واستكشاف الأجوبة عنها، من طريق المُقارنة بين المراجع المُصنَّفة، ودرس الظروف الموضوعية التي نشأت فيها الحوادث المكتوب عنها. وإلاَّ كيف تبوَّأ إدوارد غيبون على عرش الكتابة التاريخية منذ أكثر من 250 سنة حتى الآن؟
أولُ سؤال يتبادر الى الذهن، يتعلق بما سمِّيَ “الفتح الإسلامي” لبلاد الشام. فالشواهد التي استعرضها غيبون، تُفيدُ بأنَّ الدخول العربي الإسلامي إلى بلاد الشام، تمَّ بالتفاهم المبدئي بين الإمبراطور البيزنطي هرقل، عند دخوله إلى مدينة القدس، بعد الهزيمة التي أنزلها بالجيش الفارسي بقيادة كسرى الثاني (أبرويز) في العام 628م، وبين زعيم قريش، صخر بن حرب الأموي، المعروف بلقبه “أبو سفيان”.
فالمراجع الغربية الأساسية تُجمع على أنَّ لقاءً في القدس تمَّ بين هرقل و”أبي سفيان”، الذي حمل معه هديَّةً رمزية إلى الإمبراطور البيزنطي المنتصر على الفرس. فاللقاء بينهما قد تم، بصرف النظر عمّا إذا كانت تلك المبادرة جاءت بدعوةٍ من هرقل، أو بزيارة تهنئة تقليدية من زعيم عربي الى قائد غربي منتصر، كما شاهدنا في هذه الأيام، بالصوت والصورة، التهافت العربي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة شرم الشيخ!
قبل طرح الأسئلة حول حقيقة ما جرى بين الإمبراطور البيزنطي، وبين الزعيم العربي القرشي، لا بدَّ من استعراض الأوضاع العامة في الدولة البيزنطية آنذاك، وأوضاع الجزيرة العربية في ذلك الوقت، من منظور هرقل، المعني الأول بالشأن السوري والمصري، حيث رأى أنَّ الدولة البيزنطية، بشق النفس، وبالكاد، استطاعت أن تُقيمَ جيشًا مُقاتلًا للدفاع عن سوريا، وهو أمرٌ سوف يكون شبه مستحيل من بعده، ما يعني أنَّ تلك الدولة سوف تخسر سوريا وما بعدها إلى الأبد. ورأى أنَّ القوة الوحيدة المائلة إلى البيزنطيين هي الجزيرة العربية الفتية، التي تتمخَّضُ فيها خلال أيامه تلك، ولادة قوة دفع عقائدية تعوّض عن النقص العسكري (وهذه نقطة صحيحة لأنها مؤكدة في القرآن الكريم في “سورة الروم”، كما مرَّ في حلقة سابقة)، لكنها في حينه كانت في حالة حرب أهلية بين المسلمين والمشركين من العرب، ولكي يتم التسلم والتسليم بين العرب والروم، لا بدَّ من أن يوحّد العرب صفوفهم، لكي يخرجوا من “الحالة البيزنطية” الاستنزافية، قبل الانتقال من التفاهم المبدئي الى التعاهد الرسمي.
*****
السؤال الأول الذي يطرح نفسه، هو كيف أنَّ أكبرَ خصمٍ للرسول العربي ورسالته في جزيرة العرب، عاد الى مكة من القدس بنفس تصالحي مع خصمه، وكيف أنَّ الرسول عاد إلى مكة من مهجره فاتحًا ذراعيه له، بعد صراع ومعارك مريرة، وجعل بيته مساويًا في الحرمة لبيت الله الحرام، بقوله لخصومه: “من دخل بيت الله الحرام كان آمنًا، ومن دخل بيت أبي سفيان كان آمناً”. ما هو ذلك الشيء الذي قلب أوضاع الجزيرة العربية، والشرق، والعالم، رأسًا على عقب، وبصورة مفاجئة؟
إنَّ بيت أبي سفيان ذاك في مكة، هو نفسه بيت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، التي وصفها بعضهم في مكة بأنها “هند آكلة الكبود”، زاعمين أنها بقرت بطن حمزة عمَّ النبي بعد سقوطه في “معركة أحد”، ومضغت كبده تشفّيًا، وهي رواية غير مؤكدة، ولم ترد على ألسنة الثقات، فكيف نال بيتها تلك الحرمة من الرسول العربي؟
الجواب الاستنتاجي من مجريات الأمور في سوريا وقتئذٍ، بعد انهزام الفرس منها، أنَّ أبا سفيان حمل إلى النبي عرضًا من هرقل، يستحقُّ المصالحة، ويرفعُ شأن العرب، ويعطيهم مفتاح التاريخ العالمي في سوريا من غير قتال أو كلفة.
بعدما قام هرقل بتقويم نتائج الحرب مع كسرى، وتقويم أوضاع دولته المتهالكة، قرَّر أن يعقد معاهدة مع المسلمين في الجزيرة العربية، يتولون فيها السلطة في سوريا، والدفاع عنها لقاء حصة للقسطنطينية من خراجها. وقد نشر إدوارد غيبون في كتابه، نقلًا عن المدوّنات اليونانية، مضمون تلك المعاهدة، التي وافق عليها أعيان قريش في اجتماعٍ لهم في دمشق، قبل التسلم والتسليم، في العام 630م، بما يقلُّ عن سنتين من تاريخ وفاة الرسول العربي.
من ذلك يتضح، أنَّ وصول السلطة في سوريا إلى يد الأمويين، وتحديدًا إلى سلالة أبي سفيان، لم يكن عَرَضًا أو بالمصادفة. وإلّاَ كيف يمكن تفسير المدفوعات من خراج سوريا إلى البيزنطيين، وهي موثّقة في السجلّات اليونانية؟ وتؤكد المراجع التي استند إليها غيبون، أنَّ بنود تلك المعاهدة تعدَّلت مرة واحدة، فرفعت قيمتها، وطريقة احتسابها (مع عرض له لأوزان ومكاييل الأموال والغلال المنقولة من دمشق الأموية إلى القسطنطينية، واحتسابها بقيمة العملات تلك في أواخر القرن الثامن عشر). فقد قضى التعديل إلى حسبة كميات الغلال، والمبالغ النقدية، والخيول وغيرها، بالمعدل اليومي على مدار السنة الشمسية (365 يومًا)، كما يلي: (عبدٌ واحد، وحصانٌ واحد، وألف قطعة نقد ذهبية عن كل يوم، بينما كانت قبل ذلك بمقادير مقطوعة سنويًا). فإذا كانت سوريا قد أخذها العرب بالفتح عنوةً، فكيف يمكن تفسير هذه المدفوعات من المُنتَصِر الى المهزوم؟
ظلّت المعاهدة سارية، كما اتُّفِقَ عليها، حتى عهد عبد الملك ابن مروان (685م–705م)، الذي أمر بإقامة دارٍ لسك العملة الذهبية العربية في دمشق لأول مرة في التاريخ العربي. وفي حين تفيد المصادر العربية بأنَّ عبد الملك أمر بذلك في العام 695م، أي بعد عشر سنوات من حكمه، وقبل عشر سنين من وفاته، وأنه لم يكن هناك شخصٌ واحدٌ مسؤول عن السك، بل كانت العملية مركزية بإشراف الخليفة نفسه، يسمي إدوارد غيبون، في حاشية النص حول الموضوع، المدعو “سميور اليهودي” أمينًا مسؤولًا عن إدارة السك. وقبل ذلك بقيت العملات البيزنطية، والفارسية (التي سكها كسرى الثاني أثناء احتلاله لسوريا مطلع القرن السابع الميلادي) سارية قانونيًا تحت الحكم الأموي. وكذلك لغة التدوين الحكومية، حيث بقيت الدواوين على حالها، باللغة اليونانية، كما كانت تحت الحكم البيزنطي في سوريا، ولم تتغير إلى العربية حتى عهد الوليد بن عبد الملك (705م–715م).
النقود الذهبية العربية التي سكها عبد الملك ابن مروان، خلت من الصور، خلافًا للعملات البيزنطية والفارسية، التي كانت تحمل على وجهٍ من وَجهَيها صورة الإمبراطور أو الملك الذي سكَّها، فكان وجهٌ من العملة العربية الجديدة يحمل قيمتها، ويحمل الوجه الآخر كتابة عربية منقوشة، في الغالب ذات مدلول ديني، ولذلك كان الدينار العربي الأول يسمونه في الكلام الدارج “المرقوش”. وبعد تداوله في التجارة، وصل إلى الديار الأوروبية حيث لفظوه “ماركوس”، ومنها اشتقت تاليًا كلمة “مارك” للعملة الألمانية.
*****
حتى خلافة عبد الملك ابن مروان، اقتصر الفتح العربي الإسلامي على بلاد فارس، لكن بعد إلغائه لتعهدات المعاهدة مع القسطنطينية، استأنف الفتح في شمال أفريقيا، حيث اجتثَّ الكنيسة المسيحية هناك من جذورها. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، بمجرّد المقارنة، هو لماذا بقيت المسيحية في المشرق وفي مصر والعراق، بكنائسها وصلبانها، وأساقفتها، ورهبانها، ومؤسّساتها، وأتباعها، مُصانة ومحترمة ومتوارثة إلى اليوم، بينما لم يبق لها أيَّ أثر في شمال أفريقيا، مع العلم أنَّ الكنيسة الأفريقية، أنجبت نخبة من الأساقفة اللاهوتيين اللامعين في الزمن الروماني، منهم على سبيل المثال: ترتوليان (155م–220م)، وهو قرطاجي، كان أول مؤلف مسيحي وضع أدبيات مستفيضة باللغة اللاتينية، فاعتبر “مؤسس اللاهوت الغربي”، فنال لقب “أبُ المسيحية اللاتينية”.
منهم أيضًا القديس الشهيد سيبريان (210م–258م)، أسقف قرطاجة، وتلميذ ترتوليان، وقد كان بارعًا في مواعظه وخطاباته باللاتينية، وأبرز كتَّاب اللاتينية في المسيحية الغربية.
ثالثهم، وأشهرهم، القديس أوغوسطين مطران عنابة في الجزائر، الذي اعتنق المسيحية متأخّرًا (وهو في الثلاثينات من عمره)، وكان من أرفع المثقفين في زمانه، واشتهر بكتابيه المميزين “مدينة الله”، و”اعترافات”، فقيل عنه: “أنه أسَّس من جديد الدين القديم”. أما كتابه “اعترافات”، فيعتبر من النصوص التأسيسية لفن كتابة السيرة الذاتية. وقد اشتهر أوغوسطين بنظريته حول “الحرب العادلة” التي أثارت جدلًا واسعًا في الكنيسة الغربية وخارجها، لأنَّ المسيحية الأولى، خلال القرون الثلاثة السابقة، كانت ترفض الحرب بالمطلق، ولا يشارك أتباعها في أيِّ حرب كجنود مقاتلين.
عالج موضوع نظرية القديس أوغوسطين في “الحرب العادلة”، الكاتب الأميركي مايكل سلاتاري، في أطروحته بعنوان: “المسيح المحارب: المنظور التاريخي المسيحي، ومشكلات أخلاقية الحرب، وإحلال السلام”، الصادر عن مطبعة جامعة ماركيت، الكاثوليكية اليسوعية، بولاية وسكونسن، مطلع العام 2007.
استشهد القديس أوغوسطين على يد الغزاة الفاندال الذين احتلوا شمال إفريقيا لمئة سنة، إلى أن أخرجهم منها الجنرال البيزنطي بيلازاريوس في عهد الإمبراطور يوستنيانوس الكبير، في أواسط القرن السادس الميلادي، كما مرَّ في حلقة سابقة بعنوان “معاهدة السلام الأبدي”.
هكذا بقيت المسيحية متجذّرة في مصر وسوريا وسائر المشرق، إلى اليوم، بينما استؤصلت بالكامل في شمال أفريقيا، ولم يبقَ لها أي أثر أو أتباع.
*****
القادة العرب المسلمون الذين كانوا أول الداخلين إلى دمشق، ثلاثة، يتقدمهم يزيد بن أبي سفيان، ثم أبو عبيدة ابن الجراح، وخالد بن الوليد. وبعد أيام قليلة، عقد أبو عبيدة اجتماعًا مع أساقفة المدينة في الكنيسة المريمية التي ما زالت مقرًّا للبطريركية الأرثوذكسية الأنطاكية إلى اليوم. وفي ذلك الاجتماع تم الاتفاق على منهجية التسلم والتسليم، وعلى ترحيل الرعايا اليونانيين الراغبين في العودة الى القسطنطينية خلال فترة زمنية محددة.
في تلك الأثناء طلب الإمبراطور هرقل من رعاياه اليونانيين في الشام عدم السفر برَّا، لأنه غير مأمون، وأوصاهم بالقدوم الى الساحل اللبناني حيث أرسل إليهم عددًا من السفن لنقلهم بحرًا. لكن بعد مضي ساعتين على انتهاء موعد الانتقال، بقي عدد منهم متأخّرًا في مسيرته باتجاه لبنان، فلحق بهم خالد بن الوليد على رأس قوة عسكرية وقتل بعض أولئك المتأخّرين، فكان ذلك أول خرقٍ للمعاهدة تحت اسم “حرفية تنفيذ الاتفاق”. وقد حدث ذلك بعد اجتيازهم مدينة بعلبك باتجاه الساحل اللبناني الشمالي.
ثم حدث في تلك الأثناء أن أُقيمَ عرسٌ كبير لابنة أمير طرابلس الشام، حضره أكثر من عشرة آلاف مدعو، في “دير أبي القدوس”، على مقربة من الأراضي اللبنانية لجهة بعلبك، فداهمهم أيضًا خالد بن الوليد، فقُتل منهم كثيرون. وكان ذلك الخرق الثاني الذي استهدف اليونانيين، مع أنَّ الطرابلسيين في حينه لم يكونوا بعد تابعين للخلافة الإسلامية.
أما الخرق الثالث الذي أدَّى إلى عزل خالد بن الوليد من مناصبه، فهو “معركة اليرموك” المشهورة، التي كانت معركة من طرف واحد، فيما كانت القوة البيزنطية تنسحب من مواقعها، للتوجه الى قيصرية البحر على الساحل الفلسطيني، لنقلها بالسفن الى بلادها. وقد وصفت المراجع الغربية وضعية الجيش البيزنطي في الجنوب السوري آنذاك، بأنها “وضعيةُ انسحابٍ منظَّم”. ولهذا، رفض البطريرك اليوناني صفرونيوس في القدس أن يفتح أبواب مدينته للقوات العربية المتقدمة نحوها إلّاَ للخليفة عمر بن الخطاب، الذي قدم بنفسه الى القدس ليلتقي صفرونيوس في “كنيسة القيامة”، ويتسلم منه المدينة المقدسة. وعندما حان وقت الصلاة، طلب منه البطريرك أن يؤدي الصلاة في الكنيسة، لكنه اعتذر وخرج الى مكان يبعد مسافة عن الكنيسة، “حتى لا يتخذ المسلمون من بعده، صلاته في الكنيسة حجةً للاستيلاء عليها”.
في القدس أيضًا، أطلق عمر بن الخطاب “عهدته بحفظ كنائس المسيحيين، وأديرتهم، وصلبانهم، وأجراسهم، وحياتهم، وممتلكاتهم”، وهي المعروفة باسم “عهدة عمر”، بينما هي في الحقيقة تأكيد للمعاهدة الأصلية مع أبي سفيان. وهي أيضاً تأكيدٌ للسبب الذي أوجب على الخليفة عمر عزل خالد بن الوليد.
*****
في مصر كانت الحكاية مختلفة قليلًا عنها في سوريا، والتعريب المصري، ثقافيًا ودينيًا ومجتمعيًا، كان متدرّجًا واستغرق قرونًا عدة. الطبقة الحاكمة الجديدة، التي حلَّت محل الحكام البيزنطيين، كانت كلها عربية في البداية، خصوصًا في السنوات الثلاث الأولى (639م–642م). وبقيت الأحوال العامة في مصر كما كانت من قبل زمنًا طويلًا نسبيًا، فكان انتشار الإسلام هناك بطيئًا ومتدرّجًا، ومع الوقت بدأ ينتشر ويتّسع بوتيرةٍ أعلى مع توسع انتشار اللغة العربية، لتحل بالتالي، مخلَّ اللغتين السائدتين في الماضي، وهما اليونانية والقبطية.
بقيت اليونانية تُستخدَم في الكنائس الأرثوذكسية، حتى بعد تعريب الليتورجيا الكنسية، في سوريا ومصر، والسريانية في سوريا والعراق ولبنان. وهذ النمط ما زال مستمرًّا إلى اليوم في الكنائس المسيحية الشرقية.
أمّا في سوريا، خلافًا لمصر، فقد كان التعريب سريعًا على جميع المستويات الثقافية والدينية والمجتمعية، لوجود احتكاك سابق لبلاد الشام مع الجزيرة العربية قبل الإسلام، خصوصًا في مجال التجارة. وقد أخذ التعريب المصري، شكل التدرُّج على شكل دوائر: الدائرة الأولى، من خلال التعاطي مع الحكومة في تسيير أمور الناس. والدائرة الثانية، التعاطي التجاري في الأسواق، والدائرة الثالثة، هي الشؤون الدينية، حيث وجوب التعريب المقترن بلغة القرآن الكريم، وأخيرًا دائرة الشؤون الثقافية واليومية بين الناس بعضهم مع بعض.
من هذه الناحية اختلف الوضع المصري والسوري، مع الإسلام واللغة العربية، عما جرى في الفتح العربي الإسلامي لبلاد فارس، تبعًا لاختلاف طريقة الدخول الإسلامي إليها. فالحكم الإسلامي في سوريا ومصر لم يقم بالقوة، كما مرَّ سابقًا. أما بلاد فارس فقد أخذها المسلمون العرب بالحرب (ساعدهم على ذلك، نشوب حرب أهلية في بلاد فارس بعد مقتل كسرى الثاني على يد ابنه، كما مرَّ في حلقة سابقة). لذلك فإنَّ إيران، على الرُغم من اعتناقها الإسلام، فإنها لم تستعرب، بل احتفظت بلغتها، وبهويتها الثقافية المميَّزة. وهذا شيءٌ منطقي، لأنَّ اللغة المحكية سابقًا في سوريا ومصر، أي اليونانية، هي لغة وافدة وليست أصيلة، فكان من الأسهل التخلي عنها، تماشيًا مع النظام الجديد، أما اللغة الفارسية وثقافتها، فهي أصيلة وليست دخيلة على المجتمع الإيراني وثقافته السائدة قبل الإسلام.
لكنَّ الوضع الإيراني شهد تحوّلًا نوعيًّا خلال حكم الشاه إسماعيل الصفوي، باتخاذ قرار فرض التشيُّع.
(الحلقة المقبلة، والأخيرة، يوم الأربعاء المقبل بعنوان “الوطن الشيعي”).
إشكالية السلم والحرب بين إيران والغرب (11)
احتواءُ إيران بعزلِها عن سوريا
خَطَرَ ليوليوس قيصر في منتصف القرن الأول قبل الميلاد، أن يُكرّرَ تجربة الإٍسكندر المقدوني في الزحف على بلاد فارس والسيطرة عليها، لكن صهره لاحقًا، بومبيوس الكبير، زَوَّجَ ابنته جوليا، الذي ضمّ سوريا إلى الإمبراطورية الرومانية، وأعلنها ولايةً كاملة الأوصاف، سبقه إلى رسم الخريطة السياسية بين روما وفارس. فقد أعلن بومبيوس الكبير في العام 64 قبل الميلاد، إنَّ سوريا هي “خط الدفاع الأول عن الإمبراطورية الرومانية”.
اعتبرَ القائمون على شؤون الجمهورية الرومانية، خلال العقود الأخيرة من حياتها، قبل “مرحلة الأباطرة”، أنَّ بلادَ فارس ليست مثل باقي البلدان البربرية التي ضمّتها روما إليها في الجوار الأوروبي وجرمانيا، بل هي بلادٌ فيها حضارة عريقةٌ ومميَّزةٌ وقائمةٌ بذاتها، ليست أقلَّ شأنًا من الحضارة الرومانية (اللاتينية–الإغريقية). وهذا كان اعترافًا بالتكافؤ الحضاري يجب أن يُحتَرَم. لكنه لم يكن بأيِّ حالٍ تكافؤًا بالقوة العسكرية والطاقات الاقتصادية.
كانت روما ترى أنَّ إمكانياتها، الاقتصادية، والعلمية، والعسكرية، أكبر بكثير من إمكانيات الدولة الفارسية، وبالتالي فإنَّ الفرس، مهما حاولوا، لن يستطيعوا التغلّب على الدولة الرومانية، أو الوصول الى عقر دارها، لكنهم يمكن، بين حين وآخر، أن يكسبوا معركةً حدودية، أو يدخلوا مؤقتًا الى إحدى الولايات التابعة للدولة الرومانية في الشرق. باختصار، يجزم التحليل الروماني للعلاقة مع الفرس، أنَّ الدولة الفارسية لن تستطيعَ قهر أو احتلال إمبراطورية روما أو تفكيكها.
لم يكن، في ذهن أحد من حكام روما أن يستعيدَ تجربة الإسكندر المقدوني في احتلال بلاد فارس وفرض حكمه عليها. بل اعتبروا أنَّ دفعَ إتاوات إلى الفرس لحفظ سلام الحدود الشرقية، أقل كلفة بكثير من أيِّ مناوشة أو حرب عسكرية معهم. وهذا النوع من الترتيب المالي جرى مرّاتٍ عدة في عهودٍ مختلفة، من أيام الجمهورية الرومانية، إلى أيام الدولة البيزنطية، بعد انشطار الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي.
هذا لا يعني أنَّ التعايش السلمي بين الإمبراطوريتين كان كاملًا وتامًا ولا تشوبه شائبة، فكلٌّ منهما حاول بين الحين والآخر، وحسب الظروف، أن يُحسِّنَ شروطه. لكن على وجه العموم كانت الحدود النهائية بينهما قد رسمت نفسها، بعد وصول الإمبراطور تراجان الى الخليج الفارسي. تلك الحدود لم تكن واضحة، إلّا في معالمها الجغرافية، لكونها بقيت متحّركة بين النهرين الكبيرين في العراق، دجلة والفرات. فإذا تمدَّد الفرس فإلى شرق الفرات فقط، وإذا تمدَّد الرومان فإلى غرب دجلة. هذا هو النطاق الذي لم يتغيَّر لمئات السنين.
بالإضافة الى الاعتراف بالتكافؤ الحضاري، كان إعلانُ بومبيوس حول سوريا، بمثابةِ مَبدَإٍ سياسي واضح المعالم، بأنَّ الجمهورية الرومانية تنطلق، في علاقتها مع بلاد فارس، من مَبدَإِ “حسن الجوار”، وبالتالي فإنَّ طبيعة عقيدتها العسكرية في هذه الحالة، هي طبيعة دفاعية.
هذا المبدأ يعني، أنَّ سوريا هي مركز الثقل للوجود الروماني في الشرق، وأنَّ روما سوف تدافع عنها بكلِّ ما أوتيت من قوة وقدرة. وبالتالي فإنها لن تسمح للمناوشات الحدوديَّة أن تتحوَّل الى حرب شاملة، طالما أنها لا تتهدَّد الأمن الروماني في سوريا.
اجتاح الفرس سوريا مرة في القرن السادس قبل الميلاد، من قبل الدولة الإخمينية، ومعها بلاد اليونان أيضًا، وقام اليونانيون مرَّةً باجتياح بلاد فارس وتخليص سوريا ومصر من الحكم الفارسي، على يد الإسكندر المقدوني، في القرن الرابع قبل الميلاد، فكأنما انكتبَ بذلك قدَرٌ غير معلن بين الفريقين، عنوانه: “واحدة بواحدة ولن تتكرَّر”.
بقيت هناك مناوشات حدودية لمئات السنين، خصوصًا في أرمينيا، كما مرَّ في حلقة سابقة، حيث جرت تسوية بالشراكة للموضوع الأرمني في عهد الإمبراطور نيرون في العام 63 للميلاد، أي بعد مئة سنة تمامًا من مبدَإِ بومبيوس بخصوص سوريا. فقد اعتبر الرومان سوريا جُزءًا من دولتهم، وليست منطقةً حدودية، وبالتالي فإنهم غير مُستعدّين لإشراك أحدٍ فيها، كما حدث في أرمينيا.
هذا المفهوم أحدث تغييراتٍ جوهرية في منطلقات ودوافع كلٍّ من الفريقين، اقتضى تصويب البحث التاريخي، من اعتبار أنَّ “حالة الحرب” بين الروم والفرس، هي المسار العام والدائم بينهما، إلى اعتبار السلام هو الأساس والحرب هي الاستثناء.
*****
لم تبقَ الاستراتيجية الرومانية، من الناحية التطبيقية، ثابتة في جميع المراحل والعهود، إلّا بمنطلقاتها العامة، كما ترسَّخت في إطارها الأصلي، أي أنَّ “السلام هو القاعدة، والحرب هي الاستثناء”. وهو ما أدركته وراعته الدولة الفارسية، وما زالت تُراعيه حتى اليوم، إذا اعتبرنا أنَّ الغرب الراهن، بشكلٍ عام، يُشكّلُ امتدادًا تاريخيًا مُتواصِلًا للمفاهيم الرومانية القديمة، قبل انتشار المسيحية هناك، وبعدها. وظلَّ هذا الإطار قائمًا بعد سقوط الدولة الرومانية في الغرب، وبقائها في الشرق، بموجب القاعدة السابقة القائمة على محوريَّة سوريا ضمن الإمبراطورية البيزنطية (الرومانية الشرقية).
بل إنَّ ما كان أمرًا واقعًا، زمن الإمبراطورية الرومانية في الغرب، أصبح في زمن الإمبراطورية الرومانية الشرقية مكتوبًا على الورق في “معاهدة السلام الأبدي” المعقودة بين الدولة الفارسية الساسانية، ممثلة بملكها كسرى الأول (أنو شروان)، وبين الإمبراطور البيزنطي يوستنيانوس الكبير في العام 532 للميلاد. وقد أخذ البيزنطيون تلك المعاهدة بجديًّة إلى درجة أنَّ الإمبراطور البيزنطي يوستنيانوس، أَمِنَ لتلك المعاهدة بحيث أهمل دفاعات سوريا إلى الغرب من الفرات!
إنَّ مثل هذه الحالة لم تنشأ سابقًا، خلال القرنَين الأوَّلين من الميلاد، حيث جرى مرّتين على الأقل تعزيز دفاعات سوريا إلى الغرب من الفرات. ففي العام 69 للميلاد، حدثت اضطراباتٌ يهودية في فلسطين، فأرسلت روما جيشًا لقمعها بقيادة الجنرال فسباسيان، الذي اختير إمبراطورًا وهو في سوريا، فعاد إلى روما وسلَّم قيادة الحملة الى ابنه الجنرال تيتوس (الذي أصبح إمبراطورًا في وقت لاحق)، فدخل تيتوس إلى فلسطين، في العام 70 للميلاد وقمع التمرُّد اليهودي، ودمَّر الهيكل، وعاد إلى روما ليبني “الكولَيزيوم”، وإلى جانبه قوس النصر الذي يحمل اسمه، وهما الآن من المعالم السياحية الكبرى التي ما زالت قائمة في مدينة روما إلى اليوم. دوَّن هذه الحملة المؤرخ اليهودي الروماني فلافيوس يوسِفوس في كتابه “الحروب اليهودية”، (اسمه اليهودي “يوسف بن متاتياهو”).
شارك المؤرخ يوسِفوس في الحرب اليهودية ضد الرومان، (66م–70م)، وكان فيها قائدًا ميدانيًا، لكنه بعد حصارٍ للقوات، التي كان منضويًا فيها، دام نحو شهرين، استسلم إلى القائد الروماني فاسباسيان، ودخل في خدمته، وصار مترجمًا له. وعندما أصبح فاسباسيان إمبراطورًا أطلق سراحه، ومنحه الجنسية الرومانية، فدخل في خدمة الجنرال تيتوس، في العام 70 للميلاد، واتخذ لنفسه الاسم اللاتيني لعائلة فاسباسيان وتيتوس، وهو “فلافيوس”، وصار مُترجمه الخاص، خلال الحصار الشديد الذي فرضه تيتوس على مدينة القدس، التي استباحها ودمَّرها، بما في ذلك الهيكل الثاني (هيكل هيرودوس). وكان يوسِفوس شاهدًا على حصار “مصعدة” حيث انتحر المتمردون اليهود المحاصرون هناك جميعهم. وتعتبر كتاباته من المراجع المهمة للحقبة المسيحية الأولى، التي نشأ في أجوائها، وطرقت مسامعه أخبار شخصياتها، ومنها بيلاطُس البنطي، والملك هيرودوس الكبير، ويوحنا المعمدان، ويسوع الناصري وغيرهم.
في ذلك الوقت كان لفلسطين وضعٌ خاص، وهو وضعٌ دعمت استمراره كليوباترا ملكة مصر، في النصف الأخير من القرن الأول قبل الميلاد، بطلبٍ خاص لها من يوليوس قيصر، عشيقها في ذلك الوقت، وهو وضعٌ قضى ببقاء فلسطين مملكة، ذات حكم ذاتي، كما أبقاها الجنرال بومبيوس الكبير عندما احتلَّ القدس في العام 63 قبل الميلاد، بعدما جعل سوريا جُزءًا من الإمبراطورية الرومانية.
هذا الوضع الفلسطيني تغيَّر تغيُّرًا جذريًا خلال النصف الأول من القرن الميلادي الثاني، بعد الانتفاضة اليهودية الكبرى التي قادها شيمون بن كوخبا، في عهد الإمبراطور هادريان عام 135م، الذي اجتثَّ تلك الانتفاضة بقسوة شديدة، وأزال صفة الحكم الذاتي عن فلسطين، وألحقها بولاية سوريا، وصار اسمها في الدواوين الرومانية “فلسطين السورية”، (ٍسيريا بالستينا)، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يشملها النظام الدفاعي الروماني عن الولاية السورية.
بذلك اتسع “مبدأ بومبيوس” باعتبار سوريا خط الدفاع عن الإمبراطورية الرومانية ضد التوسع الفارسي، ليشمل أيضًا الدفاع عنها ضد الخطر اليهودي، فازداد ثقل مركزية سوريا في النظام الروماني.
*****
قبل نشوء هذه الحالة الفلسطينية في سوريا، وبعدها أيضًا، أجرت الدولة الرومانية تعزيزات دفاعية واسعة للمنطقة السورية. ففي مطلع القرن الثاني الميلادي، (100-103م)، قام الإمبراطور تراجان، سلف هادريان، بحملةٍ عسكرية وصل بها إلى أطراف الجزيرة العربية المُطلّة على بلاد فارس، والمعروفة باسم “بلاد البحرين”، (المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية حاليًا)، حيث أطلَّ من “القطيف” على بلاد فارس.
من القطيف، توجّه تراجان الى العراق، حيث أقام استحكامات دفاعية بالقرب من البصرة، وهي المرة الأولى التي وصل فيها جيش روماني إلى تلك المنطقة، منذ احتلال الإسكندر المقدوني لبلاد فارس، خلال الثلث الأول من القرن الرابع قبل الميلاد. كان ذلك ضمن خطة تراجان للدفاع عن سوريا. ولحماية هذا الوضع الدفاعي الجديد، ضم تراجان مملكة أرمينيا الى الإمبراطورية الرومانية، وكذلك بلاد ما بين النهرين (بالتوسُّع من غرب الفرات الى غرب دجلة)، وبلاد الأشوريين في شمال العراق، وجعل كلًّا منها ولاية رومانية مثل سوريا.
الشق الثاني من خطة تراجان هذه، اقتضى إزالة وضع الحكم الذاتي لمملكة الأنباط في “بترا”، (أرابيا بترايا) الممتدة من جنوب سوريا الحالية، وشرق الأردن، إلى صحراء تهامة، وصولًا إلى أطراف الحجاز. وكانت مملكة الأنباط في تلك المرحلة من التاريخ الروماني مملكة غنيَّة تسيطر على خطوط التجارة بين الشام والجزيرة العربية، وقد سيطرت على مدينة دمشق لفترة وجيزة من 85 الى 71 قبل الميلاد.
تجارة التوابل والبخور، كانت تأتي من اليمن، عبر الجزيرة العربية، إلى “بترا”، ومنها إلى غزة على الساحل الفلسطيني، ومن غزة تُشحن بحرًا إلى أسواق أوروبا.
مملكة “بترا” هذه جعلها تراجان ولاية رومانية، تحت الحكم المباشر من روما، وأقام فيها استحكامات عسكرية قوية في العقبة على البحر الأحمر، وشق من العقبة طريقًا برِّيًا مُبلَّطًا، إلى مدينة بُصرى في جنوب سوريا، لضمان سرعة الانتقال للألوية الرومانية في الحالات الطارئة.
هكذا طوَّق تراجان سوريا، بمواقع دفاعية رومانية خالصة من أرمينيا والعراق، إلى البحر الأحمر. هذا الطوق عزَّزه من بعده خلفه الإمبراطور هادريان، الذي ضم فلسطين الى الولاية السورية، بعد الانتفاضة اليهودية (135م-138م).
ثم قام الإمبراطور سبتيموس ساويرس في العام 197م بحملة توسُّعية في شمال العراق، بهدف إقامة حاجز إضافي للدفاع عن سوريا. والمعروف أنَّ سبتيموس هو من مواليد ليبيا، ومسقط رأسه هناك المدينة الرومانية المعروفة في التاريخ الروماني باسم “لابتيس ماغنا”، حيث وسَّعها وجمَّلها سبتيموس، وما زالت قائمة الى اليوم، سالمة أكثر من أيِّ أثر روماني آخر في العالم، بما فيه قلعة بعلبك في لبنان. وهي الآن معروفة في ليبيا باسم مدينة “الخُمس” التي تبعد حوالي 140 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مدينة طرابلس العاصمة.
أذكر أنني، في شهر حزيران من العام 1970، زرت طرابلس لتغطية مؤتمر قمة عربي، بحضور الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، قبل نحو ثلاثة أشهر من وفاته، وبعد ثورة معمر القذافي في الفاتح من أيلول (سبتمبر) بتسعة أشهر فقط (انعقد المؤتمر في قاعدة “عقبة بن نافع”، وهي قاعدة جوية أميركية سابقة كانت تدعى “قاعدة ويلاس”). وبعد انتهاء القمة العربية الموسَّعة، التي مثَّل لبنان فيها الرئيس شارل حلو، انعقدت قمة أخرى لما كان يُسمى في حينه “دول المواجهة”، لم يكن لبنان من بينها، بل كانت صفته من “دول المساندة”، فارتأى الرئيس اللبناني أن يعود الى بيروت لأنه غير معني بالقمة الثانية، وغير مدعوٍّ إليها أصلَا. لكن القذافي استوقفه، وقال له: “لا تسافر لأنني سوف أُريكَ معلمًا رومانيًا أعظم من قلعة بعلبك اللبنانية”، فانتقلا معًا إلى “مدينة الخُمس” التي أذهلت الرئيس حلو. ويقدِّر بعض المهتمين بشؤون الآثار، أنَّ سبتيموس أنفق على توسعة وتجميل مسقط رأسه، بالحجارة المنحوتة، والأقواس المعمارية الخالدة، والمنحوتات النادرة، ما يعادل نصف ما أنفقته روما على المدن الإيطالية قاطبةً!
*****
اختلفَ الوضعُ قليلًا في بلاد فارس بقيام الدولة الساسانية بقيادة الملك أردشير الأول، وابنه شاه بور الأول، وهي الدولة التي اعتنقت الزرادشتية ديانة رسمية للبلاد، وذلك في أواسط القرن الثالث الميلادي (سُمِّيَت “إيران شهر”، أي “بلاد الآريين”). واعتناق الدولة الساسانية للزرادشتية يُشبه كثيرًا اعتناق الشاه إسماعيل الصفوي للمذهب الشيعي في مطلع القرن السادس عشر الميلادي. ومع أنَّ الدولة الساسانية، في بدايتها، كانت دولة قويَّة نسبيًا، إلّاَ أنَّ حدودها لم تكن ثابتة. وقد جاء في كتاب “أطلس تاريخ الإسلام” (الصادر عن “دار الزهراء للعالم العربي” في مصر، عام 1986، بإشراف الدكتور حسين مؤنس): “هناك مبالغة في نصوص تصوير اتساع دولة فارس في العصر الإيراني؛ لأنَّ فارس لم تكن قط في أيِّ عصر من عصور تاريخها قبل الإسلام دولة ثابتة الحدود، إنما كانت حدودها تتَّسعُ أحيانًا في عصور الملوك الأقوياء، وتنقبض في عصور الضعفاء، وهم الأكثرون”.
كانت غالبية حروب الدولة الساسانية في إيران، مع الإمبراطورية الرومانية، ومن بعدها الإمبراطورية البيزنطية، مناوشات حدودية، كما في المرحلة السابقة، بعد الفتح الإسكندري. لكن القوات الساسانية في بعض حروبها الحدودية، استطاعت أن تهزمَ أو تقتل وتجرح عددًا من الأباطرة الرومان أكثر من أيِّ مرحلة سابقة.
في العام 242م، قام الإمبراطور الروماني غورديان الثالث (حكم من 238م الى 244م)، بحملة ناجحة ضد الدولة الساسانية بقيادة الملك شاه بور الأول، فأنزل بالجيش الفارسي هزيمة مشهودة في معركة “الفلوجة” في العراق. وبعد المعركة توفي قائد الحرس الإمبراطوري، وهو والد زوجة الإمبراطور، بسبب المرض، فاختير لقيادة الحرس (وهو أشبه ما يكون بالحرس الجمهوري الذي أقامه صدام حسين خلال فترة حكمه، سواء من حيث القوة والعتاد أو من حيث الامتيازات)، ضابط يُدعى ماركوس فيليبوس، وهو سوري من الجولان، عُرف تاريخيًا باسم “فيليب العربي”.
خلال تلك الفترة القصيرة قُتل الإمبراطور غورديان في ظروف غامضة، والمرجح أنها مؤامرة من ضباط الحرس، الذين أعلنوا على الفور اختيار “فيليب العربي” إمبراطورًا (حكم من 244م الى 249م). ولهذا السبب اضطر الإمبراطور فيليب أن يعقد هدنة مع الملك الفارسي، ليعود سريعًا إلى روما ليحصل على تثبيت لمنصبه الجديد من مجلس الشيوخ. وقد دفع لقاء ذلك مبلغًا كبيرًا من المال إلى الملك الفارسي يُقدَّر بنحو 500 ألف دينار من الذهب!
الثابت تاريخيًا أنَّ الإمبراطور فيليب هو من “عرب اللجاة”، وهي منطقة الحجارة البركانية، في سوريا الحالية، بين حوران وجبل الدروز، وقد حذا حذو سلفه سبتيموس سويروس، من حيث الاهتمام بالمنطقة التي ولد فيها، وإعمار مدنها. وكانت “اللجاة” في ذلك الوقت جُزءًا من ولاية بترا، التي كانت من قبل مملكة ذات حكم ذاتي ضمن الإمبراطورية الرومانية.
*****
أما الإمبراطور الروماني الأتعس حظًّا من أسلافه، في الحرب مع الفرس، فهو “فالريان” (حكم من 253م – 260م)، وقد اشتهر باضطهاده للمسيحيين في جميع أنحاء الإمبراطورية. وهو جاء إلى الشرق في حملة تأديبية ضد زنوبيا ملكة تدمر السورية، التي أصبحت السلطة في يدها، كوصية على ابنها القاصر، بعد اغتيال زوجها، العائد من معركة مظفَّرة ضد الفرس.
استغلّت زنوبيا انشغال الدولة الرومانية، بحروب عديدة، أنهكتها وأضعفتها، وبصراعاتٍ على السلطة استنزفتها، وقامت بالسيطرة على الولايات الرومانية في جوارها من أقصى الأناضول الى أقصى صعيد مصر، فاعتبرت نفسها ندًّا لروما، وأعلنت نفسها إمبراطورة، وبعدما كانت تدمر مملكة صغيرة تابعة، صارت إمبراطورية مستقلة. ولهذا جرَّد فالريان حملته ضدها واعتقلها، وأرسلها مع عائلتها مخفورةً إلى روما حيث قضت هناك بقية حياتها. لكن الإمبراطور الروماني فالريان، وهو في طريق عودته مع جيشه، وقع في كمين فارسي في سهل الرها عند أعالي نهر الفرات، فأسره الملك الفارسي شاه بور الأول، مع جيشه، ومات في الأسر، حيث نُسجت روايات كثيرة حول مصيره وعذاباته في الأسر الفارسي. وهو القائد الروماني الوحيد الذي وقع في يد الفرس.
في منتصف القرن الرابع، اعتلى عرش الإمبراطورية الرومانية قائد فيلسوف وشاعر، عالي الثقافة، هو الإمبراطور “جوليان” (المعروف باسم “يوليانوس المرتد”)، ابن شقيقة الإمبراطور الأسبق قسطنطين الكبير، الذي اعتنق المسيحية، وجعلها دين الدولة الرومانية، وترأس “مجمع نيقية” في العام 325، وهو أول مجمع مقدس لأساقفة الإمبراطورية الرومانية في الغرب والشرق. لكن الإمبراطور جوليان، ابن شقيقته، ارتد عن المسيحية، ونكّل بالمسيحيين، وأعاد التقاليد الدينية القديمة القائمة على تعدُّد الآلهة.
بعدما استتب الأمر للإمبراطور جوليان، ونجح في توحيد الإمبراطورية، زحف الى الشرق، عام 360م، في حملة كبيرة ضد الدولة الساسانية في بلاد فارس، كانت ناجحة في بدايتها، حيث وصلت حملته الى العاصمة الفارسية (ستسيفون)، لكنه لم يشأ أن يحاصرها، بل واصل حملته في العمق الإيراني، حيث اصطدم بمشكلات لوجستية، من حيث نقص الإمدادات، فعاد أدراجه، وخاض قتالًا شديدًا مع الجيش الفارسي في مدينة سامراء في العراق، حيث أصيب بجرحٍ قاتل.
كانت مدينة أنطاكية آخر محطة سورية للإمبراطور جوليان، وهو في طريقه الى بلاد فارس. والمعروف أنَّ أنطاكية هي عاصمة المسيحية الأولى، فقابلته ببرود وعداء، حيث كتب الإنطاكيون في كل ساحات المدينة شعارات ساخرة ضدَّه، ورسومًا كاريكاتورية على الجدران، لم يتسع وقته لإزالتها، لكنه ردَّ على أهل أنطاكية بالمثل، وهو يغادرها إلى الحرب التي لم يعد منها، بقصيدة شعرية هجائية كتبها وعلقها على مدخل المدينة!
كان من الطبيعي أن يعتقد المسيحيون في ذلك الوقت، بأنَّ جوليان، كما فالريان، دُحرا وقتلا في بلاد فارس، جزاء تنكيلهما بأتباع المسيح!
بعد حكم جوليان بفترة وجيزة انشطرت الإمبراطورية الرومانية إلى غربية وشرقية، واحدة عاصمتها روما، والثانية عاصمتها القسطنطينية.
*****
يمكن تلخيص الاستراتيجية الرومانية لاحتواء إيران، قبل انشطار الإمبراطورية، بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى، من بداية حكم أغسطس قيصر في العام 31 قبل الميلاد إلى نهاية حكم نيرون في منتصف العام 68 للميلاد، وهي مرحلة شملت خمسة أباطرة، أغسطس (الذي وُلد المسيح في عهده)، تيبيريوس (الذي صُلب المسيح في أيامه)، كاليغولا، كلوديوس (الذي احتل بريطانيا وجعلها ولاية رومانية، ونيرون (الذي احترقت مدينة روما في فترة حكمه). وهؤلاء قام تعاطيهم مع الفرس على الدفاع القوي، والديبلوماسية المرنة. فقد أقيمت معسكرات مؤقتة للألوية الهجومية داخل الحدود، والاعتماد خارجها على ملوك تابعين لروما يشكلون مناطق عازلة، أو يجري استخدامهم بالوكالة في مناوشات مجدودة، غالبًا ما كانت تمهيدًا لتحرُّكٍ ديبلوماسي.
المرحلة الثانية، هي مرحلة “العائلة الفلافية”: فاسباسيان، وابناه تيتوس، ودوميتيان (امتد حكم هذه السلالة من العام 69م إلى العام 96م). قامت استراتيجية هذه المرحلة على إلغاء الملوك الزبائن، وإقامة معسكرات دائمة للألوية العسكرية، وبناء عوائق دفاعية منيعة ومانعة.
المرحلة الثالثة والمتأخّرة، من 284م الى انشطار الإمبراطورية في القرن الرابع الميلادي، قامت على الدفاع في العمق، مع قطعات عسكرية متحرّكة ميدانيًاً من الاحتياطي. وقد بقيت الحدود الشرقية للإمبراطورية مفتوحة، لأنَّ التفكير الاستراتيجي خلال تلك المرحلة، الطويلة نسبيًا، لم يكن مُرتكزاً على الحدود، بل على الشعوب.
لذلك تمركزت القوات العسكرية في المدن وليس على الحدود المفترضة، حيث أقيمت قلاع لها حاميات عسكريَّة صغيرة غايتها تأمين خطوط المواصلات ليس إلّا.
(الحلقة المقبلة يوم الأربعاء المقبل: تسلُّم وتسليم بين العرب والروم!)
إشكالية السلم والحرب بين إيران والغرب (10)
إسكندرٌ واحدٌ… لا إسكندران!
“ستاجيرا” بلدة ريفية في منطقة مقدونيا الوسطى في بلاد الإغريق، أسسها في العام 655 قبل الميلاد رهط من المهاجرين قدموا من أنحاء يونانية أخرى. بعد الحرب الفارسية التي دحرت فيها أثينا الأسطول الفارسي في معركة “سلاميس”، (480 ق.م)، انضمت إلى “حلف أثينا الأول”، لكنها انتفضت ضده في العام 424 قبل الميلاد، وخلال “حرب البيلوبونيز” انضمت الى اسبارطة ضد أثينا. وفي العام 348 ق.م، احتلها الملك المقدوني فيليب الثاني والد الإسكندر، ودمَّرها، وباع أهلها عبيدًا في سوق النخاسة!
هذه البلدة المتعوسة والمتقلّبة، اشتهرت في التاريخ القديم لكونها مسقط رأس الفيلسوف الإغريقي الكبير أرسطو، الذي اختاره الملك فيليب لتعليم ابنه ووريثه الإسكندر المقدوني. في ذلك الوقت، كان أرسطو قد قضى عشرين سنة يُدرِّس في “أكاديمية أفلاطون” في أثينا (منذ أن كان عمره 17 سنة حتى بلغ 38 سنة من العمر)، ولم يغادر “الأكاديمية” إلاَّ بعد وفاة أفلاطون في العام 348 قبل الميلاد.
لماذا اختار الملك فيليب الفيلسوف أرسطو لتعليم ابنه؟
السبب الأول، بطبيعة الحال، هو شهرة أرسطو وصيته الذي طبَّق الآفاق. والسبب الثاني أنَّ والد أرسطو كان صديقًا لوالد الملك فيليب، وطبيبه الخاص، أو بالأحرى طبيب البلاط المقدوني.
لكن كيف تمَّ ذلك، والملك فيليب هو الذي دمَّر بلدة أرسطو ومسقط رأسه (ستاجيرا) ودفع أهلها الى العبودية؟
الروايات التاريخية تُجمع على أنَّ الصفقة تمّت بطريقة “المافيا” في الزمن الحاضر، أي أنَّ الملك فيليب قدَّم لأرسطو عرضًا لا يستطيع أن يرفضه. فما هو هذا العرض؟
أولًا، يقوم الملك فيليب بإعادة بناء بلدة “ستاجيرا” كاملةً، ويُعيدُ أهلها إليها بعد إعتاقهم من العبودية.
(ما يُذكِّر اللبنانيين اليوم بخطاب السيد حسن نصر الله، بأنَّ “حزب الله” سوف يُعيد إعمار القرى الحدودية المدمرة في جنوب لبنان بأجمل مما كانت عليه).
ثانيًا، يقوم الملك فيليب ببناء أكاديمية باسم أرسطو في أثينا، تُخصَّص في البداية لتدريس الإسكندر وشلة من رفاقه المقرَّبين، الذين أصبح معظمهم جنرالات في جيشه، بعد جلوسه على العرش خلفًا لوالده.
ثالثًا، يدفع الملك المقدوني تكاليف الأكاديمية، وراتبًا يليق بمعلم مثل أرسطو.
رابعًا، يتعهّد الملك المقدوني بإلحاق بعثات علمية مرموقة يختارها أرسطو لمرافقة الجيش المقدوني في حملاته العسكرية لدراسة أحوال البيئة، والطبيعة، والمناخ، والحياة، والسكان، في البلدان التي يفتحها الجيش. وبالفعل قبل أرسطو هذا العرض الذي تمَّ تنفيذه من الفريقين بحذافيره.
استغرقت عملية التدريس هذه للإسكندر ورفاقه مدة أربع سنوات (منذ أن كان عمر الإسكندر 13 سنة، الى حين بلوغه 16 سنة). وقد شمل برنامج الدروس، الفلسفة، والرياضيات، والسياسة، والديبلوماسية، والشعر، والفلك، والموسيقى، بالإضافة الى برنامج للقراءة شمل كتابات منوعَّة من “الياذة هوميروس”، إلى “جمهورية أفلاطون”.
خلال تلك الفترة أثبت الإسكندر أنه محبٌّ للعلم، ومدمنٌ على القراءة، سريعُ البديهة، ذكيُّ الملاحظة.
*****
بعد إكمال هذا البرنامج الكثيف، انصرف الإسكندر ورفاقه الى التدريبات العسكرية، وإتقان فنون المناورة في الحرب، وشؤون التدريب والإدارة، ومعايير اختيار القيادات الميدانية. وفي العشرين من عمره توفي والده فجلس على العرش المقدوني ليصبح القائد العسكري الأول في التاريخ العالمي من ذلك اليوم الى هذا اليوم.
شغل الباحثين والمؤرخين لقرون طويلة، وما زالت الى الآن، تصدر كتب ودراسات تتناول سيرته من زوايا جديدة، بالإضافة الى كون عملياته العسكرية مادة أساسية يجري تدريسها في الكليات الحربية حول العالم. ومن أواخر الكتب المهمة التي صدرت أخيرًا عن مطبعة جامعة أكسفورد البريطانية، كتاب بعنوان: “جنديٌّ وكاهنٌ وإله: حياة الإسكندر الكبير”، من تأليف فريد نايدن، أستاذ التاريخ في جامعة نورث كارولينا الأميركية، الصادر في العام 2019.
لافتٌ في هذا الكتاب تسليط الضوء على التوجّه الديني للإسكندر المقدوني، لجهة أنه “مبتكر في الفكر الديني”، خصوصًا بعد فتحه لمصر، حيث تمازجت الثقافة الهلينية بسهولة مع الثقافة المصرية السائدة آنذاك، بحيث يمكن القول بأنَّ مصر “علّمته كيف يفكر لاهوتيًا”. لكن الإسكندر لم يتفاعل بسهولة مع الأديان الأخرى، إما لأنه لم يرغب في ذلك، أو لأنه لم يستطع، ربما لعلة في عقليَّات الشعوب الأخرى، أو بسبب رواسب في ثقافته الموروثة في المسائل الدينية، من حيث إنه لا يعتبر أنَّ كل الأديان متساوية في جوهرها، لكنه كان يتعاطى مع الديانات المحلية والأجنبية باحترام.
ما من قائد في العالم إلَّا وتأثر به، بعضهم حاول، وبعضهم راودته نفسه ولم يُقدم. فلم تجتمع الخصال العليا في قائد مثلما اجتمعت فيه: جندي شجاع، وقائد ملهم، وسياسيٌّ بارع، وكاهنٌ ورع، وشبيه الآلهة، أو متألهٌ فوق الملوك والحكام، شديد القسوة على أعدائه، ضنين على أصدقائه وحلفائه، مهنته الابتكار في الحرب فلا يتردد في القتل، كما لا يتردد في العفو.
كان يعرف مكانته، ويتصرّف على أنه وحيدُ زمانه، فلا عجب أنَّ ما من قائد في التاريخ من بعده استطاع أنْ يجاريه. والأهم من ذلك حمل الثقافة الهلينية، التي تشرَّبها من أغزر ينابيعها، ونشرها في العالم، منارةً للعقول، ووسيلةً للترقي. هكذا بقي العالم من بعده: إسكندر واحدٌ… لا إسكندران!
في كل الأوقات، حتى يوم وفاته في بابل في العام 323 قبل الميلاد، لم تفارق وسادته نسخة من “إلياذة هوميروس”، قدمها له معلمه أرسطو وعليها توقيعه.
*****
بعضُ الأثينيين الذين كانوا معارضين للحكم المقدوني، عاب على أرسطو قبوله تعليم الإسكندر ابن الملك فيليب، الذي قام، عامدًا متعمدًا، بتدمير بلدة “ستاجيرا”، مسقط رأس أرسطو، ونكَّل بأهلها، وأذلهم. ومنهم من نعته بأنه “معلم الطغاة”!
لهذا خلال السنوات الأربع التي تولى خلالها تدريس الإسكندر، لم يكتب أرسطو شيئًا، خشية أن يستثير الجدل والخلافات، وربما ليبرهن أنه قادرٌ على التأثير في تلميذه الى الأحسن. والثابت أنه وضع أهمَّ كتبه، التي ما زالت مادةً يجري تدريسها في الجامعات والكليات حول العالم، بعد انتهاء مهمته لتدريس الإسكندر ورفاقه.
لكن الباحثين والمؤرخين، ما زالوا إلى يومنا هذا، يدققون في كيفية وفاة الإسكندر في بابل وهو ما زال في ريعان شبابه وكامل عافيته، لا سيما حول ما إذا كان للمعلم أرسطو دورٌ في التخلص من تلميذه السابق، الذي بات يتصرَّف، بعد انتصاراته الميدانية الخارقة، وكأنه من صنف الآلهة. وقد انتشرت حوله أسطورةٌ مفادها أنَّ الإسكندر ليس ابن فيليب المقدوني، بل هو ابن الإله الإغريقي “زوس”!
ذلك أنَّ هناك شبهة تاريخية بأن الإسكندر لم يمت ميتة طبيعية، بل جرى تسميم الخمر الذي كان يحتسيه. فالرأي بدأ يميل إلى أنَّ الإسكندر شرب في بابل خمرًا مسمومًا!
ليس على هذا القول شواهد قاطعة بعد، لكن هناك قرائن لا يُستهان بها:
أوّلًا، الحساسيات بين الجنرالات الكبار الذين ورثهم في جيشه من أيام أبيه، والجنرالات الشبان الذين تصاحب معهم من أيام الدراسة، أو “شلة الرفاق”. وبالتالي، ليس من المستبعد أن يكون بعض الجنرالات القدامى قد فكر بالتخلص منه.
ثانيًا، بعد وصول جيش الإسكندر الى ضفاف “نهر الكانج” في شمال الهند، رفض ضبَّاط الجيش أن يكملوا مسيرة التوغل في شبه القارة الهندية، مطالبين بالعودة الى بلادهم. وهذا التمرد هو الذي حمل الإسكندر على العودة الى بابل، حيث لقي حتفه الغامض.
ثالثًا، الشبهات حول دور ما للمعلم أرسطو في التخلص من تلميذه السابق. هناك رواية تفيد بأن بعض قدامى القادة العسكريين السابقين في جيش الإسكندر، ممن تركوا الخدمة في الجيش، أو سُرّحوا منه تسريحًا تعسّفيًا، وعادوا الى اليونان، تشاوروا مع أرسطو في الأمر، ويقال إنه أبدى نوعًا من الموافقة، أو على الأصح، لم يبدر منه أي اعتراض!
لكن هناك روايات أخرى، تفيد بأن أرسطو لعب دورًا تنفيذيًا في “الجريمة”، بأن اقترح على المتآمرين نوع المادة الكيميائية الفعالة التي عليهم استخدامها، وبعضهم أخذ الرواية الى حدها الأقصى بالإيحاء أنَّ أرسطو قام بنفسه بتركيب الخلطة الكيميائية القاتلة!
*****
إنَّ حملة الإسكندر المقدوني في طريقه الى مصر، اصطدمت ببعض العقبات التي أخرجته عن طوره، وجعلته يرتكب مجازر ضد السكان غير مسبوقة منه. ففي مطلع العام 332 قبل الميلاد، وقف جيش الإسكندر على أبواب مدينة صور على الساحل اللبناني، فرفض أهل المدينة أن يستقبلوه، مما اضطره الى ضرب حصار عليهم امتد لسبعة أشهر.
خلال الحصار استطاع الإسكندر أن يقيم في البحر منصات وأبراج عائمة، يطلق منها ضربات شديدة بالمنجنيق على أسوار صور لخرقها، ومن فوق الأسوار لإنزال الضرر بالأهالي وممتلكاتهم. وفي النتيجة نجحت خطته فدخل الى صور ودمر ما يقرب من نصفها.
المرجع الأهم عن حملات الإسكندر العسكرية في الشرق، آريان، وهو مؤرخ وسياسي من مدينة نيقوميديا (حاليًا في تركيا الى الشرق من إسطنبول واسمها “إزميت”، وليست مدينة “إزمير” الكبرى على بحر ايجه) عاش في روما، وكتب، وجلس عضوًا في مجلس الشيوخ الروماني في القرن الأول الميلادي، قال إنَّ الإسكندر قتل من أهل صور نحو ثمانية آلاف شخص بعد سقوط المدينة في يده، لكنه أصدر عفوًا عن الأهالي الذين اعتصموا في معبد الإله الصوري “ملكارت”، الذي كان الإغريق يساوونه بالإله الإغريقي “هيرا كليس”، أما الباقون وعددهم نحو 30 ألفًا، من المقيمين والأجانب، ومعظمهم من النساء والأطفال، فقد جرى بيعهم عبيدًا في سوق النخاسة!
وقال آريان أيضًا، إنَّ الإسكندر غضب على أهل صور لأنهم أعاقوا زحفه على بلاد فارس.
*****
بعد سيطرته على صور، زحف الإسكندر بجيشه نحو مصر، فاصطدم بعائق مماثل في مدينة غزة، عندما وصل إليها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 332ق.م، لكنه وصل إليها مزوّدًا بخبرات واسعة تعلمها من حصار صور خلال الأشهر السابقة. وكانت غزة في ذلك الوقت الطريق الإلزامي إلى مصر، التي كانت تحكمها العائلة الفرعونية الواحدة والثلاثين تحت وصاية الملك الفارسي الإخميني داريوس الثالث. وكان داريوس قد عيَّن قائدًا لتحصينات غزة، المانعة لأيِّ عدو من اقتحام مصر، جنرالًا شديد المراس، اسمه “بتيس”، أعدمه الإسكندر بعد اجتياحه لغزة، لأنه تطاول عليه بالكلام، وقد احتقره الإسكندر لأنه في الأصل من الخصيان في البلاط الفارسي!
طلب الملك داريوس من “بتيس” أن يصمدَ في وجه الإسكندر مدة كافية تسمح له بتجهيز جيش قوي يطبق على القائد المقدوني من الخلف، لكن ذلك لم يحصل، لأن الإسكندر استخدم خبراته في حصار صور بقصف التحصينات البرية للمدينة من البحر. وبعد ثلاث محاولات فاشلة، قبل وصول الأبراج والمنصات من صور، خرق جيش الإسكندر الحصار واقتحم مدينة غزة، فانفتح أمامه الطريق الى مصر واسعًا.
المؤرخ الروماني كوينتوس روفوس، وقد كتب أيضًا في القرن الأول للميلاد، (في كتابه بعنوان “الكتب الباقية عن تاريخ الإسكندر المقدوني الكبير”، يقول: “إنَّ الإسكندر، بقتله الجنرال الفارسي “بتيس”، أراد أن يقلد معاملة “أخيل” للبطل المهزوم “هكتور”، كما في إلياذة هوميروس!
عندما دخل الإسكندر الى مدينة غزة، حسب المؤرخ روفوس، قتل جميع الذكور من سكان المدينة، وأرسل جميع نساء وأطفال المدينة الى البيع كعبيد في سوق النخاسة. (ولنا أن نتخيَّل كم أنَّ غزة سيئة الحظ لجوارها مع مصر، ولمعاناتها من الصراع بين الفرس والغرب)!
أما في المعارك، بعد اختراق الحصار، فقد سقط من الغزيين نحو عشرة آلاف قتيل. ويصف المؤرخ روفوس، طريقة إعدام القائد الفارسي “بتيس”، على طريقة “أخيل”، بقوله إنَّ المقدونيين ثقبوا رجليه من الكعبين بين العظم والوتر وأدخلوا فيهما حبلًا ربطوه بعربة مسرعة سحلته على الأرض الى أن مات!
بإزالته غزة، أزال الإسكندر العائق الأخير بينه وبين مصر، من غير أن يخشى انقطاع خط إمداداته من الشمال.
*****
قبل سنة من حصار صور، أي في العام 333 ق.م، (في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من تلك السنة)، تقابل الجيشان المقدوني والفارسي، بقيادة الإسكندر من جانب، وبقيادة داريوس الثالث من الجهة المقابلة في معركة “إيسوس”، (مدينة “إيسوس” القديمة تقع في السهل الساحلي لتركيا الحالية في مقاطعة “هاتاي” على الحدود السورية)، حيث انتصر جيش الإسكندر، فتراجع داريوس إلى بابل ليلتحق بجيشه هناك، وأكبر غنيمة كانت للإسكندر في تلك المعركة، أنه أسر عائلة داريوس المباشرة، المؤلفة من زوجته ووالدته وابنتيه، مما حمل الملك الفارسي على مكاتبة الإسكندر محاولًا التفاهم معه ديبلوماسيا. بالإضافة الى استيلائه على المناطق الفارسية في آسيا الصغرى، التي تشكل معظم أراضي تركيا الحالية.
كانت تلك معركة مشهودة كتبت بداية نهاية الدولة الفارسية، لأنها كانت حاسمة، وهي أول هزيمة تلحق بالجيش الفارسي وهو بقيادة الملك شخصيًا. وفوق ذلك، هرب داريوس بعدما تيقّن من انهزام جيشه.
يُجمع المؤرخون على أنَّ داريوس كتب الى الإسكندر ثلاث رسائل، كل واحدة منها تتضمّن عرضًا أرفع قيمة من سابقه.
الرسالة الأولى كانت رسالة مجاملة من داريوس قال فيها للإسكندر: “كانت هناك علاقة صداقة وتحالف بين والدكم الملك فيليب وملكنا ارتحششتا، لكن عندما صعد آر سيس ابن ارتحششتا الى العرش، كان فيليب هو المعتدي عليه، مع أنه لم يلحقه أي أذى من الفرس. لكن منذ توليَّ العرش، لم ترسلوا أي مبعوث لنا لتأكيد الصداقة القديمة والتحالف الذي تبعها، بل عبرتم بجيشكم الى آسيا وألحقتم بالفرس أذى كبيرًا”.
ردَّ الإسكندر على هذه الرسالة بقوله الى داريوس: “أسلافك غزوا مقدونيا، وبقية بلاد الإغريق، وألحقتم بنا أذى كبيرًا مع أننا لم نُلحق بكم أي ضرر. أنا عُينت قائدًا أعلى لليونانيين، وهدفي من العبور الى آسيا هو معاقبة الفرس، لأنكم أنتم البادئون بالعدوان”.
ثم عدَّد الإسكندر تلك الاعتداءات الفارسية بقوله: “دعمتم أهل بيرينثوس الذين أضروا بوالدي، وأرسلتم قوة الى “تراقيا” التي كانت تحت حكمنا. وقد توفي والدي على أيدي متآمرين حرضتموهم أنتم، كما تباهيتَ، في رسائلك بأنك أنت الذي قتلت آر سيس، ووصلت إلى العرش بطرق غير سويَّة، خلافاً للعادات الفارسية، وفيها إساءة للفرس، كما بعثت برسائل كثيرة إلى اليونانيين تُحرَّضهم ضدي، وتدفعهم إلى محاربتي. وبعثت بأموال الى أهل اسبارطة وغيرهم من اليونانيين، فلم تقبل أي مدينة يونانية أموالكم باستثناء اسبارطة. وقد حاول مبعوثوكم إفساد أصدقائي، وحاولتم تقويض السلام الذي أقمته بين اليونانيين، ولذا قدتُ هذه الحملة ضدكم، لأنكم أنتم البادئون بالنزاع”.
واسترسل الإسكندر في رسالته الشديدة اللهجة الى داريوس الثالث بالقول: “أما الآن وقد هزمت في البداية قادة جيشك وحكام ولاياتك، هزمتك شخصيًا مع جيشك، وبفضل الآلهة سوف أسيطر على بلادكم كلها. كلُّ الذين حاربوا إلى جانبك، ونجوا من الموت انضموا اليَّ بإرادتهم من غير إكراه، بل انخرطوا في الحملة ضدكم بإرادتهم الحرَّة”.
ثم راح الإسكندر يملي شروطه على داريوس بقوله: “بعد الآن خاطبني على أنني سيد آسيا كلها. وإذا كنت تخشى من الأذى للمجيء إليَّ بشخصك، فابعث ببعض أصدقائك لتلقي التطمينات اللازمة. تعال اليَّ بشخصك لتطلب مني إطلاق والدتك، وزوجتك، وأولادك، وأي شيء آخر ترغبه، وأي شيْ تستطيع إقناعي به سيكون لك”.
المعروف عن معركة “إيسوس”، أنَّ الملك داريوس، عندما انهزم جيشه أمام الإسكندر، فرَّ من المعركة هاربًا، تاركًا خلفه والدته وزوجته وابنتيه، فوقعن جميعًا في يد القائد المقدوني، وكان ذلك من الأسباب الجوهرية لهذه المراسلة.
ختم الإسكندر جوابه، بقوله للملك الفارسي: “عندما تتواصل معي في المستقبل، فليكن ذلك بصفتي ملك آسيا. لا تكتب لي كأننا على قدم المساواة، بل أعرض مطالبك الى سيد جميع ممتلكاتك، وإلّا سوف أتعامل معك على أنك مخطئ. أما إذا كنت مصرًّا على لقبك كملك، فقف ثابتًا وقاتل من أجله. فلا تهرب لأنني سوف أطاردك الى أي مكان تذهب إليه”!
*****
في العرض الثاني، طالب داريوس الإسكندر بإطلاق سراح والدته، وزوجته، وابنتيه، وخدمهم ومرافقيهم، لقاء مبلغ من المال قدره 500 وزنة من الفضة (نحو 13 ألف كيلوغرام من الفضة بمكاييل هذا الزمان)، بالإضافة الى منطقة آسيا الصغرى اللصيقة باليونان (تركيا الحالية). هذا العرض أهمله الإسكندر ولم يرد عليه.
أما العرض الثالث، فقد وجد الإسكندر من الضروري عقد مجلس عسكري لمناقشته، لأنه انطوى على بنود جديدة، أراد أن يستمزج آراء جنرالاته فيها، خصوصًا قدامى المحاربين منهم في أيام والده. وقد انطوى العرض الثالث على ما يلي: يُرفع المبلغ النقدي عشرين ضعفًا من 500 وزنة فضة الى عشرة آلاف وزنة (أي ما يعادل 260 طنًا حيث كل وزنة تساوي 26 كيلوغرامًا بالمكاييل الحديثة)، ويعطيه كل البلدان التي احتلها إلى الغرب من الفرات، أي تركيا، وجُزء من سوريا، وجُزء من العراق، والساحل الفينيقي (لبنان)، وفلسطين، ومصر. وفوق ذلك، عرض عليه أن يصاهره بتزويجه ابنته، فتصبح بينهما قرابة دم!
لم يفاجأ الإسكندر، وهو يستمزج الآراء، بأنَّ القادة القدامى أعربوا عن ميلهم الى قبول عرض الملك الفارسي. فقد وقف الجنرال بارمينيو يتحدث ناطقًا باسم العسكريين القدامى في جيش أبيه، من الوجهة الاستراتيجية، قائلًا إنه لا يحبذ المواجهة مع الجيش الفارسي في سهول سوريا والعراق المكشوفة، لأنها أنسب لجيش الخيالة الفارسي ورماته، حيث السهول المنبسطة تسهل عليهم استغلال تفوقهم العددي في مجال واسع للمناورة، وأشار بكلام ملطَّف إلى أنَّ اليونانيين لا يعرفون الكثير عن الوضع في بابل، لأنه قد يكون مشابهاً لمصر، ما يُغري الملك الإسكندر بترفيع عسكريين من أهل البلد، وكأنهم من “الرفاق”!
كان ذلك الاجتماع أول إشارة على وجود تباين بين القادة القدامى في جيشه وبين “الرفاق” الجدد. لم يفت ذلك على الإسكندر، الذي ردَّ على كلمة الجنرال بارمينيو اللطيفة اللهجة، بكلامٍ حادٍّ ومهين، قائلًا له: “لو كنتُ بارمينيو لقبلت العرض الفارسي، لكن بما أنني الإسكندر فسوف أرفضه. أما الزواج فهو شأني الخاص وأنا لا أرغب في اتخاذ زوجة فارسية. وأما الأسرى الفرس فهم ملكي الشخصي ولن أقبل بإطلاقهم مقابل عشرة آلاف وزنة”!
في الختام قرر الإسكندر أن يدعو داريوس الى الاستسلام، أو سوف يطارده الى أن يقتله أو يأسره!
*****
أخذ الإسكندر، مع ذلك، بالتحليل الاستراتيجي لقدامى الجنرالات، من حيث أخطار المواجهة في ميدان مفتوح، فراح يستدرج الجيش الفارسي إلى المرتفعات الشمالية في العراق، حيث حركة الخيالة ستكون بطيئة بالضرورة، وحيث علف الخيول شحيح. وهكذا ضرب الإسكندر الملك الفارسي داريوس الثالث الضربة القاضية في معركة “أربيل”، في العام 331 ق.م. وهذه المرة أيضًا هرب الملك داريوس شرقًا ليحاول جمع جيش جديد يواجه به الإسكندر، لكن “بيسوس”، كبير جنرالات جيشه، خانه وقتله في العام التالي 330 ق.م. وقد وجد الإسكندر جثة الملك الفارسي، فتعامل معه باحترام وإكرام، إذ أقام له جنازة ملكية رسمية، رفعت منزلته لدى الشعب الفارسي، فكسب إعجابهم ودعمهم أيضًا.
لكن موضوع جعل الحدود على نهر الفرات، كان خيار الجمهورية الرومانية بعد توسعها الى إمبراطورية شملت اليونان، وآسيا الصغرى، وسوريا ومصر، على قاعدة احتواء إيران بعزلها عن سوريا، بدلًا من خوض حروب مكلفة للسيطرة عليها. وهذا ما سنعرضه في الحلقة المقبلة، مع التحليل الروماني للتعاطي مع إيران، وهو تحليل ما زال ساريًا إلى اليوم، من حيث عزل إيران عن سوريا.
(الحلقة المقبلة يوم الأربعاء المقبل: احتواء إيران بعزلها عن سوريا“).
إشكالية السلم والحرب بين إيران والغرب (9)
حروبُ السلام! ترامب للعالم: “سبحاني … ما أعظم شاني”
“السيرك” الذي أقامه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على مسرح الكنيست الإسرائيلي ثم في قمة شرم الشيخ، يحكي الكثير عن الحالة البائسة التي وصل اليها العالم، خلال الفترة الممتدة من الحرب العالمية الأولى إلى اليوم. وقد لا يكون من المصادفات أنه في خلال هذه الفترة تحديدًا، انطلق وتنفَّذ مشروع إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وما أسفرت عنه من حروب ومجازر واضطراب مستدام في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، وفي العالم الأوسع.
كان لافتًا، وليس مفاجئًا، ما جاء في الخطاب الإسرائيلي وفي الخطاب الأميركي على مسرح ذلك “السيرك” في الكنيست الإسرائيلي، سواء لجهة استحضار التاريخ الفارسي القديم من قبل الجانب الإسرائيلي، ولجهة الدور الأميركي المعاصر الذي ساوى، أو بزَّ، أفضال الملك الفارسي قورش، مؤسس الدولة الإخمينية قبل نحو 2600 سنة، على اليهود المأسورين في السبي البابلي.
دونالد ترامب، حسب الخطاب الإسرائيلي، لم يقف في الكنيست بصفته “رئيسًا أميركيًا آخر”، بل بصفته “من عمالقة التاريخ، الذين لا ينساهم الشعب اليهودي”. وضعوه في صف واحد مع الملك الفارسي قورش، وبينهما آلاف السنين!
لكن خطاب ترامب كان أكثر واقعية عندما أعلن أنه أعطى نتنياهو من الأسلحة كلَّ ما طلبه، وقد “استخدمها بيبي جيدًا” (في تدمير غزة وشعبها)، ومنها أسلحة لم يكن هو، كما قال، قد سمع بها أو عرف عنها شيئًا!
هذا في، رأيه، هو ما صنع “السلام” على يده. أي أنَّ “السلام” لا يتحقق إلّاَ بالقوة المفرطة، القوة الغاشمة العمياء، إلى حدِّ الإبادة الجماعية.
كأن ترامب قال ما قال، ليوحي بأنَّ جميعَ الحروب العدوانية التي قامت بها إسرائيل، ضدَّ الفلسطينيين والعرب، بدعمٍ مُطلَق من الولايات المتحدة، ليس لها من هدف سوى “السلام”. أي السلام عن طريق القوة!
لكن الحروب، كل الحروب التي نشبت في العالم، لم تكن قطُّ من أجل السلام، بل من أجل الغزو والسيطرة والاستيلاء على أراضي وثروات الآخرين. ليست هناك حروبٌ من أجل السلام بالمطلق.
لا أحد يعرف ذلك مثل المؤرّخين الأميركيين، الذين عاصروا الحروب التوسُّعية للولايات المتحدة، باسم توطيد السلام وإشاعة الديموقراطية!
بالمقابل، فإنَّ التعريف الحقيقي للسلام، هو الذي نادى به الرئيس المكسيكي بنيتو خواريز في القرن التاسع عشر (1806–1872)، يوم كانت جيوش الولايات المتحدة تقضم أراضي المكسيك من كاليفورنيا، الى تكساس، ونيو مكسيكو، حيث قال في دحض “السلام الأميركي” (القائم على القوة بشكل لازم): “السلامُ هو احترامُ حقوقِ الآخرين”، وبالتالي فإنَّ أيَّ سلامٍ غير ذلك يدخل في “باب الحرب”، سافرةً كانت أو مقنَّعة.
*****
في اليوم التالي لسيرك ترامب في شرم الشيخ، نشرت جريدة “غارديان” البريطانية ما قاله ترامب للقادة والزعماء الذين اصطفّوا لتحيته، وهو واقف على المسرح منفردًا، يصافحهم واحدًا واحدًا، واختارت أن تنشر في عنوانها الرئيسي عبارة نطق بها “حاكم العالم”، قال فيها:” أنا هو الشخص الوحيد، صاحب الشأن، الذي له معنى”!
لو كان محرر جريدة “غارديان”، مُلمًّا بالتراث العربي والإسلامي، لاختصر العنوان بكلمتين، باستحضار قول الحلّاج عن نفسه: “سبحاني ما أعظم شاني”!
طبعًا له أن يقول ذلك، طالما أنَّ الإسرائيليين جعلوه في مقام الملك الفارسي قورش. هو أراد من ذلك أن يُبيِّنَ الفرق الشاسع بين مقامه ومقام الذين أمامه ووراءه من الرؤساء. لكن ذلك يعطي صورة زائفة عن واقع الحال، حيث جاء ليصنع السلام في الشرق الأوسط، بينما حكومة بلاده معطلة منذ نحو شهر!
حديث الرئيس الأميركي عن القنابل والأسلحة المدمرة التي أمر بإعطائها الى نتنياهو، ليست الدليل الوحيد على يقينه بأنَّ الحرب، أو على الأصح، القوة المفرطة، هي طريق السلام. فقد سبق له أن أمرَ بتغيير اسم “وزارة الدفاع” في بلاده الى “وزارة الحرب”، وهذا ما لم يفعله الإسرائيليون حتى الآن، ولو انهم مارسوه على أرض الواقع بأفظع ما يكون. وآخر دليل على الإطار “الحربي” للسلام، الذي يقوم ترامب بتظهيره في هذه الأيام، الأمر الذي أصدره بصرف رواتب العسكريين فقط، فيما رواتب كل العاملين الآخرين في الدولة متوقفة بسبب تعطُّل الحكومة المشار إليه!
أمّا الدليل الأوضح على خطأ القول بأنَّ القوة العسكرية هي طريقُ السلام، فهو في كتب التاريخ من أيام هيرودوتس، المؤرخ الأول (الملقب بأنه “أبو التاريخ”)، إلى اليوم، وخصوصًا في الكتاب الذي وضعه المؤرخ الإغريقي ثوكيديدس عن “حرب البيلوبونيز” (431 ق.م–404 ق.م)، وهي الحرب الأهلية التي نشبت بين أثينا وحلفائها، واسبارطة وحلفائها، بعد نحو خمسين سنة من دحر الأثينيين، بقوتهم البحرية، الأسطول الفارسي في معركة “سلاميس”، وقال في مقدمته إنه “كتبه لجميع الأزمنة”.
كل ما كانوا يسمونه “سلام” من بداية التاريخ البشري ما هو إلّا عبارة عن “هدنة مؤقتة بين حربين”. وما كان أي “سلام” منها قائمًا على “احترام حقوق الآخرين”، بل على العكس تمامًا، فما كانت حربٌ إلاَّ اعتداءً على حقوق الآخرين، أو لرد مثل هذا الاعتداء.
أو على الأصح، هو “هدنة خادعة” في ثوبِ “سلامٍ كاذب”!
هذا ما أكده ثوكيديدس بقوله: “كل معاهدة سلام لها صلاحية زمنية مهما طالت. هي مجردُّ هدنة بين حربين: الحرب التي مضت، والحرب المتوقع لها أن تُستأنف”!
*****
ما قاله ترامب خلال وقوفه على منبر الكنيست الإسرائيلي، وعلى منصة قمة شرم الشيخ، ينبىء بمفهومٍ مشوَّه للسلام، يتعدّى مفهوم السلام بالغصب. ويتّضح ذلك من نقيض هذا المفهوم للطرف المغبون، في حالِ رفضِ ذلك الطرف لسلام القوة، لأنه يُكرِّس الغُبن. إذ إنَّ هذا المفهوم يحمل تهديدًا صريحًا بحربٍ لا نهاية لها، لمجرد شعوره بالتفوُّق على الأعداء الظاهرين والمحتملين.
خطورة الاعتداد بالتفوُّق أنه يحمل الطرف الأضعف على الشعور بالهزيمة مسبقًا، بسبب فداحة الأثمان التي سيتكبّدها من خلال الاستمرار في الحرب أو المقاومة. وقد بيَّن المؤرخ ثوكيديدس هذه النقطة، من خلال عرضه لانتشار مرض الطاعون في أثينا، مباشرةً بعد خطبة رثاء القائد الأثيني بيركليس. ويرى بعض المعلقين والدارسين، أنَّ المؤرخ الإغريقي تعمَّد ذلك، ليُذكِّر العالم بأنَّ هناك حدودًا لقدرة البشر على التحمُّل، ولتضحياتهم المفترض أنها للصالح العام.
هذا ما أكده أيضًا المفكر الاستراتيجي الألماني كارل فون كلاوزفيتز، في العصور والحروب الحديثة، من أنَّ التضحيات المطلوبة في زمن الحرب، “يمكن أن تتجاوزَ نقطة التحمُّل الاجتماعي”.
تطرق ثوكيديدس أيضًا إلى موضوع “القوى التوسعية” التي ترفض إقامة السلام إلّاَ باستسلام الطرف الآخر لشروطها. وحيث تدعو الحاجة، أو تسنح له الفرصة، لوقف توسُّعه أو استئنافه، ينشأ مناخٌ من الخوف والرعب لدى قوى أخرى غير معنيَّة بالصراع، ما يستدعي تدخُّل تلك القوى لوضع حدٍّ لهذا التمادي. وكان من المكن تفسير تدخُّل ترامب في هذا السياق، لو لم يكن في الأصل منخرطًا في التوسّعية الإسرائيلية المانعة للسلام الحقيقي القائم على الاعتراف بحقوق الفلسطينيين.
إنَّ هذا التصوُّر، يصحُّ في حال أنَّ الطرف الثالث، غيرُ معني بالصراع ويخشى أن ينجرَّ اليه. لكن الولايات المتحدة التي يمثلها ترامب، بل يدّعي حصرية تمثيله لها، بشتم من سبقه من الرؤساء والمنافسين على كل المنابر، في الداخل والخارج، ليس طرفًا محايدًا ليستوفي الشرط الذي وضعه المؤرخ الإغريقي، بأن وَضْعَ الحدِّ للطرف المتمادي في حرب التوسع، عن طريق القوة والتفوق العسكري، يقتضي “قلب نظامه إذا لزم الأمر، وإقامة وضع في مكانه أقل خطرًا وتهديدًا”. أما ما يجري الآن فهو قلب أنظمة المعتدى عليهم، والمطالبة بنزع سلاحهم، وتفكيك أنظمتهم، واغتيال قادتهم، وحملهم بالقوة على التخلي عن حقوقهم في أرضهم!
بأيِّ مقياس قيس مفهوم “الحرب من أجل السلام، أو الاستعدادات لها”، فإنَّ النتيجة لا تُحقِّق سوى الحرب. لأنَّ “الحرب من أجل السلام”، من هذه الناحية، هي مثل الحرب من أجل التوسع، لأنَّ “السلام” بالقوة يعني إلزام الطرف الأضعف بالتنازل عن حقوقه، خلافًا لتعريف السلام الحقيقي، الذي نادى به الرئيس المكسيكي خواريز، قبل نخو قرنين من الزمان، بأنه لا يقوم إلّاَ بالاعتراف بحقوق الآخرين، بصرف النظر عن موازين القوة.
*****
الفيلسوف البريطاني في القرن السابع عشر، توماس هوبز، كان أول من ترجم كتاب ثوكيديدس عن “حرب البيلوبينيز”، من اليونانية الى الإنكليزية، ونشره في العام 1629م، في بداية عهد الملك تشارلز الأول (الذي جرى إعدامه لاحقًا في ثورة كرومويل). ومع أنَّ المؤرّخ الإغريقي وضع مقدمة لكتابه، أعلن فيها أنه “وضع كتابه لجميع الأزمنة”، فإنَّ الفيلسوف البريطاني هوبز، وضع هو الآخر مقدمة لذات الكتاب المترجم، ليبرهن “أنَّ الحالة الطبيعية للجنس البشري هي حالة الحرب”!
ما من شك في أن هوبز أقدمَ على ترجمة كتاب ثوكيديدس، لإعجابه به، وتقديمه على أيِّ مؤرّخٍ آخر، بمن فيهم هيرودوتس (أبو التاريخ). فقد قال هوبز عن ثوكيديدس: “هو بين المؤرخين مثل هوميروس بين الشعراء، ومثل ديموسثينيس بين الخطباء، ومثل أرسطو بين الفلاسفة”. وقد صدرت طبعات عدة من ترجمة هوبز هذه، بعد الطبعة الأولى المذكورة أعلاه، (في العام 1629م)، واحدة في العام 1634م، وثالثة في العام 1648. وقد فكّر هوبز في أواخر حياته عام 1676م أن يُصدِرَ طبعةً جديدة، لكن الوقت فاته بوفاته!
بصرف النظر عن تفاصيل الحرب، ونصوص معاهدات السلام التي تليها، فقد أكدَّ المؤرّخ الإغريقي ثوكيديدس، أنَّ كلَّ معاهدة سلام، أيًّا كان مضمونها، لها صلاحية زمنية مهما طالت مدتها. هي مجردُّ “هدنةٍ بين حربين”، الحرب التي مضت، والحرب المتوقع لها أن تنشبَ من جديد.
أما هيرودوتس، المؤرّخ الأول، فقد كتب التاريخ على شكل حكايات سمعها في تجواله في بلاد الإغريق، وفي مصر، وبلاد فارس، بينما ثوكيديدس من بعده، كتب التاريخ بموضوعية نقدية مجرَّدة، حتى يمكن القول بأنه أول صحافي ميداني في التاريخ، لأنه كان شاهد عيان على “حرب البيلوبينيز”، وعرف قادتها وأقطابها، وآراء مواطنيه الأثينيين فيهم، وفي مجريات الحرب.
يمكن، في المقابل، مقارنة أسلوب هيرودوتس القائم على الأمثال الشعبية الدارجة، السماعية المصدر، مع أسلوب ثوكيديدس العلمي القائم على المعلومات وتحليلها، من خلال مثال واحد أورده هيرودوتس، وفيه يقول: “في السلم الأبناء يدفنون آباءهم، وفي الحرب الآباء يدفنون أبناءهم”.
هذا الكلام المبسَّط، يُذكّرني بخطبة لأحد مشايخ الدين يرثي فيها والد أحد الوجهاء في لبنان، بعد توقُّف الحرب الأهلية بما انتهت إليه في “سلام الطائف”، حيث خاطبه بقوله: “الحمد لله الذي أعزَّك بوقوفك على قبره، ولم يُذِلَّهُ بوقوفه على قبرك”!
*****
في “حروب السلام المزعوم”، تلفيقات سببية كثيرة، لكن تبقى فيها شذرات تدلُّ على “المنزلة الأخلاقية” للأطراف المتحاربة. بل إن التلفيقَ يصل أحيانًا الى حدِّ ادعاء الطرف الأقوى المعتدي بأنَّ له المنزلة العليا أخلاقيًا. وهذا ما دأبت عليه إسرائيل في جميع حروبها، النظامية وغير النظامية، بمساعدة جوقة إعلاميَّة عالمية. لكنها بسبب استخدامها قوة الإبادة المفرطة ضد الفلسطينيين في غزة، ولمدة سنتين كاملتين، فقدت منزلتها الأخلاقية في نظر الرأي العام العالمي قاطبةً. فلم تعد شعوب العالم تنظر الى إسرائيل على أنها في المركز الأخلاقي الأعلى، وهذا من نوع الكسور التي لا تُجبر.
حتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أشار الى ذلك إشارة بعيدة وغامضة، في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي، حيث قال: “إنه من المستحيل أن تغلب العالم، إن العالمَ شيءٌ قويٌّ”.
على أنَّ في هذا الكلام مخالفة عقائدية صريحة لتعاليم السيد المسيح، الذي أعلن لتلاميذه خلاصة مجيئه المظفر بقوله لهم: “ثقوا أني قد غلبتُ العالم”. المهم أن يعرف كلُّ واحدٍ أي عالم يقصد. فإذا كان المقصود هو النظام العالمي الروماني، فإنه ينطبق حاليًا على النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث لدولة إسرائيل فيه مركز الصدارة.
إنَّ ما قاله ترامب من ناقضٍ ومنقوض، في مسألة السلم والحرب، لم يستطع أن يُخفي حقيقة حروب إسرائيل من حيث كونها “حروبًا محميَّة”، بل هو فاخر بحماية أميركا لحروب إسرائيل المستمرة من عشرات السنين، وتمكينها من الغلبة على جميع جيرانها مجتمعين ومتفرّقين، بما في ذلك تغطيتها لحرب الإبادة في غزة على مدى سنتين كاملتين.
*****
في الحرب الأهلية اليونانية بين أثينا واسبارطة، قامت الدولة الفارسية الإخمينية بالتدخل في تلك الحرب بهدف تدمير أثينا، لأنها هزمت الأسطول الفارسي الجبَّار في معركة “سلاميس” (عام 480 قبل الميلاد). لكن التدخّل الفارسي في تلك الحرب لم يكن عسكريًا، لأن أثينا كانت محصَّنة من جهة البر، وتتمتع بحريَّة الحركة من جهة البحر، بل دعمت المجهود الحربي للطرف المحارب لها، بدفع أموال نقدية لمدينة اسبارطة وحلفائها.
كان ملك الدولة الإخمينية الفارسية في ذلك الوقت داريوس الثاني، الذي توفي في الوقت الذي انتهت فيه الحرب الأهلية اليونانية لصالح حلفاء الملك الفارسي (404 قبل الميلاد). وبعد وفاته خلفه ابنه ارتحششتا الثاني، فلقي معارضة من شقيقه قورش الثاني، الذي استعان بجيش من اليونانيين المرتزقة قوامه عشرة آلاف مقاتل، معظمهم من جنود اسبارطة المشهورين بمهارتهم القتالية، وعُرف في التاريخ باسم “العشرة آلاف”.
نجح “العشرة آلاف” في المعركة الميدانية لصالح مستخدمهم قورش الثاني، لكنه قُتل في المعركة الأخيرة التي انتصر فيها، فوقع المحاربون اليونانيون المرتزقة في حيرة من أمرهم، حيث خدعهم بعض زعماء القبائل الفارسية، عارضين عليهم إرشادهم للعودة الى بلادهم، لكنهم قتلوا قادتهم غدرًا، مما جعل هؤلاء المقاتلين العشرة آلاف ينتخبون الباحث الأثيني المشهور سينوفون، تلميذ سقراط، قائدًا لهم. وكان سينوفون قد انخرط في الحملة كمراقب ومساعد. وبقيادته شق “العشرة آلاف” طريقهم عبر إيران، وهم يقاتلون كل من اعترضهم من القبائل الفارسية، في رحلة استمرت سنة كاملة، نجحوا خلالها في العودة الى بلادهم سالمين.
دوَّن سينوفون ذلك التراجع القتالي المشهود في كتاب له بعنوان “المسيرة الكبرى” (أناباسيس). وقد وضع عددًا من الكتب الشيّقة وجدت كلها سالمة، منها كتاب مهم بعنوان “تاريخ زماني”، وهو مرجعٌ وافٍ عن الحقبة الفارسية في بلاد الإغريق.
أما التحوُّل الكبير الذي كتب نهاية الدولة الإخمينية في بلاد فارس، فهو ظهور الدولة المقدونية في بلاد الإغريق، كقوة عظمى في الغرب، بقيادة الملك فيليب وابنه الاسكندر (ذو القرنين)، الذي أسقط الدولة الإخمينية في بلاد فارس، واحتل الشرق كله وصولًا إلى الهند، ومعه الحضارة الهيلينية التي تجذَّرت عميقًا في سوريا مصر.
(الحلقة المقبلة الأربعاء المقبل: “إسكندر واحد … لا إسكندران”)
إشكالية السلم والحرب بين إيران والغرب (8)
“معاهدة السلام الأبدي”
عبارة “السلام الأبدي”، كلامٌ جميلٌ على الورق. أما على الأرض، فإنها عبارةٌ مستحيلةٌ، كما ثبت في جميع مراحل التاريخ، القديم، والمتوسط، والحديث.
مع ذلك، فإنَّ الحاكِمَين الكبيرين في بلاد فارس وبلاد الروم، كسرى الأول (أنو شروان)، ويوستنيانوس الأول الكبير، في بلاد الروم، أراد كلٌّ منهما أن يكونَ السلامُ طويلًا بين الدولتين اللدودتَين، لأسبابٍ داخلية تتعلق بالإصلاح العام لوقف التدهور الناجم من الحروب المتواصلة بينهما.
لكن الواقع أثبت، بعد أقل من ثماني سنوات على توقيع “معاهدة السلام الأبدي” في العام 532م، أنَّ الشيء الأبدي هو الحروب المتواصلة. وهذا ما أكّدته أيضًا الحروب والمعاهدات الحديثة منذ بروز الولايات المتحدة كلاعبٍ أول على المسرح العالمي بعد الحرب العالمية الأولى (1914–1918)، بما يتشابه مع أوضاع الدولة الرومانية بعد أفول نجم الجمهورية، وسياسييها الكبار.
توقفت الحرب العالمية الأولى بعد دمارٍ واسع وملايين القتلى، فكان السلام القصير خلال الفترة الفاصلة بين الحربين بمثابة استراحة من أجل الاستعداد لحرب جديدة، فانطفأت فكرةُ “الحربِ التي تُنهي كل الحروب”، مثلما انطفأت فكرةُ “السلام الأبدي” التي نحن بصددها هنا، بين كسرى وقيصر، قبل 1400 سنة!
السلام الأطول الذي تحقق في التاريخ القديم هو الذي ساد نسبيًا خلال حكم الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر لمدة خمسين عامًا من حكمه الطويل، (من سنة 27 قبل الميلاد الى 14 ميلادية)، لكن بعد حربين أهليتين كبيرتين، ومتتاليتين، انتصر فيهما أغسطس قيصر، الأولى ضد قتلة راعيه يوليوس قيصر في مجلس الشيوخ في منتصف شهر آذار (مارس) من عام 44 قبل الميلاد (أغسطس قيصر هو ابن حفيدة يوليوس قيصر المغدور)، والثانية ضد مارك أنطوني وزوجته المصرية الملكة كليوباترا. وقد سميت مرحلة السلام الطويلة نسبيَّاً، خلال حكم أغسطس، “السلام الروماني” (باللاتينية: “باكس رومانا”).
والأهم من ذلك كله أنَّ عهد أغسطس قيصر شهد مولد ملك السلام، يسوع الناصري، الذي جاء من أجل سلام العالم، فنشبت باسمه حروبٌ لا تنتهي، حتى داخل الكنيسة التي حملت رايته!
أيضًا، لم يُتَح للرئيس الأميركي وودرو ويلسون، الذي لمع نجمه في “مؤتمر فيرساي للسلام” بعد الحرب العالمية الأولى، أن يُضفي على “السلام” الذي جاء إلى فيرساي من أجله، صفة “السلام الأميركي” (“باكس أميرِكانا”)، مُتَوَهِّمًا أنَّ ما قام به في ذاك المؤتمر، يؤهّله لنيل تلك الصفة، لكن ذلك لم يكنْ!
تمامًا مثل الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، يدَّعي أنه جاء ليُطفئ الحروب، طامحًا لنيل جائزة “نوبل”، فكأنه حقَّق “السلام الأبدي” الذي فات الأقدمين، لكن هذا أيضاً لم يكنْ!
ما حقَّقه ترامب في حرب غزة هو وقفٌ لإطلاق النار. لم يُنهِ حالة الحرب، حتى يُنجز أي شكل من أشكال السلام الحقيقي، ولو بصورة مؤقتة.
على أنَّ “سلام ترامب” في قطاع غزة تشوبه شائبة “التواطؤ”، لكونه طرفًا في النزاع إلى جانب إسرائيل، بما يجعل مسعاه أقرب إلى “الصفقة” منه إلى “السلام”، وهذا فنٌّ يتقنه الرئيس الأميركي، بصفته “ملك ملوك الصفقات” في الأزمنة الأخيرة!
ما يُرجح “صورة الصفقة” في “سلام ترامب”، ظهور عرَّابين وسماسرة، ظن الناس أنهم انزووا خجلًا مما اقترفوه بحق العراق والعراقيين في العام 2003، فأطلوا برؤوسهم كجوارح الطير حين تحوم حول الفريسة المحاصرة من كل جانب، وكأنها معسكر اعتقال.
المفارقة هنا، أنَّ الولايات المتحدة، بعد مضي أكثر من قرن على الحربين العالميتين الكبيرتين، وهي تخرجُ من حربٍ لتدخل في أخرى، وكأن إله الحرب الخفيِّ قد صادرها الى الأبد، لتصبحَ في مدارٍ غير المدار الذي قامت عليه.
أو لعلَّ دونالد ترامب، مثل سابقه وودرو ويلسون في القرن الماضي، لم يلحظ ما لحظه الإمبراطور يوستنيانوس، قبل 1500 سنة، من أنَّ مدرسة التجارب التاريخية، وانبلاج فجر المسيحية، قد دحضا الأمل الخرافي بأنَّ روما أقامتها الآلهة لتحكم فوق أمم الأرض. أو لعله صدَّق مقولة بعض الآباء المؤسّسين للولايات المتحدة أنهم توخّوا أن يستعيدوا تجربة جمهورية روما القديمة، من خلال تفادي أخطائها، فوقعوا في المطب!
وما زال “السلامُ الأبديُّ”… “أضغاثَ أحلام!
في الثامن من أيلول (سبتمبر) 2016، أي قبل عشر سنوات فقط، أصدرت مطبعة جامعة كامبريدج، ترجمة جديدة لمجموعة القوانين الإصلاحية التي أصدرها الإمبراطور البيزنطي يوستنيانوس في القسطنطينية، وملاحقها، بعنوان “كوديكس يوستنيانوس”، حُدد سعر بيع النسخة الواحدة منها بمبلغ 1500 جنيه إسترليني، لأنها تضم عشرات المجلدات بما يربو على 7000 صفحة. وقد شملت تلك المجموعة الهائلة من القوانين الإصلاحية جميع مناحي الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية، والثقافية، كلها بهدف ترسيخ السلام الداخلي، بين مكونات الشعب، والسلام الدائم بين الأمم.
وذلك أيضًا لم يَكُن!
*****
تبقى قصَّة الفلاسفة اليونانيين السبعة، الذين لَجَؤوا الى بلاطِ كسرى كملاذٍ آمنٍ، عبرةً رائعةً في كيفية تحقيق حصانة الفلاسفة والمفكرين، كما دوَّنها إدوارد غيبون بقلمٍ رشيقٍ، وفكرٍ عميق. ويُحْسَبُ لكسرى أنو شروان، أنه أصرَّ أن تكون حصانة الفلاسفة السبعة في بلادهم مكفولة ببند مميَّز في “معاهدة السلام الأبدي”.
كتب غيبون في موضوع الفلاسفة السبعة يقول: “سبعة أصدقاء من الفلاسفة، ديوجين، وهيرمياس، ويولاليوس، وبريسيان، ودماسكيوس، وإيزيدور، وسيمبليسيوس، انشقوا عن دين ملكهم، واتخذوا قرارًا بالبحث، في بلد أجنبي، عن حريَّةٍ حُرموا منها في بلدهم. فقد سمعوا، وصدَّقوا ساذجين، أنَّ جمهورية أفلاطون تحقَّقت في حكومة بلاد فارس المستبدَّة، وأنَّ فيها ملكًا وطنيَّا يحكمُ سعيدًا أمَّةً فاضلة. وسرعان ما اكتشفوا، بطبيعة الحال، أنَّ بلاد فارس تُشبه غيرها من بلدان العالم. وأنَّ كسرى الذي أسبغ على نفسه صفة “فيلسوف”، ما هو إلّاَ إنسانٌ مغرورٌ، شديدُ القسوةِ، وبالغُ الطموح. وأنَّ روحَ التعصُّب وانعدام التسامح سائدٌ بين رعاياه المجوس. وأنَّ النبلاء فيها متغطرسون متعجرفون، وخدَّامَ البلاط عبيدٌ خانعون. والقضاةُ طغاةٌ شطبوا العدل من وجدانهم. حيث المرتكبون والمذنبون يُفلتون من العقاب، والأبرياء غالبًا ما يُدانون بما لا يرتكبون. خيبة أمل الفلاسفة دفعتهم إلى عودة سريعة إلى وطنهم، معلنين بالفم الملآن، إنه من الأفضل لهم أن يموتوا على حدود الإمبراطورية (البيزنطية) من أن يستمتعوا بالثروة والمنافع من يد البرابرة”!
مع ذلك، أصرَّ كسرى أن يُدرج حماية الفلاسفة بندًا صريحًا في المعاهدة، ونصًّا ملزمًا في مجموعة القوانين التي كان الإمبراطور يوستنيانوس عاكفًا على تدوينها!
في الوقت ذاته، أعتق البيزنطيون قائدًا عسكريًا فارسيًا كان في الأسر، لكنه ارتدَّ عن الزرادشتية، واعتنق المسيحية. أُفرج عنه وعاد الى بلاده بموجب معاهدة “السلام الأبدي” ليلقى حتفه فيها، وقد عُرف باسمه المسيحي “الشهيد مار غريغور”!
*****
كان الإمبراطور البيزنطي بحاجةٍ ماسَّةٍ الى سلام طويل، لاعتبارَين أساسيين: أولهما برنامج عسكري طموح في الغرب، في شمال أفريقيا وإيطاليا وجنوب إسبانيا، في محاولةٍ لإعادة توحيد وإحياء الإمبراطورية الرومانية الغربية، بعد نحو قرن من سقوطها في أيدي الغزاة القوط. وثانيهما، حاجته الى تحديث وإصلاح القوانين، كما تبيَّن تاليًا من “كوديكس يوستنيانوس”.
نجح يوستنيانوس إلى حدٍّ كبير في حملته الغربية، لوجود قائد عسكري الى جانبه، هو الجنرال بليزاريوس، الذي يُعدُّ من أكبر وأنجح القادة الميدانيين في التاريخ العسكري العالمي. لكنه ما كان ليستطيع أن يفعل ذلك من غير سد الثغرات عند الحدود الشرقية للإمبراطورية، وهو ما توخاه من معاهدة السلام مع كسرى، وكان عليه أن يدفع للملك الفارسي كسرى أنو شروان مبلغًا كبيرًا من الذهب لقاء ذلك. فالسلام دائماً بحاجة الى الذهب بذريعة أو أخرى!
اللبنانيون يعرفون ذلك أكثر من غيرهم، لأنهم شاهدوه على الطبيعة في “مؤتمر الطائف” لسلامٍ أسوأ من الحرب!
العراقيون، بلغتهم الخاصة أيضًا، يقولون في مثل هذه المسائل: “يا معوَّد… ينراد لها”!
وهذا ما فهمه الرئيس الأميركي ترامب، بأنَّ “السلامَ تجارةٌ أيضًا”!
بالفعل، استطاع بليزاريوس أن يستردَّ كامل شمال أفريقيا من قوات “الفاندال” الذين استولوا على تلك المنطقة من الإمبراطورية قبل مئة سنة، وزحف إلى إيطاليا فاستعاد جنوبها إلى حضن الإمبراطورية. لكن علاقة الصداقة بين الإمبراطور يوستنيانوس، وقائد جيشه بليزاريوس، ما لبثت أن فترت وانتهت بتقاعد القائد، الذي مات حزينًا منبوذًا.
جاء في كتب السير أن سبب الفتور بينهما مناكدات نسائية بين ثيودورا زوجة الإمبراطور، وأنطونيا زوجة القائد، على القاعدة الإسلامية: “إن كيدَهُّنَّ عظيم”!
كذلك، وبالتوازي، انطلقت ورشة تحديث القوانين، وهي الورشة التي انتهت بوضع المجموعة القانونية المسماة “كوديكس يوستنيانوس”، كما مرَّ.
بذلك يمكن حصر الإنجازات الكبرى التي حققها الإمبراطور يوستنيانوس بثلاثة، هي:
أولًا، استعادة أجزاء كبيرة من المناطق التابعة سابقًا للإمبراطورية الرومانية في الغرب، شملت شمال أفريقيا كله، وأجزاء من إيطاليا، ومن جنوب إسبانيا.
ثانيًا، “معاهدة السلام الأبدي” مع الملك الفارسي كسرى أنو شروان.
ثالثًا، تدوين الإصلاحات القانونية وتحديثها في مدوَّنة سُميت “كوديكس يوستنيانوس”.
ولا ننسى طبعًا، أنَّ يوستنيانوس هو الذي شيَّد كاتدرائية “آيا صوفيا”، في القسطنطينية (إسطنبول) التي ما زالت إلى الآن من الآيات المعمارية الفريدة في العالم، حتى بعد تحويلها الى جامع إسلامي في أواخر القرن الخامس عشر، ثم إلى متحف في عهد مصطفى كمال أتاتورك في أوائل القرن العشرين.
*****
أما العمل الديبلوماسي الراقي الذي أنتج “معاهدة السلام الأبدي”، فإنه يستحقُّ أنْ يكونَ هو المؤبد الذي أخفقت المعاهدة في أن تكونه.
قبل بدء التفاوض، قام الوفد الفارسي بزيارة بروتوكولية للإمبراطور البيزنطي ليُقدّموا له هدايا الملك كسرى، فسألهم: “كيف حال أخينا بالله؟” (قاصدًا الملك كسرى). فأجابوه بأنه بخير ويبعث لكم سلامه. فردَّ عليهم قائلًا: “يُسعدنا جدًا أن يكونَ بصحة جيدة”.
يبدو أنَّ الصحة الجيدة للحاكم من مقتضيات السلام، عكس ما هو شائع بأنها من مقتضيات الحرب والطعان!
أما التفاوض على تفاصيل المعاهدة فقد قام به وفدان رسميان، مع كل منهما ستة مترجمين متمرّسين يتقنون ثلاث لغات: الفارسية، واليونانية، واللاتينية. وكان ذلك التشكيل بالغ الأهمية من أجل دقة التعابير بالمقارنة بين معانيها باللغات الثلاث السائدة في ذلك الوقت. وقد استغرقت الترجمة وقتًا طويلًا في التوصل الى النصوص النهائية.
ذلك، بالفعل، كان إنجازًا أهمَّ وأبقى من السلام الذي أريد له أن يكون أبديًا، فلم يكن.
تلك الإنجازات لم تكن سهلة. إذ إنَّ متطلبات الإصلاح الداخلي، والسعي إلى تحقيق السلم الخارجي، جعلت النظام السياسي في القسطنطينية يُسرع الخطى نحو مركزية السلطة، الأمر الذي لم يكن لمصلحة طبقة النبلاء وبعض النخب الأخرى، لكونه أبعدها عن مركز القرار.
*****
في القديم، قبل نحو أربعة قرون من المعاهدة، كانت أرمينيا أرض صراع بين الرومان والفرس، وقد تناوب عليها الفريقان. لكن في عهد الإمبراطور نيرون، في منتصف القرن الأول للميلاد، وقعت حرب مع الفرس بقيادة ملكهم فولوكاسيس، استمرَّت خمس سنوات من عام 58 الى 63 للميلاد، انتهت بتسوية حول أرمينيا لتحييدها عن الصراع بين الدولتين. وقد قضت تلك التسوية بأن يقوم الملك الفارسي بتسمية الملك الأرمني، ثم يجري تتويجه في روما على يد الإمبراطور الروماني!
“معاهدة السلام الأبدي” في القرن السادس الميلادي، أعادت إحياء هذا التقليد.
إنه أشبه ما يكون برئاسة الجمهورية اللبنانية في زمن الوصاية السورية، حيث كانت دمشق تُسمي الرئيس اللبناني، وواشنطن تُزكّيه!
صحيحٌ أنَّ أرمينيا، في وقت سابق، كانت جُزءًا من الإمبراطورية الرومانية تحت السيادة المباشرة لروما، لكنها، في الوقت ذاته، منطقة حدودية عازلة بين الفرس والروم، وبالتالي ظلت دائمًا عُرضةً للاقتسام عند احتدامِ الصدام.
المنطقة الثانية التي تم تحييدها عن الصراع الفارسي–البيزنطي بموجب المعاهدة، هي الجزيرة العربية. لكن الصراع بالوكالة ظلَّ قائمًا في جزيرة العرب بين المناذرة ذراع الفرس، والغساسنة ذراع الروم. هذه الحالة، عن طريق الأذرع الوكيلة، أنهاها كسرى الثاني (أبرويز) حفيد كسرى الأول (أنو شروان)، بقتله الحليف التاريخي المدلل للفرس في الجزيرة العربية، ملك الحيرة النعمان ابن المنذر، وإعلان سيادته المباشرة على تلك المنطقة. لكن ذلك أيضًا لم يدم، لأن عرش كسرى نفسه سقط تحت حوافر الخيول العربية بعد سنوات قليلة من هزيمته في سوريا ومصر على يد الروم البيزنطيين.
لكن تحييد الجزيرة العربية في الصراع بين الروم والفرس بدا وكأنهُ لمصلحة الفرس، لأن المزاج العام في الجزيرة العربية كان منحازًا الى الروم!
على أنَّ المناطق العازلة بين الإمبراطوريتين، هي مناطق شاسعة وتشكل كتلة كبيرة من الأرض بينهما تمتد من جبال القوقاز في الشمال إلى الصحراء العربية في الجنوب، وبينهما بلاد ما بين النهرين (بين دجلة والفرات في العراق). وتلك المناطق العازلة لم تكن رسمًا لحدود ثابتة كما هو مفهوم الحدود اليوم بموجب القوانين الدولية العصرية، بل كانت مناطق متحرّكة يجري عليها تبادل في الأراضي والسكان والحصون والمدن، حسب نتائج النزاعات العسكرية. وقد كانت مسألة نقل السكان من جهة الى أخرى بندًا أساسيَّا في “معاهدة السلام الأبدي”.
هنا أيضًا يعرف اللبنانيون أكثر من غيرهم معنى “نقل السكان”، من كل الأمكنة إلى مكان واحد، وصفه رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بقوله: “إنهم يجيئون إلى لبنان وكأنه مِكَبٌّ”. هذه كانت زلة لسان، لأن حكومته ووزير داخليته في ذلك الوقت، هما اللذان أصدرا مراسيم تجنيس مئات الألوف الذين لا يعرف اللبنانيون، ولا حكومة رفيق الحريري، من أين أتوا، ومن دقَّق في هوياتهم!
يبدو أنَّ ذلك أيضًا كان بندًا سريًا في “معاهدة العلاقات المميزة” تحت الوصاية!
إنَّ استيلاء فريق أو آخر على أراضٍ ومدنٍ في المنطقة العازلة، لم يكن من أجل التوسُّع بالحرب، ولم يكن يُحسَبُ عملًا حربيًا، إلّاَ إذا ارتأى الفريق الآخر أن يتخذ منه ذريعة لحرب كبرى، في حسابه أنه سوف ينتصر فيها فيملي شروطه على عدوه. ومن المفارقات في هذا المنحى الاستنسابي أنه كان يجري تبريره على أنه “لتوطيد السلام والعلاقات” بين الفريقين الجارين!
ما سمح بهذا “النظام”، إذا جاز التعبير، أنَّ القوتين المعنيتين بالأمر، الدولة البيزنطية والدولة الساسانية، كانتا متشابهتين ومتساويتين، فلم يكن ما بينهما صراعًا بين دولة صاعدة وأخرى متهالكة (كما يحلو لبعض المحللين اليوم أن يصفوا الوضع بين الصين وحلفائها في الشرق، وبين الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في الغرب).
*****
يبقى السؤال المُحَيِّر: هل سبق للبشرية أن عاشت بسلام؟
هذا السؤال طرحته الباحثة مارتا ليسون في “كليَّة لندن الجامعية”، في عرض لمعاهدات سلام من أقدم الأزمنة إلى اليوم نشرته في مجلة “شتيرن”، وقد حلَّت “معاهدة السلام الأبدي” بين الروم والفرس، في القرن السادس، في المرتبة الثانية من بينها، بعد “المعاهدة الحثيَّة–المصرية” في العام 1259 قبل الميلاد. ثم “سلام نورمبورغ” بين الإمبراطور شارل الخامس والبروتستانت في العام 1532م، حيث جرى لأول مرة ضمان مشترك للسلام تحت حكم القانون. يليه “سلام براغ” في العام 1866م (وقبله سلام العام 1635م) لإنهاء الصراع النمساوي–البروسي. ثم “معاهدة فرساي” في العام 1919م لإنهاء الحرب العالمية الأولى. وبعدها معاهدة السلام المصرية–الإسرائيلية في العام 1979م، وأخيرًا “اتفاقية دايتون”، لتسوية النزاع في البوسنة والهرسك في العام 1995م. والآن، يأتي “سلام شرم الشيخ” بين إسرائيل و”حماس”، على يد عرَّابها دونالد ترامب، الذي لم يتبيَّن بعد إلى ماذا يرمي وإلى أين سيصل.
لكن الباحثة ليسون، قبل استعراضها لمعاهدات السلام الواردة أعلاه، طرحت السؤال نفسه: هل سبق للبشرية أن شهدت مرحلةً من السلام المطلق؟
أجابت عنه بكلام ساخر بقولها: ربما …في وقتٍ لا علم لنا به!
ثم جزمت بعبارة “الأرجح لا”، مؤكدة أنه لا مكان للتخمين أو الافتراض من هذه الناحية.
لكن استنتاجها الأخير يبدو واقعيًا وخفيف الظل، حيث قالت: “يبدو أنَّ الحرب، صغيرة كانت أم كبيرة، تجري في دمنا… لا ليس كلنا… يكفي أن يصلَ شخصان إلى موقع المسؤولية ليجعلا حياة بني البشر بائسةً تعسة”.
والدليل القاطع على صحة هذا الكلام المشاهد المروعة التي شاهدها العالم كله في قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين، وكأنها تجري في المريخ وليس على الأرض!
(الحلقة المقبلة الأربعاء المقبل: “حروب السلام”)!
إشكالية السلم والحرب بين إيران والغرب (7)
“مقاتلُ المسيحيين”
مجازر القدس، التي سالت فيها دماءُ المسيحيين، عند دخول الجيش الفارسي إليها بقيادة كسرى الثاني (أبرويز)، في العام الميلادي 614، مُحَيِّرة للباحثين. وتفسيرها، على الأرجح، يتعلّقُ بالتقلّبات في مواقف كسرى، بسبب ما جرى له في بداية عهده، فعُزِلَ عن عرشه، ثم ما لبث أن استعاده بمساعدة الإمبراطور البيزنطي موريس.
في تقديري أنَّ كسرى غَيَّرَ رأيه بالمسيحية البيزنطية بعد مقتل الإمبراطور موريس في القسطنطينية. فقد كان المسيحيون مُقدَّمين في بلاطه، لا سيما أنَّ زوجته المفضلة، شيرين، كانت مسيحية، ولها نفوذٌ يُجمِعُ عليه المؤرّخون، ساعد على انتشار الديانة المسيحية في الدولة الساسانية، مما أثارَ حفيظة وحنق رجال الدين الزرادشتية، ممثلي الديانة الرسمية للدولة. تؤكّدُ هذا المنحى أيضًا الباحثة الأميركية المولودة في فرنسا (من أصل أرمني)، نينا غاروسيان، التي تقول إنَّ كسرى تَغيَّرَ، وعاد الى عادته السابقة، بعد مقتل راعيه الإمبراطور موريس، من حيث التناوب بين رعاية المسيحيين واضطهادهم!
لم ينتقم كسرى من المسيحية بالمطلق، أو حاول اجتثاثها، بل أخذ يشجع ويناصر المذهب النسطوري المنشق عن الأرثوذكسية البيزنطية، مع أن زوجته الثانية كانت أيضًا مسيحية، وهي أميرة بيزنطية، اسمها ماريا، (أو مريم)، شاع أنها ابنة الإمبراطور موريس، تزوّجها بعد عودته إلى عرش أبيه وجدّه، على يد الإمبراطور البيزنطي، وابنها اعتلى عرش والده، بعدما انقلب عليه وقتله، مما أدخل بلاد فارس في حربٍ أهلية، تفكّكت فيها الدولة، واستقلَّ الإقطاعيون بمناطقهم، قبل سنوات قليلة من الفتح العربي الإسلامي.
هذه القراءة لما جرى للمسيحيين في الإمبراطورية الساسانية، بعد مقتل الإمبراطور موريس، وقيام كسرى باحتلال سوريا ومصر، تُعطي تفسيرًا افتراضيًا، لقيام كسرى في العام 613م بقتل “ملك الحيرة” اللخمي، النعمان ابن المنذر، قبل سنة من دخوله إلى مدينة القدس في فلسطين، مع أنَّ “ملوك الحيرة” كانوا دائمًا حلفاءً للدولة الفارسية في صراعها التاريخي مع الدولة الرومانية، ثم البيزنطية، شأن الغساسنة في سوريا حلفاء الدولة الرومانية، ثم البيزنطية من بعدها. فقد كان كلٌّ منهما ذراعًا للدولة الراعية له، يقاتل بالنيابة عنها، خصوصًا بعد “معاهدة السلام الأبدي”، حيث انتقل الصراع بين الفرس والروم من الحرب المباشرة بينهما، إلى الحرب بالوساطة، وتحديدًا في الجزيرة العربية، حيث لم تتورّط الدولة المركزية، لا في بلاد الروم ولا في بلاد الفرس، بدخول جيوشها إلى جزيرة العرب، منذ فشل التجربة الوحيدة التي جرت في عهد أغسطس قيصر في السنة الرابعة قبل الميلاد، عندما حاول القائد الروماني غاليوس إيليوس الوصول إلى اليمن برًّا من سوريا.
الأدلة التاريخية في معظمها تؤكد أنَّ قتلَ كسرى لملك الحيرة شجَّع على انتشار المسيحية النسطورية بين العرب اللخميين في منطقة الحدود الغربية للإمبراطورية الساسانية. وهي منطقة قامت القوات الفارسية بتولي السيطرة عليها مباشرةً بعد مقتل النعمان. فليس أمرًا جديدًا، أو مستغربًا، أن تقومَ دولةٌ ما بالتخلّص من أذرعها الخارجية إذا اقتضت مصلحتها ذلك، خصوصًا إذا كان الأمرُ أقلَّ كلفة من الاستمرار في رعايتها والإنفاق عليها.!
طبعًا هناك دائمًا حكايات تُعطي الحوادث المفصليّة في التاريخ تفسيرات خيالية لا علاقة لها بالسياسة أو الحرب. ومن الحكايات التي نُسجت حول مقتل النعمان، أنَّ كسرى قتله لأنه رفض تزويجه ابنته، واسمها “الحرقة”، وهذا على الأغلب من نسج الخيال!
لكن المؤكّد، بما لا يقبل الشك، بأنَّ تلك الحادثة أضعفت الجبهة الغربية للدولة الساسانية، مما سهَّل دخول الفتح العربي الإسلامي من تلك الثغرة، تمامًا كما وصف المؤرخ البريطاني المشهور في القرن الثامن عشر، إدوارد غيبون، في كتابه الكلاسيكي “تاريخ انحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية”، من حيث رأى أنَّ إهمال الإمبراطور يوستينيانوس الكبير لدفاعات سوريا إلى الغرب من الفرات، بعد توقيعه “معاهدة السلام الأبدي” (عام 532م)، مع كسرى الأول (أنو شروان)، كان من الأسباب التي سهلت الفتح العربي الإسلامي لبلاد فارس من تلك الثغرة أيضًا.
*****
أكّد إدوارد غيبون في المجلد الخامس من كتابه المذكور: “إنَّ تحالف اليهود والمسيحيين النساطرة والمسيحيين اليعاقبة، وما أعطاه كسرى للمنشقّين من منافع جُزئية، أثار كراهية وقلق رجال الدين الكاثوليك (الأرثوذكس). وكان الفاتح الفارسي واعيًا لكراهيتهم وقلقهم، فراح يتعامل مع رعاياه الجدد بيد من حديد. وكلما كان يشعر باهتزاز الاستقرار في البلاد التي سيطر عليها، أرهق سكانها بالضرائب، وبأعمال المصادرة والسطو على ثرواتهم، وكان ينهب معابدهم أو يدمرها، وينقل المنهوبات من ذهب، وفضة، ومرمر ثمين، وفنون وفنانين، الى بلاده الموروثة”.
لذلك، فإنه ليس بالأمر السهل فصل صورة كسرى نفسه، وارتكاباته الشخصية، عن تلك التي قام بها ضباط جيشه ومعاونوه، أو حتى استبانة محاسنه الشخصية، وسط الوهج العام لمجده وعظمته!
على أنَّ مسألة المسيحيين النساطرة في العراق وجنوب بلاد فارس كان لها دورٌ أكبر بكثير من حجمها الفعلي في مستقبل الشرق الأوسط، خلال القرون التالية بعد الدولة الساسانية، التي كان لكسرى الثاني شأنٌ في تشكيلها. ويذهب بعض المؤرّخين إلى تفسير ما أقدم عليه من نقلٍ لعود الصليب الأصلي من كنيسة القيامة في القدس، فور احتلاله لها في العام 614م، إلى منطقة خوزستان في إيران، بأنه من قبيل تعزيز شرعية المذهب النسطوري المنشق عن الأرثوذكسية، بأن وضع في حوزتهم أغلى رمز في المسيحية!
إنَّ تدخُّلَ الحكام في بلاد فارس، وفي بيزنطية، خلال تلك المرحلة، بالشؤون المذهبية المسيحية، أمرٌ لا تجيب عنه بشكل مُقنع تمامًا الأسباب الشائعة. فقد قيل إنَّ كسرى منع التبشير الديني في إمبراطوريته، لكنه سمح للمسيحيين النساطرة أن يسافروا ويفتحوا كنائس لهم في الصين والهند، وساعدهم في ذلك المسعى. كذلك، الرواية الجارية عن الإمبراطور هرقل، بعد الهزيمة التي ألحقها بالدولة الساسانية الفارسية في سوريا عام 628 للميلاد، بأنه حلَّ ضيفًا على الرهبان الموارنة في دير لهم بين حماه وحمص، فأقنعوه بمذهبهم “المونوفيزي” (الطبيعة الواحدة)، فأراد أن يجعل المذهب الماروني، “الأرثوذكسية الجديدة” في الدولة البيزنطية، فاصطدم بمعارضة شديدة من أساقفة القسطنطينية.
ما يعطي هذه الرواية مصداقية تاريخية، تركيز إدوارد غيبون عليها في كتابه عن انحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية، حيث وضع المذهب الماروني بين الأسباب التي أدَّت إلى سقوط الدولة الرومانية. لكن أساقفة القسطنطينية الأرثوذكس، كان لهم سببٌ ديني – أخلاقي في معارضتهم لهرقل، لكونه تزوج من مارتينا ابنة شقيقته (وأنجب منها تسعة أولاد)، خلافًا للأصول والأعراف الاجتماعية، ولتعاليم الكنيسة. وربما كان أنه حاول اعتناق “أرثوذكسية جديدة”، بسبب تلك المعارضة من قبل أساقفة القسطنطينية!
*****
من الصعب معرفة التطوّرات القاسية التي مرَّت بها المنطقة السورية، من جرّاء الغزو المغولي الذي أودى بالدولة العباسية وبآخر خلفائها، من غير قراءة سليمة، غير منحازة، لدور المسيحيين النساطرة في إطلاق تلك التطوّرات، من خلال المفارقات التي رافقت الدور النسطوري، سواء في بلاد فارس، أو في الكنائس التي ساعدهم كسرى الثاني على نشرها في الصين والهند.
في العام 428م اختار الإمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس الثاني، الراهب الأنطاكي نسطوريوس بطريركًا على كرسي القسطنطينية، لمزايا فيه تؤهّله للمنصب، منها تقشّفه في العيش، وأهم من ذلك فصاحته في الخطاب الديني والمواعظ المُثيرة للجدل. ففي خطاب تنصيبه بحضور الإمبراطور ثيودوسيوس، قال نسطوريوس يخاطبه:
“أيها القيصر، أعطني الأرض خاليةً من الهراطقة، وأنا أعطيك ملكوت السماء عوضًا عنها. اجتثَّ معي الهراطقة، ومعك اجتث لك الفرس”!
المفارقة هنا، أنَّ النسطورية لم تعش وتزدهر إلّاَ في بلاد الفرس والعراق، وفي أقاصي آسيا، لتعود مع الغزو المغولي إلى بلاد الشام.
الصراعُ الذي خاضه نسطوريوس مع بطريرك الإسكندرية الأرثوذكسي كيريل بحجّةٍ لاهوتية، كان في الواقع بمثابة حرب أهلية داخل الجسم المسيحي. في النهاية كانت الغلبة للإسكندرية، بنوعٍ من التواطؤ بين البطريرك الاسكندري كيريل وبابا روما سلستيوس، مما حمل المجمع المسكوني في روما عام 430م على إدانة نسطوريوس وقطع الشراكة معه. وفي السنة التالية انعقد مجمع أفسوس حيث أعاد نسطوريوس تأكيد اعتراضه على تسمية مريم العذراء “والدة الإله” (ثيوتوكوس)، مُحتَجًّا بأنَّ المسيح هو قال عن نفسه إنه “ابن الانسان”، فلماذا لا تُسمَّى والدته “والدة الإنسان” (هوموتوكوس)، وهي أيضًا والدة المسيح، فلماذا لا تُسمَّى بهذا الاسم (والدة المسيح، “كريستوتوكوس”)!
الدعوى الدينية، في هذه المعمعة الكنسية، هي مجرد ذريعة، أما الدافع الحقيقي، حسب القديس الآباتي إيزيدور، الذي بقي مترفّعًا عن ذلك الصراع وما رافقه من جدليات، فهو الطموح السلطوي الدنيوي للأساقفة!
أما على المسرح السياسي في الشرق الكبير، فإنَّ الكنائس النسطورية التي تأسّست في الصين والهند من أيام كسرى الثاني، تجذَّرت هناك، وكان لأتباعها شأنٌ ملحوظٌ في تلك البلاد البعيدة. تلك الكنائس في الهند، وتسمى إلى اليوم “الكنائس السورية”، انتكست في القرن السادس عشر، على أيدي المستعمرين البرتغاليين الذين وفدوا إلى الهند والصين، ومعهم “محاكم التفتيش الكاثوليكية”، التي قمعت تلك الكنائس لكنها لم تستطع اجتثاثها، فبقيت إلى يومنا هذا.
لكن نساطرة الصين، الذين انتشروا بين المغول وتزاوجوا معهم، فقد ألَّبوا المغول وحرّضوهم على غزو الدولة العباسية، خصوصًا بعد هجرتهم الكبيرة من العراق وبلاد فارس إلى بلاد الصين في مطلع القرن التاسع الميلادي، احتجاجًا على المعاهدة التي عقدها الخليفة العباسي هارون الرشيد مع شارلمان مؤسس “الإمبراطورية الرومانية المقدسة”، في محاولةٍ لإعادة استنهاض الإمبراطورية الرومانية القديمة في الغرب. وكانت حجة النساطرة، أنهم والوا العرب المسلمين وناصروهم ضد الغرب، فإذا بخليفة المسلمين يعقد معاهدة مع الغرب، وكأنه يبتغي إقصاءهم، فهاجر منهم كثيرون احتجاجًا، وراحوا يعملون من مهجرهم لتقويض الخلافة العباسية.
عندما تقدَّمت جحافل المغول باتجاه الدولة العباسية في بلاد فارس وبلاد العرب، عام 1258م، كان في قيادتها بعض المسيحيين النساطرة، وحلفائهم في أرمينيا، وفي جورجيا، وفي أنطاكية الصليبية. فالقائد المغولي العام.، الذي احتل دمشق، “كتبغه منتاش”، كان نسطوري الأب والأم. ولم يكن كتبغه وحده الذي دخل إلى الشام، فقد رافقه إلى هناك ملك أرمينيا، هيثم الأول (الذي كان قبل ذلك قد قام بزيارة الى الخان المغولي الأكبر طُلوي ابن جنكيز خان، والد هولاكو خان، في عاصمته “قراقوروم”)، ومعه أيضًا فرقة من الجيش الجورجي، لكن ملك جورجيا لم يحضر بنفسه، إضافة إلى ملك أنطاكيا الصليبي بوهيموند السادس ومعه فرقة من جيشه. حتى ليمكن القول بأنَّ تقويضَ الدولة العباسية على أيدي الجحافل المغولية، هو مشروعٌ نسطوري بامتياز انتقامًا من هارون الرشيد ومعاهدته مع شارلمان!
بين المراجع الشرقية القليلة عن المرحلة المغولية في بلاد فارس وبلاد العرب، يُعتبر كتاب رشيد الدين فضل الله الهمداني، وعنوانه “الجامع في التاريخ”، هو المرجع الأدق. وكان كاتبه الهمداني (1247- 1318م) طبيبًا ومؤرّخًا وسياسيًّا، والأهم من ذلك أنه عاصر الغزو المغولي لبلاد فارس والأقاليم الواقعة تحت سيادة الخلافة العباسية، من بداياته، وهو فتى عمره لا يتجاوز الحادية عشرة. ولذلك تعتبر مرجعيته في الموضوع على أنها إفادة شاهد عيان.
كانت تلك أول مرَّة من 700 سنة، كما قال إدوارد غيبون في كتابه عن انحلال وسقوط الدولة الرومانية، وصل إلى حكم دمشق أربعة أمراء مسيحيين!
*****
ما هو مربكٌ في دخول كسرى إلى القدس، وما رافقها من مجازر ضد المسيحيين، الرواية القائلة بأنَّ الملك الساساني عقد اجتماعًا مع أساقفة المدينة المقدسة، قبل أن يقتلع عود الصليب من كنيسة القيامة، وقبل أن تسيل نقطة دم واحدة. إذ ليس مؤكّدًا أنَّ ذلك قد حصل، وفي حال حصوله، لا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا قال كسرى للأساقفة، وماذا قالوا له، لكن ما جرى في المدينة من مجازر بعد استباحتها، يُنبىء بأنَّ الأساقفة لم يتجاوبوا مع مطالبه، أيًّا كانت تلك المطالب، في حال كان خبرُ الاجتماع بين كسرى والأساقفة صحيحًا. لكن الثابت أنَّ القديس زكريا، بطريرك القدس في حينه (تحتفل الكنائس الشرقية والغربية بذكراه يوم 21 شباط/فبراير من كل سنة)، أُسِرَ مع عدد من الأساقفة والرهبان والراهبات، والآلاف من المسيحيين، واقتيدوا إلى بلاد فارس.
والثابت أيضًا أنَّ اليهود في العهود الرومانية، كانوا ممنوعين من دخول المدينة المقدسة منذ التمرّد اليهودي على الدولة الرومانية عام 138 للميلاد، في عهد الإمبراطور هادريان. ذلك التمرُّد، الذي قاده شيمون بن كوخبا، أربك القوات الرومانية في فلسطين، بقيادة الجنرال روفوس، وأنزل بها خسائر غير مسبوقة، مما اضطر الإمبراطور هادريان تكليف حاكم بريطانيا في ذلك الوقت، الجنرال يوليوس سكستوس ساويرس، بأن يقود الحملة ضد التمرّد اليهودي، فقمع ذلك التمرُّد بشدة وقسوة، وأنزل الدمار بالمدن والقرى اليهودية، بحيث يُقدر عدد الضحايا من المتمردين اليهود نحو 700 ألف شخص، وصلب قادة التمرد على الطرقات، ومن بينهم شيمون بن كوخبا نفسه. ومنذ ذلك الوقت، حتى الاحتلال الفارسي، أي مدة 476 سنة، لم تطأ أرض القدس قدم أي يهودي.
لكن مع قدوم الجيوش الفارسية بقيادة الجنرال شهر براز، بعد احتلال “قيصرية البحر”، العاصمة الإدارية لفلسطين الممتازة (باليستينا بريما)، شكّلَ اثنان من اليهود، هما نحميا بن هوشيل، وبنيامين الطبري، عصابات مسلحة معاونة للجيش الفارسي، قدَّر بعض المؤرخين عديدها بين 20 و30 ألفًا، سُميَ “الجيش اليهودي–الفارسي”، بهدف تحدّي قرار الدولة الرومانية بمنعهم من دخول القدس. هؤلاء على الأرجح هم الذين ارتكبوا المجازر الواسعة ضد المسيحيين، وهو الرأي الذي رجَّحه الباحث الفلسطيني عصام محمد سخنيني، في كتابه المذكور آنفًا بعنوان “مقاتل المسيحيين”.
مصداقية حجة سخنيني، يعززها شمول كتابه للمجازر ضد المسيحيين في جنوب الجزيرة العربية، على يد ذي نؤاس، الملك اليهودي الحميري في اليمن. لأنَّ وصفًا لتلك المجزرة ورد ذكره في القرآن الكريم (سورة البروج، عن “الأخدود وصاحب الأخدود”)، حيث حُفر في الأرض أخدود كبير أشعل في جوفه جمرٌ حارقٌ طُمر فيه المسيحيون الذين رفضوا الارتداد عن دينهم. واللافت أنَّ بعض الحفريات الحديثة في مدينة نجران السعودية وجوارها، وكانت في ذلك الوقت المطرانية الأولى في الجزيرة العربية، أظهرت وجود أثار لحرائق واسعة تحت الأرض، لم تُستكمل دراستها بعد!
*****
إنَّ الروايات الأدق تاريخيًا، لمجازر القدس في العام 614م، هي تلك التي وردت في مدوّنات معاصريها، أو في زمن قريب من حدوثها، وأبرزها الكتب والسير التي تناولت بطريرك الإسكندرية “القديس يوحنا المحسن”، الذي أطلق عليه لقب “المحسن”، لكثرة أعماله الخيرية التي قام بها لإيواء وتدبير شؤون عشرات الألوف من المسيحيين اللاجئين من فلسطين وسوريا في فترة الاحتلال الفارسي ومجازر القدس التي رافقته. وكذلك مدوّنات الراهب في دير مار سابا بالقرب من منطقة بيت لحم في فلسطين، واسمه أنطيوخوس ستراتيجوس، وتتضمّن أدق التفاصيل عما حلَّ بالقدس وفلسطين في تلك الفترة.
في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) 610م، بعد ثلاثة أيام فقط من تتويج هرقل إمبراطورًا في القسطنطينية، احتل كسرى الثاني العاصمة السورية أنطاكية. وبعد أسبوع احتل مدينة حماه على نهر العاصي، وهي مدينة عريقة ابتناها في العام 300 قبل الميلاد، القائد المقدوني سيلوكوس نيكاتور، الذي صار ملكاً على سوريا بعد وفاة الإسكندر الكبير، وتقسيم إمبراطوريته على قادة جيشه الكبار. وقد ازدهرت زمن الحكم اليوناني بحيث بلغ عدد سكانها في أوجها آنذاك نحو 500 ألف نسمة. لكن حماه توصلت الى اتفاق مع الملك الفارسي، لضمان سلامة المدينة وسكانها.
أما حمص فقد سقطت في أيدي الجيش الفارسي في العام 611 م، ثم سقطت دمشق في العام 613م. وفي السنة التالية 614م، سقطت فلسطين كلها، الواجهة البحرية أولًا ثم مدينة القدس حيث جرت المجزرة المهولة بحق المسيحيين، وتم خلالها تدمير عدد كبير من الأديرة والكنائس والمعالم التاريخية للمدينة.
من الثابت أنَّ أهالي مدن عديدة في سوريا هربوا إلى الخارج، معظمهم قصدوا مصر، حيث فتح البطريرك الأرثوذكسي القديس يوحنا ذراعيه للاجئين السوريين والفلسطينيين، فأقام لهم الملاجئ، والمدارس، والمشافي. ولكثرة توافد اللاجئين، كادت تحدث مجاعة في مصر، لو لم يتدارك البطريرك الأمر، ويستورد حمولة عدة سفن لرحلات متكررة، من القمح والحبوب، لإطعام رعاياه القدامى والجدد.
والشيء الأهم الذي ضغط عليه، بعد وفود اللاجئين الفلسطينيين، وما حملوه معهم من أخبارٍ سيئة حول احتجاز راهبات الأديار المسيحية بالمئات، بحيث اضطرّ أن يدفع كميات كبيرة من الذهب، كفديةٍ لإطلاق ألف راهبة، سُمح لهم تاليًا باللجوء إلى مصر.
تفاقمت المشكلة بعد سنوات قليلة، عندما عزم الجيش الفارسي على احتلال مصر، مما اضطرَّ معظم اللاجئين السوريين والفلسطينيين هناك، إلى الفرار مرة ثانية من وجه الجيش الفارسي. هذه الهجرة الثانية، توزّعت بين قبرص، وصقلية، وقرطاجة، وروما. وإلى قبرص لجأ أيضًا في العام 619م، بعد سقوط الإسكندرية، البطريرك يوحنا (القديس المحسن)، لأنَّ قبرص موطنه الأصلي ومسقط رأسه، لكنه فارق الحياة بعد أشهر قليلة من الهروب الكبير من مصر.
جاء في مدوَّنة يعقوب الرهوي: “هرب الأساقفة من المناطق الشرقية (سوريا وفلسطين)، ومعهم هرب الرهبان، وعدد كبير من السكان تبعوهم لخوفهم من الزحف الفارسي”. ويبدو أيضًا أنَّ لاجئين كثيرين وفدوا إلى مصر من مسيحيي العراق، حسب مدوّنة كاهن يدعى توما، كتبها في العام 640م، أي بعد 25 سنة من وقوع مجازر القدس.
*****
ترك اللاجئون السوريون والفلسطينيون إلى روما أثرًا كبيرًا في تاريخ المسيحية خلال تلك المرحلة، حيث أسّسوا أديارًا للرهبان السوريين، ويبدو أنَّ الرهبان الفلسطينيين لم يقطعوا الصلة مع بلدهم الأم، لأنهم تمكّنوا في ذلك الوقت من تهريب رأس الشهيد القديس أناستاسيوس الفارسي إلى روما، كما نقلوا أيضًا مخطوطًا بيد مودستوس، بطريرك القدس. ومن الذين لَجَؤوا إلى روما في ذلك الوقت أسقف فلسطيني اسمه ثيودور، (كان له ابن يحمل أيض اسم والده). وقد أصبح ثيودور الإبن بين العامين 642 و649، أول بابا شرقي على رأس الكنيسة الكاثوليكية، وهو الذي سعى إلى عقد المجمع المسكوني في العام 649م، لإدانة مذهب القائلين بالطبيعة الواحدة للمسيح!
(الحلقة المقبلة: “معاهدة السلام الأبدي”)
إشكالية السلم والحرب بين إيران والغرب (6)
“وَديعَةُ كسرى”!
“إيران فكرة”…
بهذه العبارة عَنوَنَ المؤرِّخُ والباحثُ الإيطالي جيراردو نولي، الذي فارق الحياة في العام 2012، كتابه: “فكرةُ إيران وأصلُها”. كان نولي مُتخصِّصًّا بالتاريخ الإيراني والثقافة الفارسية.
“الفكرة”، كتعبيرٍ مُجرَّد، لها شرطان: الأوّل: أن تكونَ لها هَوِيّة ثقافية داخلية، مُميّزة لشعبها، والثاني: أن تكونَ لها رسالة إنسانية للعالم الخارجي.
لكنَّ هذه “الفكرة” مُربكة للباحثين، لأنَّ اسم “إيران” لم يُعتَمَد رسميًا إلّاَ في العام 1935، ولأنَّ الاسمَ الشائع من قبل، وهو “بلاد فارس”، تعبيرٌ أطلقه الأغرابُ عليها، أو فلنقل أطلقه المؤرّخون القدامى، من خارجها. وهو الاسم الذي كانَ مُعتَمَدًا من العرب قبل الإسلام، وظلَّ ساريًا إلى قرونٍ عديدة، ومن اليونانيين، الذين كانوا أكثر الشعوب احتكاكًا بالفرس، سلبًا وإيجابًا، قبل الإسلام بأكثر من ألف سنة.
ما زادَ من التشوُّش في فَهمِ تلك “الفكرة” اعتماد الجمهورية الإسلامية الراهنة هَويَّة سياسية إضافية إلى الهويّة التاريخية التي قامت عليها إيران خلال تاريخها الطويل (الهوية الجمهورية). واللافت في الأمر، أنَّ الجمهورية الإسلامية في دستورها الجديد، أو الوحيد، (لأن الحركة الدستورية التي كانت أول حركة من نوعها في الشرق الأوسط عام 1906، أُحبِطَت ولم يرَ دستورها النور)، اعترفت بالديانة الزرادشتية القديمة، إلى جانب الإسلام، والمسيحية، واليهودية أيضًا. وبالتالي، يمكن القول بأنَّ الجمهورية الإسلامية لا تُمثّلُ افتراقًا كاملًا، أو نهائيًا، عن “الفكرة” التي استنبطها نولي في أبحاثه.
أما الإسم “إيران”، المُشتَق من الهَوِيّة التاريخية الذاتية للإيرانيين، فهو يعني، كما أُريدَ له أن يعني في العصر الحديث، “بلاد الآريين”، لا بلاد الفرس. وبهذا المعنى للفكرة، أثَّرت القوى الحاكمة، من الدولة الساسانية، الى القجارية، فالصفوية، فالخُمينية، في مضمون تلك “الفكرة”، وتأثَّرت بها أيضًا. لأنَّ كلَّ واحدةٍ من هذه الدول، التي تعاقبت على حُكمِ إيران منذ مئات السنين، أدخلت على “فكرة إيران” شيئًا من التقاليد والهَويّات الدينية، خلال المرحلة الإسلامية العربية وخلال المراحل السابقة للإسلام، للإبقاء على المفهوم التاريخي للإيرانيين لأنفسهم ولنظرة العالم الخارجي إليهم بأنهم ليسوا دولة عادية مثل باقي الدول المجاورة، بل هم “كيانٌ عالمي مُتميِّز”، مستحقٌّ لهم، ومحرومون منه. بعبارةٍ أخرى: “الحلمُ الإمبراطوري الإخميني ما زالَ ينبضُ في عروقِ الإيرانيين”.
صحيحٌ أنَّ الحُكمَ القجاري انفتحَ على العالم الخارجي في ذروةِ المدِّ الإمبريالي الأوروبي، حيث قام ناصر الدين الشاه في أواخر القرن التاسع عشر بجولةٍ خارجية على العواصم المؤثّرة في ذلك الوقت، وكذلك فعل مظفر الدين شاه في بداية القرن العشرين، شملت عاصمة الإمبراطورية الروسية آنذاك سانت بطرسبورغ، والعاصمة العثمانية إسطنبول، والعاصمة البروسية (الألمانيَّة) برلين، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البلجيكية بروكسل، في تماهٍ مُرتجى مع الغرب الأوروبي، إلّاَ أنَّ “الفكرة”، بدأت تتشكّل من بداية الدولة الساسانية على يد مؤسسها الملك أردشير الأول، وابنه الملك شاه بور، منذ الربع الأول للقرن الثالث الميلادي، حيث اعتمدا الديانة الزرادشتية، دينًا رسميًا للدولة. وقد تشكّلَ الحلم الساساني على إحياء، أو استرداد، ما بلغته الدولة الإخمينية، شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا.
أصل “الفكرة”، إذن، بدأ بتحديد هوية إيران الزرادشتية، وبآفاقها الخارجية المُتمثّلة بمحاولة استعادة امتدادها التاريخي في زمن الدولة الإخمينية. لكنها تبلورت من جديد خلال العصور الحديثة، عندما “تشيَّعت” إيران على يد الشاه إسماعيل مطلع القرن السادس عشر بقرارٍ سياسي مُلزِم بغية التميُّز عن باقي المسلمين، خصوصًا عن السلطنة العثمانية التي اتخذت لنفسها صفة “الخلافة الإسلامية”. ما يعني أنَّ “الفكرة” لا تعود “فكرة” واضحة من غير تميُّزٍ عن نظائرها إذا بقيت تحت جناح “فكرة الآخرين”، ولو كانوا يعتنقون الدين ذاته. فالتشيُّع الإيراني، بهذا المعنى، حافظ على “الفكرة” من خلال التميُّز الديني.
*****
لكن ماذا عن إيران الإسلامية منذ القرن السابع الميلادي حتى قرار التشيُّع بعد ثمانية قرون في إطارِ تلك “الفكرة”؟
الفتحُ الإسلامي حَكَمَ بلاد فارس كقوة قاهرة من الخارج، تمامًا كحُكم الإسكندر المقدوني في القرن الثالث قبل الميلاد، مع فارق ملحوظ، هو أنَّ الإسكندر لم يُحاوِل فَرضَ الثقافة الهيلينية على الفرس، بل طرح نفسه على أنه امتدادٌ للدولة الإخمينية التي قهرها، وتمازج معها. ولهذا لم تتهلّن إيران مثل سوريا ومصر، حيث كانت النظرة إلى الإسكندر هناك على أنه “مُحرِّرٌ” لهما من الحكم الفارسي.
فالحُكمُ في إيران، زمن الدولة العربية الإسلامية، كان للعرب. وبالتالي كان في منظورِ “الفكرة” حُكمًا أجنبيًا، يُدارُ من المركز العربي الخارجي: من دمشق أيام الدولة الأموية، ومن بغداد أيام الدولة العباسية، حتى الغزو المغولي في أواسط القرن الثالث عشر الميلادي. واللافت، أنَّ إيران تحت الحكم العربي الإسلامي الطويل لم تتعرَّب ثقافيًا، بل كانت هناك مقاومة فارسية للتعريب. ويعتبرُ بعضُ المؤرّخين أنَّ أبا القاسم الفردوسي وضع كتاب “الشاهنامه”، (أي كتاب “سِيَّر الملوك”) بالفارسية، مُتعمّدًا إعلان التمسّك باللغة الأم، كهويةٍ مُميّزة، خصوصًا أنها تركزُ على أساطير الفرس قبل الإسلام. فقد كتبها الفردوسي شعرًا، وهي تُعدُّ في الأدب العالمي أطول ملحمة شعرية من أيِّ نظيرٍ لها في العالم. بل يمكن القول بأنه أراد أن يتفوَّقَ فيها على كتاب الإمام الطبري بالعربية بعنوان “تاريخ الرُسُل والملوك” الذي صدر قبل “الشاهنامه” بسنواتٍ قليلة. وهذا أيضًا بخلاف ما حدث في سوريا ومصر، حيثُ اكتسحت اللغة العربية ما قبلها، وأزالته من الوجود… وما رسَّخ هذا الانطباع، أنَّ كتاب الطبري لم يُترجم إلى الفارسية إلّاَ بعد خمسين سنة من نشره، أي مع بداية القرن العاشر الميلادي (حوالي 390 هجريَّة).
قَبِلَ الإيرانيون الإسلام كأمرٍ واقع، لكنهم لم يستعربوا ثقافيًا. تمامًا كما حدث في زمن الفتح الإسكندري. فطوال تاريخهم، لم يتخلَّ الإيرانيون عن هويتهم الثقافية المُمَيَّزة، مع أنهم تفاعلوا مع الثقافات التي سيطروا على بلدانها في العهود الإمبراطورية، ومع الثقافات الوافدة إليهم مع الفاتحين من خارجها. (وهذا من أوجه تميُّز “الفكرة”).
لكن “الفكرة”، أي فكرة، مهما كانت نبيلة، أو حتى مُقَدَّسة، كما يُستدلُّ من التجارب التي عاصرناها نحن في القرن العشرين، يداخلها الفساد في حال استخدامها سلاحًا في صراع المصالح، وخصوصًا في الصراعات على السلطة. شاهدنا ذلك بما حلَّ بفكرة “البعث العربي”، أو “القومية السورية”، أو “القومية العربية”، وكذلك بأفكارٍ سامية مثل “الاشتراكية، و”الشيوعية”، و”الديموقراطية”، التي فشلت وسقطت كلها جرَّاء الفساد البشري الذي داخلها بفعل الصراعات على السلطة أو على النفوذ والسيطرة. وقد شاهد العالم في السنتين الماضيتين، صورة فاضحة عن الهمجية الإسرائيلية، مخالفةً تمامًا حتى لجوهر “الفكرة” اللابسة شعار “المظلومية اليهودية” على يد الأوروبيين، ونادى بها كلّ الذين أطلقوها وتبنُّوها من يهود وغير يهود.
هذا الفساد، النسبي منه والمُطلَق، عندما يستولي على أيِّ فكرة، مهما كانت نبيلة وراقية، بما في ذلك الأفكار الدينية، شخَّصَه اللورد أكتون البريطاني، وهو مؤرّخٌ كاثوليكي وسياسي ليبرالي، في رسالة له الى أسقف بروتستانتي أنغليكاني في العام 1887، وذهب مثلًا بعبارته المشهورة القائلة: “السلطة مَفسِدة، والسلطةُ المُطلقة مَفسِدة مُطلقة”!
وما زال هذا المنحى ساريًا منذ أقدم الأزمنة إلى اليوم، وسوف يبقى كذلك، على الأرجح، ما دام البشر يتصارعون على المصالح، وعلى النفوذ والسلطة، على حساب المبادئ الإنسانية.
*****
دَرَجت العادة بين الدولة الساسانية والدولة البيزنطية، خصوصًا بعد “معاهدة السلام الأبدي”، التي عُقدت بين الإمبراطور البيزنطي يوستنيانوس الأول الكبير وبين الملك الفارسي كسرى الأول (أنو شروان)، في العام 532 للميلاد (سوف نستعرضها في حلقة مقبلة بعنوان “معاهدة السلام الأبدي”)، أن يتبادل الحاكمان البيزنطي والفارسي، كبادرة حسن نية، إقامة ولي عهد كل منهما في عاصمة الآخر، قريبًا من العرش. ولي العهد البيزنطي في البلاط الفارسي، وولي العهد الفارسي في البلاط البيزنطي.
حدثَ في العام 591 أن تولّى العرش الفارسي الملك كسرى الثاني (أبرويز)، حفيد الملك كسرى الأول (أنو شروان)، المذكور أعلاه، خلفًا لوالده الملك هرمز الرابع. لكن قائد جيش أبيه، ويُدعى بهرام، انقلب عليه ساحبًا ولاءه له بعد أربع سنوات من اعتلائه العرش، ففرَّ الملك كسرى إلى العراق حيث أمدَّه الإمبراطور البيزنطي موريس بقوة عسكرية أعادته الى عرشه (معظم أفرادها من أرمينيا). تمامًا كما حدث للشاه محمد رضا بهلوي، عندما فرَّ إلى الخارج في العام 1953 بعد وصول الدكتور محمد مصدق إلى رئاسة الحكومة وأمَّمَ شركات النفط الأجنبية، فأعاده كيرميت روزفلت، مسؤول وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، إلى عرشه بانقلابٍ مُضاد أطاحَ حكومة مصدق!
من الطبيعي في هذه الحالة، أن يشعرَ الملك الفارسي بالامتنان للإمبراطور موريس، كما شعر بذلك الشاه محمد رضا بهلوي تجاه الولايات المتحدة والغرب، بعد مجيئه الثاني على يدهم وبمساندتهم. وكما صارت واشنطن وصيَّة على حكم الشاه محمد رضا، كذلك صارت القسطنطينية وصيَّة على عرش كسرى، أو حامية له.
لم يَدُم هذا الوضعُ طويلًا، لأنَّ الإمبراطور موريس أُزيلَ من المشهد بصورةٍ مفاجئة في انقلابٍ عسكري قام به ضابط، قائد مئة، اسمه “فوقاش” (عديد الكتيبة التي كان يقودها ضابط بهذه الرتبة في الجيش الروماني القديم، لم يصل قط الى مئة جندي، وأكبر عدد وصل إليه في تاريخ الجيوش الرومانية هو 86 جنديًا فقط). ومنذ إعلانه إمبراطورًا بتزكية من سلفه تيبيريوس الثاني (تيبيريوس الأول هو خليفة القيصر أغسطس، وكلاهما له علاقة بالتاريخ المسيحي. فقد وُلد المسيح في عهد أغسطس، وصُلب في عهد تيبيريوس الأول)، خاض موريس حروبًا متواصلة على جميع الجبهات وفي كلِّ الاتجاهات، مما استنزف مالية الدولة، فاضطرَّ إلى اتخاذ إجراءاتٍ اقتصادية صارمة، مما أحدث تملمُلًا واستياءً في الأوساط الشعبية، وخصوصاً في صفوف الجيش، مما حفز الانقلاب العسكري عليه وإطاحته.
*****
فور وقوع الانقلاب في القسطنطينية، حرّكَ كسرى الثاني (أبرويز) جيوشه واحتلَّ سوريا، وصولًا الى القدس في فلسطين، مُعلنًا أنه يحفظها “وديعة” في عنقه، ريثما تعود الشرعية الى القسطنطينية. وبالتالي فإنه لن يعيدها لأيٍّ كان غير راعيه السابق الإمبراطور موريس.
كان الضابط فوقاش غير ملمٍّ بشؤون السلطة والحكم، وضعيف الثقافة، فلم يكن واثقًا من نفسه، ولا واثقًا بمن حوله، فقتل الإمبراطور موريس وأعلن نفسه إمبراطورًا، وتملّكه الخوف والهلع، فصار يتوهَّم أنه يرى الأعداء في كلِّ مكان يتربّصون به، فراح يمارس القتل على الشبهة، مما سرَّع في نهايته، بعد حكم من الإرهاب والخوف استمر ثماني سنوات (602 -610م).
بلغت أخبار الاضطرابات في القسطنطينية بعد فترة مسامع قائد الجيوش البيزنطية في شمال أفريقيا، المقيم في قرطاجة، فأوفد ابنه الذي يحمل نفس الاسم (“هيراكليوس” أو “هرقل”)، مع قوة بحرية ليستطلع ما يجري في العاصمة. ولما وصل هرقل الأصغر إلى القسطنطينية، يوم الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) من العام 610، تحركت المدينة كلها لاستقباله، فأعدم فوقاش فورًا، وأعلن نفسه إمبراطورًا.
لكن كسرى لم يعترف بشرعية هرقل، فقرّرَ أن يحتفظَ بسوريا، ودخل الى مدينة القدس في فلسطين حيث صادر عود الصليب الأصلي من كنيسة القيامة ونقله الى خوزستان في جنوب إيران. ورافق دخوله إلى القدس حدوث مجازر ضد المسيحيين سالت فيها دماءٌ كثيرة. ويختلف المؤرخون حول الجهة التي قامت بتلك المجازر. هناك من يقول إنَّ الجيش الفارسي المحتل هو الذي فعل ذلك، وهناك آخرون يتّهمون يهود المدينة، الذين استقووا بالجيش الفارسي، هم الذين قاموا بها (راجع كتاب الباحث الفلسطيني عصام محمد سخنيني، بعنوان “مقاتل المسيحيين”، الصادر في بيروت عن “المؤسسة العربية للدراسات والنشر” بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، حول المجازر بحق المسيحيين في نجران، جنوب الجزيرة العربية، على يد الحاكم اليهودي الحميري ذي نؤاس في اليمن عام 523م، ومجازر القدس المشار إليها عام 614م تحت نظر الملك الفارسي كسرى الثاني).
هناكَ قرائن عديدة تدلُّ على أنَّ كسرى الثاني (أبرويز)، اتخذ من مقتل الإمبراطور البيزنطي موريس ذريعة للتوسُّع بهدف استعادة حدود الإمبراطورية الإخمينية، فحقَّقَ ذلك مؤقتًا بسيطرته على كامل سوريا (بما فيها فلسطين)، ومصر وحتى ليبيا.
في ذلك الزمان، كان من معايير شرعية أي حاكم جديد أن يسكَّ نقودًا ذهبية للتداول في الأسواق تحمل صورته، وأي كلام يريد أن يُميز به نفسه، بعد سنتين من اعتلائه العرش. وبالفعل سكَّ كسرى الثاني مجموعة من العملات باسمه وتحمل صوره، بعد سيطرته على سوريا، لكنه أبقى على العملات البيزنطية المتداولة سابقًا، ربما لأنَّ السوريين لم يُقبلوا على عملته الجديدة خشية أن تفقد قيمتها في حال عودة سوريا إلى البيزنطيين.
توجد في المتاحف، وبعض صور لنقود كسرى في المراجع التاريخية، قطع عليها صورته نُقشت إلى جانبها عبارة “ملك الملوك”، لا يوجد لها نظير في العملات السابقة. وهناك قطع أخرى عليها اسمه وصورته وعبارة “المُتقدِّم في المجد”.
*****
لا يستقيمُ فَهمُ المرحلة المُمتَدّة من حُكم كسرى الأول (أنو شروان)، إلى الفتح العربي الإسلامي، بعد حكم حفيده كسرى الثاني (أبرويز)، ما لم تُفهم إشكالية السلم والحرب بين الدولة الساسانية في بلاد فارس وبين الإمبراطورية الرومانية، ومن بعدها الإمبراطورية البيزنطية. ويمكن النظر إلى تلك الإشكالية بمنظارِ ما يجري اليوم بين إيران الإسلامية وبين الغرب، من مشادَّة سياسية ومناوشات عسكرية، لأنها في ديناميتها وأسبابها، تُشكّلُ امتدادًا تاريخيًا متواصلًا، لعله الأطول والأعمق في التاريخ العالمي.
ليس من المُجدي بناء الفهم التاريخي لصراع الأمم الحيَّة، مثل إيران والغرب، على الفرضيَّات، لكنه لا بدَّ في المراحل المفصلية من افتراض ما كان يمكن أن يحدث على غير ما حدث فعلًا. قطعًا، لو لم ينقلب الضابط البيزنطي فوقاش في مطلع القرن السابع الميلادي على الإمبراطور موريس ويقتله، لكان تحقَّق، ولأول مرة، سلامٌ حقيقي بين الروم والفرس على يد كسرى الثاني (أبرويز) والإمبراطور موريس، تأسيسًا على “معاهدة السلام الأبدي”، بين كسرى الأول (أنو شروان)، والإمبراطور البيزنطي يوستينيانوس الأول الكبير، في الثلث الأول من القرن السادس.
إذ ليس من عبثٍ سُمِّيَ “السلام الأبدي”، لأنَّ الفريقين تضرَّرا من الصراع الدائم، وكلاهما كان بحاجة إلى إصلاحات قانونية جذرية لإعادة ترميم النظام الداخلي من أجل إعادة بناء حالة الازدهار من خلال الاستقرار، بعد التدهور المريع في كلتا الإمبراطوريتين، والضيق الاقتصادي الخانق، بفعل إنفاق الموارد المالية على حروب متواصلة بينهما، يستحقُّ السلام بعدها أن يكون أبديًا. كلٌّ منهما شعر بوطأة الكلفة الباهظة للحرب، سواء كانت مباشرة رأسًا لرأس، أو بالواسطة من طريق “الأذرع” الموالية لكلٍّ منهما، وهي حالة مستمرة إلى اليوم.
في التاريخ الفارسي القديم، يُذكر كسرى الثاني (أبرويز) على أنه “ملكٌ مسرفٌ، مبذّرٌ، ينفق عن سعة على المظاهر والفخفخة، وهو المسؤول الأول عن سقوط الإمبراطورية الساسانية”!
*****
كما في الوقت الحاضر أيضًا، لا يمكن إغفال العامل الديني في الصراع الفارسي–البيزنطي، حيث لعبت الحساسيات بين الزرادشتيين والمسيحيين واليهود، دورًا في تأجيج الصراعات السياسية والعسكرية، خصوصًا في مرحلة كسرى الثاني (أبرويز)، كما سنرى في الحلقة المقبلة بعنوان “مقاتل المسيحيين”، مع أنه لم يكن مُنحازًا أو مسبّبًا لتلك الحساسيات الدينية، بل بسبب تعصُّب رجال الدين، ومصالح طبقة النبلاء الإقطاعيين، والمحاربين، وهي الطبقات المرتبطة دومًا مع رجال الدين!
لكن هذا التحالف لا يمكن فهمه بالمنظور الطبقي، بل في إطار فكرة “إبرانشهر”، التي عبَّرت عن نفسها، في الحقبة الساسانيَّة، على أنها مساحةٌ محدَّدة من الأرض تحكمها “الأرستقراطية العسكريَّة”، ومفاهيمها الفكرية حدَّدها، وجدّدها، رجال الدين. وكان هذا التحالف عاملًا وجوديًّا مهمًا لبقاء الدولة في بداية الحكم الساساني. وقد أصبح ذلك من المسلّمات الفكرية المُثلى في الديانة الزرادشية، حيث كانت النظرة إلى الدين والدولة على أنهما ركيزتان لا تنفصلان عن بعضهما البعض، وأيٌّ منهما لا تستطيع البقاء من دون الأخرى. وقد تقبَّل المسيحيون واليهود هذه الفكرة، وأجاز الزرادشتيُّون التزاوج معهم.
فوق ذلك، كان كسرى الثاني، كمحاربٍ وقائدٍ ميداني، مجدّدًا في الفنون الحربية، وفي ابتكار الأسلحة، تعويضًا عن الضعف الذي أصاب الطبقة العسكرية الفارسية التقليدية، بسبب الاعتماد المتزايد، في المراحل الأخيرة من الدولة الساسانية، على قوات مرتزقة من القبائل الرُحَّل. واللافت أنه خلال حُكم كسرى الثاني، قتل الفرس عاملهم ملك الحيرة العربي على اللخميين، النعمان بن المنذر، في العام 613 للميلاد، لأسباب غير معروفة على وجه الدقة حتى الآن، واختلف فيها الرواة.
من التجديدات العسكرية التي أدخلها كسرى في المعارك، استعمال الفيلة، بما يشبه سلاح الدبابات في الوقت الحاضر. استعمل الفيلة ضد البيزنطيين، واستعملها ضد القوات العربية الإسلامية الفاتحة، حسب المصادر العربية. ومن التغييرات الإدارية التي أدخلها على الجيش، ما سمَّاه العرب “ديوان المقاتلة”، حيث خصَّص معاشًا ثابتًا لقوات سلاح الخيالة. ومن بين هؤلاء الجنود، اختار قوات النخبة الذين سمَّوهم “الخالدون”، وقائدهم هو آمر الحرس الملكي، وذلك بكلفة عظيمة، تضاهي في زمانها كلفة صدام حسين على “الحرس الجمهوري” في العراق، كجيش رديف لحماية السلطة، وكلفة “الحرس الثوري” وملحقاته في الجمهورية الإسلامية خلال العقود الأخيرة.
حتى في تنظيم ترتيب المشاة والرماة، وأسلحة كل منهم، استحدث كسرى تحرّكات عسكرية وأسلحة مبتكرة. ففي “كتاب الخطط العسكرية” للإمبراطور البيزنطي موريس (يدعى باليونانية “ستراتيجيكون”)، معلومات تفصيلية حول الاستراتيجيات الحربية، وحول أدق الفروقات في الأسلحة وأوجه استخدامها بين الجنود الفرس وجنود الروم.
جاء أيضًا في المراجع الصينية القديمة، (“كو–كو–ياو”)، أنَّ الفرس كانت لديهم مصانع للفولاذ، يورّدون منها إلى الصين لصنع السيوف، لكونها قويةً ومتينةً. لكن المصادر الرومانية، تفيد بأنَّ الفولاذ الفارسي يأتي في الدرجة الثانية بعد الفولاذ الهندي، وهذا ما تؤيده المصادر العربية أيضًا. فقد ورد في الشعر العربي مرارًا تعبير “سيوف الهند”، لإظهار أوليتها كسلاحٍ قاطع، بحيث باتت كلمة “مهنَّد” (أي السيف الهندي) الاسم المتداول بمعنى “السيف” عند العرب.
(الحلقة المقبلة: “مقاتل المسيحيين”).
إشكالية السلم والحرب بين إيران والغرب (5)
التَوَسُّعِيَّة الإيرانية: نَمَطٌ ثابتٌ ونَهجٌ مُتَغَيِّرٌ
أدهشت إمبراطورة إيران الراحلة ثُرَيّا المجتمع اللبناني خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها مع زوجها الشاه إلى بيروت، واستمرَّت أسبوعًا، من 16 الى 23 كانون الأول (ديسمبر) 1957.
كان ذلك في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس كميل شمعون المضطربة.
الشاهبانو ثريا إصفندياري–بختياري، الزوجة الثانية لشاه إيران محمد رضا بهلوي، (تزوَّجها بعد سنتين على طلاقه من الأميرة فوزية)، كانت في زمانها من النجمات العالميات، لجمالها الفتَّان، وثقافتها العالية، وأناقتها المُمَيَّزة، فأصبحت موضعَ اهتمامِ وسائل الإعلام العالمية، والمُنتديات الاجتماعية حول العالم.
أقامَ لهما الرئيس كميل شمعون، وزوجته زلفا ثابت، حفل استقبال كبير في القصر الجمهوري، في “محلَّة القنطاري”، تخلّله عشاءٌ رسمي، وحفلٌ موسيقي راقص، بما يليق بمقامٍ إمبراطوري. وخلال تلك الزيارة، منحت الجامعة اللبنانية، الحديثة العهد آنذاك، درجة دكتوراه فخريَّة للشاه الزائر.
لم تَكُن تلك زيارة الشاه الأولى للبنان في عهد كميل شمعون. فقد حطَّ في بيروت ليومٍ واحد في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1951، حيث التقى الرئيس اللبناني، وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة. التقاه في بداية عهده الزاهرة، والتقاه في نهايته المُلتبسة. في تلك الفترة أبدى شاه إيران اهتمامًا خاصًا بلبنان، يكادُ يُضاهي اهتمام الجمهورية الإسلامية خلال العقود الأخيرة. ومن مظاهر ذلك الاهتمام اشتراك قوات إيرانية في حفظ السلام على خطوط الهدنة بين لبنان وإسرائيل.
*****
ربما كان في ذهن الشاه مشروعٌ أوسع، يقومُ على استمالةِ شيعة لبنان، كجسمٍ موحَّد، على غرار “البيئة الحاضنة” في هذه الأيام، فأوفدَ بعثةً رسمية الى مدينة صور، قبل مدة من زيارته الثانية إلى لبنان، لطرح مشروعه على كبير علماء الشيعة في ذلك الوقت، الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين، الذي كان في حينه مريضًا، طريح الفراش، وقبل وفاته بأسابيع قليلة.
قال الموفد الإيراني للسيد شرف الدين، إنَّ الشاه هو الحاكم الشيعي الوحيد في العالم الإسلامي، ويهمُّه أن يحظى بدعم الشيعة في لبنان، وفي غير لبنان، وهو مستعدٌّ أن يُموِّلَ إنشاء المدارس والكليات والمستشفيات والنوادي الثقافية، وكل ما يلزم لرفع المستوى المعيشي والثقافي للطائفة، وعرضَ عليه مبلغًا نقديًا كبيرًا لتيسير الأمور ريثما تكتملُ دراسات المشروع. كان مبعوثُ الشاه محمد رضا بهلوي يتكلم في العام 1957، وكأنه ينطقُ بمنطق الشاه إسماعيل في العام 1501!
لكن السيد شرف الدين، وهو في أيامه الأخيرة، رفضَ العرض، مُفضِّلًا استقلال الشيعة في لبنان عن أيِّ دولةٍ غير الدولة اللبنانية، مع أنَّ كثيرين من الشيعة كانوا يشعرون بالغبن والحرمان في هذه الدولة.
في السنوات الأولى من قيام دولة لبنان الكبير، تولّى زمام الأمور فيها ثلاثة رؤساء من غير الموارنة، (شارل دبَّاس، وبيترو طراد، وأيوب ثابت)، ولمّا انتُخِبَ أول رئيس ماروني، هو حبيب باشا السعد، في أواسط ثلاثينيات القرن الماضي، بعثَ إليه السيد عبد الحسين شرف الدين برسالة تهنئة مُمَيَّزة، قال له فيها: “إننا نمنحك ثقتنا، وهي ثقةٌ لا تُمنح إلّاَ لمثلك”، أي إلى الرئيس الماروني تحديدًا. وفي بداية العهد الاستقلالي، برئاسة الشيخ بشارة الخوري، بعث إليه السيد شرف الدين برسالةٍ مُماثلة.
هو موقفٌ شجاعٌ ينسجم مع جوهر مشروع “لبنان الكبير”، حيث فضَّل البطريرك الماروني الياس الحويك، شيعة لبنان على مسيحيي وادي النصارى والساحل السوري، لأنه لم يَكُن يسعى إلى “وطنٍ مسيحي”، بل إلى كيانٍ عصريٍّ تعدُّديٍّ مُتوازنٍ، بين مكوّنات متمايزة ومتكاملة في الوقت ذاته، لتثبيتِ مبدَإِ “التعدُّد المتنوّع، في إطار التعايش السلمي”، ضمن نظامٍ يقوم على نوعٍ من التوجّه الديموقراطي، يكفل الحريات العامة والخاصة.
كان هذا أيضًا الخيار الشيعي في ذلك الوقت، وهو خيارٌ لبناني لا لبس فيه، وبالشراكة مع الموارنة تحديدًا، كما جاء بوضوح في رسالة السيد شرف الدين إلى الرئيس حبيب باشا السعد، وفي عزِّ الانتداب الفرنسي، الذي قاومه السيد شرف الدين، وحكم عليه الفرنسيون بالإعدام ففرَّ إلى مصر ومنها إلى فلسطين ليكون بالقرب من الحدود اللبنانية قبالة جبل عامل. كان بإمكانه أن يلجأ إلى إيران، أو العراق، لكنه لم يفعل.
بالمقارنة بين المحاولة الفاشلة التي جرَّب فيها الشاه محمد رضا بهلوي استمالة شيعة لبنان، وبين النجاح الباهر، الذي حقَّقته الجمهورية الإسلامية بعده، في جعل شيعة لبنان كتلة متراصَّة، مرتبطة بها، سياسيًا، وعسكريًا، وعقائديًا، يتضح ما هو المقصود بعبارة “النمط الثابت، والنهج المتغيِّر”، لأنه أيضًا ينسحبُ على التاريخ القديم، والمتوسط، مثلما هو واضحٌ في التاريخ الحديث.
*****
إنَّ التوجُّهَ التوسُّعي للدولة الإيرانية نمطٌ قائمٌ وثابتٌ منذ قيام الدولة الإخمينية على يد الملك قورش وابنه قمبيز الثاني في أواسط القرن الخامس قبل الميلاد (550 ق. م). وقد اتَّجَهَ ذلك التوسُّع إلى الغرب، نحو البحر الأبيض المتوسط، عبر سوريا، التي كانت دائمًا نقطة الارتكاز في التوسُّعية الفارسية قبل الإسلام، باتجاه مصر وليبيا، في الغرب الجنوبي، وباتجاه اليونان والبلقان في الغرب الشمالي. ولذلك، لا يُمكِنُ القول بأنَّ إيران بلدٌ شرقيٌّ تمامًا، لتمازجها وتلاقحها مع حضاراتٍ عريقة، ومنها على وجه الخصوص الحضارة الهيلينية الإغريقية في بداية تفتُّح نهضتها العلمية القائمة على التدوين. في تلك المرحلة أصدر هيرودوتوس أول كتاب في التاريخ. وفي تلك المرحلة، المعروفة باسم “مرحلة ما قبل سقراط”، تَفتَّحَ الإغريق على العلوم الطبيعية، النظرية والتطبيقية، قبل ولوجهم في “مرحلة الفلسفة” التي ما زالت ساريةً إلى اليوم. ومن أوائل روَّاد مرحلة العلوم والفلك والرياضيَّات، التي انطلقت، بالتزامن تقريبًا مع توسُّع الدولة الإخمينية غربًا، المُعلم “طاليس”، الذي حسب مسبقًا تاريخ كسوف الشمس، وصنع آلةً لعصر الزيتون، وتلميذه “أناكسيماندر”، الذي كان أول من قال بأنَّ كوكب الأرض جسمٌ سابحٌ في الفضاء، وتلميذ تلميذه “بيثاغوراس”، عالم الرياضيات والموسيقى، مؤسس علم الهندسة الذي طوَّره من بعده إقليدس المشهور.
كانت بلاد الإغريق في ذلك الوقت مدنًا متفرّقة، بمعنى أنَّ كلَّ مدينة كانت دولة مستقلة، بما درجت تسميته في كتب التاريخ “الدولة المدينة”. وقد تميَّزت أثينا، بنظامها الديموقراطي، حيث لكلِّ مواطن رأي يستطيع أن يُجاهرَ به في المجالس والساحات. لكن الدولة الفارسية الإخمينية المحتلة، أقامت على حُكمِ كلِّ مدينة حاكمًا طاغية يحكُمُ باسمها، الى أن جاءَ يومٌ توحَّد فيه هؤلاء الحكّام، تحت ضغط مواطنيهم، فدحروا الحكم الفارسي بقيادة داريوس الأول.
ذلك التمرُّد أرسى نمطًا تغيَّرَ نهجه مع تغيُّرِ الظروف الإقليمية والدولية. واللافت أنَّ ذلك النمط تبلورَ من خلال دينامية الاحتلال والمقاومة، حيث انهزمت الدولة الفارسية عندما اتحد خصومها ضدها. وهذا النمط تكرّرَ في ما بعد، في اليونان، أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، وحدث في صدر الإسلام في الجزيرة العربية، منتصف القرن السابع الميلادي، عندما توحَّدت القبائل العربية تحت راية الإسلام، وانتصرت على الفرس في معركة “القادسية”، وكما حدث في مطلع القرن الثالث عشر، عندما توحّدت القبائل المغولية تحت راية جنكيز خان، ثم اجتاحت الحشود المغولية بلاد فارس، وصولًا إلى بغداد ودمشق، بقيادة حفيده هولاكو خان، فأسقطت الدولة العباسية، وقتلت المستعصم بالله، آخر الخلفاء العباسيين.
لكن الصراع الإغريقي–الفارسي في الغرب اليوناني، له مراحل وتوجُّهات مختلفة، كتبت حتميَّة انتصار الغرب، كما جاء في أطروحة المؤرخ العسكري الأميركي، فيكتور دايفيز هانسون، الأستاذ في جامعة ستانفورد (ولاية كاليفورنيا) في كتابه “لماذا ربح الغرب”، (الصادر عن “فايبر آند فايبر”، مطلع العام 2017). وقد أعاد اليونانيون الكرّة في العصور الحديثة بانتصارهم على الدولة العثمانية في مطلع القرن التاسع عشر، ونيل استقلالهم عنها، بمساعدة القوى الغربية في أوروبا.
*****
اعتبر هانسون “معركة سلاميس” البحرية، في العام 480 قبل الميلاد، معركة حاسمة من حيث تأكيد حتمية انتصار الغرب، فوصفها بأنها “معركة سلاميس المقدَّسة”، حيث تمكّنت زوارق يونانية صغيرة، لكنها سريعة الحركة والمناورة، بإنزالِ هزيمة كاسحة بالأسطول الفارسي الضخم، ومعه أساطيل فينيقيا ومصر، لكون سواحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا ومصر واقعة تحت سيادة الدولة الفارسية الإخمينية في ذلك الوقت. وقد عزا ذلك الانتصار المهيب، وغير المتكافئ، إلى كون البحَّارة اليونانيين من الرجال الأحرار، الذين يختارون قادتهم بإرادتهم الحرَّة، ويناقشون خططهم لاتخاذ القرارات المناسبة، بينما بحَّارة الأساطيل الفارسية وحلفائها، فاقدون إرادتهم الحرَّة، ينفذون خططًا لا دخل لهم فيها، والجنود الذين يقومون بالتجذيف لتحريك السفن الثقيلة، البطيئة الحركة والمناورة، هم من العبيد المُقيَّدين بالسلاسل، خشية هروبهم!
في العصور الحديثة، وفي اليونان أيضًا، عندما قام الأسطول المصري، بقيادة إبراهيم باشا، باحتلال الموانئ اليونانية، نيابةً عن السلطنة العثمانية، لقمع ثورة الاستقلال اليوناني عن الدولة العثمانية، في مطلع عشرينيات القرن التاسع عشر، تحالفت أساطيل غربية ودمَّرت الأسطول المصري في “معركة نافارينو”، التي كانت آخر معركة بحرية في العالم تُخاض بسفن شراعية تقليدية، لأن “الثورة الصناعية” في الغرب اكتشفت البخار، وبنت السفن البخارية القوية والسريعة، فصارت السيادة في أعالي البحار للبخار… وأصحاب البخار.
هناك نقطةٌ أخرى، تتعلّق بالتفاوت في النظرة إلى الدين بين الغرب والشرق، تطرَّقَ إليها الفيلسوف البريطاني برتراند راسل، في كتابٍ له صدر في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين، بعنوان “السلطة”، قال فيه إنه في الصراع بين الدين والدولة، كان النصر حليف الدولة في الغرب، بينما في الشرق كان الدين دائمًا ينتصر على الدولة!
إنَّ الأحلام الإمبراطورية التوسُّعية لم تُغادر مخيَّلة الدولة الإيرانية، بأيِّ حلَّةٍ لبست. ففي شهر تشرين الأول (أكتوبر) 1971، أقام شاه إيران محمد رضا بهلوي، احتفالاتٍ باذخة في مدينة بيرسيبوليس القديمة، عاصمة أول إمبراطورية فارسية في العصور الغابرة (الإمبراطورية الإخمينية)، إحياءً لذكرى مرور 2500 سنة على قيام تلك الإمبراطورية، دعا إليها معظم قادة دول العالم على نحوٍ مبهر ومفاجئ، وبكلفة عظيمة في وقتٍ من الضائقة الاقتصادية، قبيل الإجراءات النفطية التي اتخذها الشاه بعد سنتين من ذلك الاحتفال الأسطوري حيال شركات النفط الأجنبية، مما عزَّز مالية دولته. لكن الأموال الفائضة المتأتية من الموارد النفطية الجديدة أنفقها الشاه على التسلح، ربما ضمن مخططه لإحياء الإمبراطورية الفارسية، التي احتفل بها مسبقًا!
*****
ربما كان الشاه محمد رضا بهلوي “ساذجًا”، إذا اعتقد بأنَّ الغرب يمكن أن يسمحَ له بتجاوز مخططه القائم على دولة إسرائيل، التوسُّعية هي الأخرى. لكنه كان متنبِّهًا للأمر، كما يُستَدَلُّ من مقابلته المشهورة مع الصحافي الأميركي مايك والاس في قصره بطهران يوم 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1976. فقد قال الشاه لمحدثه الأميركي في ذلك البرنامج الذائع الصيت، وعنوانه “60 دقيقة”، لأنه يستمر لساعة كاملة: إنَّ اللوبي اليهودي في أميركا لديه قوة سياسية واقتصادية هائلة، يتحكّم بها في الانتخابات الرئاسية، وانتخابات الكونغرس، ويؤثِّر بالتالي في صنع القرارات السياسية.
سأله والاس: كيف ذلك؟
فقال: “إنهم يملكون قوة هائلة في الصحافة ووسائل الإعلام، وفي المصارف وبيوت المال، وسوف أكتفي بذلك…
سأله ما إذا كان يقصد جريدة “نيويورك تايمز”، لأن عائلة سالزبورغر اليهودية تملكها، فأجابه: ضع مقالات تلك الجريدة في الكومبيوتر وانظر ما هي النتيجة…
ثم سأله: وماذا عن جريدة “واشنطن بوست”، فأجاب الشاه: الشيء ذاته.
قال أيضًا إنه لا مشكلة له مع دولة إسرائيل إذا أعادت الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. “وجه السذاجة” هنا، يظهر إذا كان الشاه قصد بذلك أنه يقبل بإسرائيل كمحميَّة إيرانية تحت جناحه!
بعد شهرين من تلك المقابلة، قام الرئيس السوري حافظ الأسد، مع زوجته، بزيارة رسمية إلى طهران، حيث لقي استقبالًا حافلًا من الشاه، الذي عقد معه اتفاقيات اقتصادية عدة، منها إمداد سوريا بقروض مالية بمبلغ 150 مليون دولار.
مشى الشاه على خطى أسلافه القدامى في الدولة الإيرانية، وكما فعلت من بعده الجمهورية الإسلامية، من حيث التمسُّك بسوريا، لأنها تمثل نقطة مركزية في التوسُّع الإيراني، لكنه لم يعش ليتابع ما في مخيلته الإمبراطورية، فأكملته من بعده الجمهورية الإسلامية على نحوٍ أنجح وأوسع، شمل شيعة لبنان أيضًا، حيث تعذَّر ذلك على الشاه أيام كميل شمعون. بل إنَّ الدورَ الإيراني، في سوريا ولبنان، خلال عهد الرئيس بشار الأسد، أظهر للإيرانيين وللعالم، مركزية سوريا من حيث كونها مسرحًا ممتازًا لخطة “الدفاع الهجومي” عن الجمهورية الإسلامية. والواقع أنه لولا سوريا، والوجود السوري في لبنان طيلة ثلاثة عقود، لما أتيح للمقاومة الإسلامية في لبنان، بقيادة “حزب الله”، أن تنمو وتتوسّع، لتصبح لاعبًا إقليميًا على مسرح أكبر من لبنان بكثير.
خلال زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى سوريا، في شهر أيلول (سبتمبر) 2010، انعقد في دمشق اجتماعٌ ثلاثي، ضم الرئيس أحمدي نجاد، والرئيس بشار الأسد، والأمين العام الراحل ل”حزب الله”، السيد حسن نصر الله، الذي بدا في ذلك المشهد، وكأنه رئيس لبنان، في اجتماعٍ رئاسي على مستوى القمة، إلى جانب دولتين من أكبر وأقوى دول المنطقة في ذلك الوقت. ولذلك فإن انكسار إيران في سوريا، كان نكسة استراتيجية من الصعب تعويضها، والقوى الغربية التي خطَّطت لإسقاط نظام بشار الأسد، كانت تعرف ذلك حق المعرفة، بناءً على التجارب القديمة كلها.
إنَّ إبعادَ إيران عن سوريا، وإبعاد سوريا عن إيران، أحبط استراتيجية “الدفاع الهجومي”، بردِّ الأخطار المحتملة، التي تواجه الجمهوريَّة الإسلامية، من خارج الحدود الإيرانية، مما سيضطر الدولة الإيرانية القائمة، أيًّا كانت هويَّة الحكم فيها، إلى “الدفاع السلبي”، في داخلها، بكل ما يحمله ذلك من أخطار واحتمالات، تتراوح بين سقوط النظام، والحرب الأهلية، أو التقسيم العرقي، أو الانكفاء والتراجع، تحت وطأة الحصار والتضييق.
*****
هكذا حدث، في معركة أربيل (أو “جوجميلا”) التي دحر فيها الاسكندر المقدوني جيوش الدولة الإخمينية بقيادة الملك داريوس الثالث في العام 331 قبل الميلاد، وأزال تلك الدولة من الوجود وعمرها 250 سنة، فانفتح أمامه الطريق الى الهند في الشرق، وإلى سوريا ومصر في الغرب. ويعتبر المؤرخون، القدامى والجدد، أن تلك المعركة الحاسمة غيَّرت تغييرًا جذريًا في أوضاع القارة الآسيوية، والعالم القديم بأكمله، لا سيما من الناحية الثقافية بنشر الحضارة الهيلينية على أوسع نطاق. وقد تجذرت تلك الحضارة بشكل خاص في سوريا ومصر الى مئات السنين، وصولًا إلى الوقت الحاضر.
شخَّصَ اللاهوتي والمؤرخ الأسكتلندي جورج آدم سميث، النمط الثابت لمركزية سوريا، في صراع الأمم، في كتابه الكلاسيكي “الجغرافيا التاريخية للأراضي المقدَّسة” (الصادر في لندن ونيويورك، أواخر القرن التاسع عشر)، بقوله: “إنَّ سوريا هي الأرض الوحيدة في العالم التي كرَّر التاريخ فيها نفسه”.
وقال أيضًا: “إنَّ سوريا ليست الطريق المؤدّي الى مكانٍ آخر. هي ذاتها هدف ومرمى جميع الطرقات. هي الولاية المباركة الأكثر مركزيَّةً في العالم، وهو ما جلب لها ويلات التنافس المتكرر عليها بين الشرق والغرب”.
مع أنَّ حملة الإسكندر المقدوني كانت مُوَجَّهة في الدرجة الأولى ضد الدولة الفارسية، وعلى الرُغم من الاحتلال اليوناني لتلك الدولة، فإنَّ الثقافة الهيلينية الإغريقية لم تتجذر في بلاد فارس كما تجذّرت في سوريا ومصر، وخصوصاً في سوريا، حيث وصف جورج آدم سميث هذه الحالة بقوله: “لقد تهلنت سوريا أكثر من هيلاس نفسها”!
كانت الثقافة الهيلينية في ذلك الوقت شديدة الجذب والاستيعاب إلى درجة أنها كادت تُذيبُ اليهود فيها، لو لم تُعاجل المؤسسة الدينية اليهودية إلى تدارك الأمر، الذي كاد يمحو الهوية التاريخية لليهود، بأن أقامت مدارس دينية لغسل أدمغة الأجيال اليهودية الجديدة، وإعادة شدها إلى جذورها التاريخية. وقد أشار إلى ذلك برنامج تلفزيوني في السبعينيات من القرن الماضي قدَّمه وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق آبا إيبان.
وربما كان ذلك من الأسباب التي حملت ملك سوريا اليوناني أنطيوخوس الرابع (أبيفانس) على تجريد حملة عسكرية قادها بنفسه في العام 168 قبل الميلاد، ضد اليهود، وأصدر أمرًا بمنع ممارسة شعائر الديانة اليهودية تحت طائلة الإعدام!
*****
تكرَّر احتلال الفرس لسوريا أيضًا في زمن الدولة الكسروية الساسانية في أوائل القرن السابع الميلادي، عندما قام كسرى الثاني (أبرويز) باحتلالها، وانتزاعها من الدولة البيزنطية، مستغلًّا اضطرابات سياسية في القسطنطينية. ثم عاد البيزنطيون بقيادة الإمبراطور هرقل فهزموا جيوش كسرى في “معركة نينوى” (في شمال العراق)، يوم 16 كانون الأول (ديسمبر) من العام 627 للميلاد)، وكان نصرًا حاسمًا، سقطت بعده الدولة الساسانية، لتقع تاليًا بيد الفاتحين العرب المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين.
إنه حادثٌ تاريخيٌّ مشهود وَرَدَ ذكره، كما بدأ وكما انتهى، في آية من القرآن هي: “غُلبت الروم في أدنى الأرض، وهم بعد غَلَبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ، ويومئذٍ يفرح المؤمنون” (سورة الروم 2 – 4). والمقصود بعبارة “أدنى الأرض” هو سوريا، ما يؤشِّر إلى أنَّ مزاج الكيان الإسلامي الوليد في الجزيرة العربية لم يَكُن متعاطفًا مع الفرس. بل هناك تفاسير قالت: إنَّ الجزيرة العربية زيَّنت لانتصار الروم على الفرس!
خسرت الدولة الساسانية سوريا، فسقطت، وزالت من الوجود، وهي حالة أشبه ما تكون بخسارة الجمهورية الإسلامية لسوريا أخيرًا، وهي خسارة استراتيجية من شبه المستحيل تعويضها في الظروف الدولية الراهنة.
(الحلقة المقبلة: “وديعة كسرى”!)
إشكالية السلم والحرب بين إيران والغرب (4)
أهون الشرين… “الشيطان الأصغر”
بهرته القاهرة. سحره العمران فيها. اندهش الأمير الشاب محمد رضا شاه عندما دخلَ إلى قصر عابدين، بصحبة والده الشاه رضا، ليطلب له يد الأميرة فوزية، ابنة الملك فؤاد من زوجته الثانية ناظلي صبري، وشقيقة الملك فاروق.
تجوَّلَ ولي العهد الإيراني في العاصمة المصريَّة، فسحره العمران الحديث الذي شيَّده الخديوي إسماعيل جدُّ خطيبته، التي أصبحت زوجته الأولى، الأميرة فوزية. انطبَعَ في ذهنه أنه عندما يعتلي العرش بعد أبيه سوف يُجاري النهضة المصريَّة الفتيَّة، الجاذبة للأنظار، والمُلهِمة للأفكار.
كانت مصر، عندما زارها الأمير الإيراني محمد رضا شاه في العام 1939 ليُصاهِرَ ملكها، “أُمّ الدنيا بحقٍّ وحقيق”.
لكنَّ زواجَ الأمير الشاب محمد رضا شاه، تمَّ لأسبابٍ سياسية، على أبواب الحرب العالمية الثانية، بينما مشروع هذه المُصاهَرة الإيرانية–المصرية، كان من بنات أفكار الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك، مؤسّس الجمهورية التركية الحديثة، بعد تصفية الإمبراطورية العثمانية، ومعها الخلافة الإسلامية، قبل نهاية الربع الأول من القرن العشرين، في أعقاب الحرب العالمية الأولى.
كان ذلك جُزءًا من مشروعٍ سياسي إقليمي كبير بدأه أتاتورك، لكنه لم يعش ليُكمله. فقد فارق الحياة وهو في السابعة والخمسين من العمر.
*****
في العام 1937، أي قبل سنة من وفاته، أطلق أتاتورك دينامية إقليمية لم تأخذ مداها المُرتجى، ليس فقط بسبب غياب الزعيم التركي المفاجئ عن المسرح، لكن أيضًا لأنَّ إيران، شريكته في معاهدة “سعد أباد”، التي تمَّ توقيعها في طهران يوم 8 تموز (يوليو) من ذلك العام، وقعت فريسة الصراع الدولي وتضارب المصالح بين الدول الكبرى: الاتحاد السوفياتي، وبريطانيا، والولايات المتحدة، على أبواب الحرب العالمية الثانية.
معاهدة “سعد أباد”، ظاهرها أنها “معاهدة عدم اعتداء” بين تركيا الكمالية، وإيران البهلوية، والعراق الهاشمي، ومملكة أفغانستان، التي كان على رأسها الملك محمد ظاهر شاه، آخر ملك على تلك البلاد، (حكم من 1933 الى 1973، وتوفي في العاصمة الأفغانية كابل في العام 2007)، لكنَّ مَرامَ أتاتورك منها كان توسعة دائرتها، لتُشكّل مجتمعة قوة إقليمية قوية تضع حدًّا للتدخُّل الأجنبي في شؤون تلك المنطقة.
أقنع أتاتورك شاه إيران رضا بهلوي، أن يُزوِّجَ ابنه وولي عهده، الأمير مجمد رضا من الأميرة المصرية فوزية، بهدفِ ضمِّ مصر الى “معاهدة سعد أباد”.
تحقَّقَ الزواج، ولم يتحقّق الهدف السياسي الذي كان يرمي إليه الزعيم التركي. ليس فقط لأنَّ الزعيم التركي، مُخطِّط المشروع الإقليمي المذكور، فارق الحياة قبل استكمال تصوّره لأهداف “معاهدة سعد أباد”، إنما أيضًا لوجود مفارقات وتبايُنات عديدة، منها ما هو شكلي، ومنها ما هو جوهري. ومن أبرز تلك المفارقات أن يكون محرّك المشروع رئيس جمهورية علمانية تقدُّمية راديكالية، على رأس مجموعة من الملوك يقودون أنظمة إقطاعية، شبه دينية، أو تحتضن حوزات دينية قوية ومُتنفّذة، ومُتعارضة في مذهبياتها الإسلامية.
*****
إنَّ وضعية الشاه رضا بهلوي، سواء في داخل إيران، أو في الفضاء الإقليمي، الذي خطَّطَ له مع مصطفى كمال أتاتورك، كانت هي الأصعب بين مجموعة “سعد أباد”. إذ إنَّ إيران هي الدولة الشيعية الوحيدة في تلك المجموعة، وقد تشيَّعت في الأصل مطلع القرن السادس عشر (على يد الشاه إسماعيل الصفوي)، لتتميّز عن تركيا العثمانية، دولة الخلافة الإسلامية السنيَّة، وكانت مؤسساتها وحوزاتها الدينية هي الأقوى والأفعل من الآخرين بما لا يقاس. (سوف نتوسع في عرض هذا الموضوع في حلقة مقبلة بعنوان “فرادة الوطن الشيعي”).
لكن هذه الوضعية ثابتة وراسخة، منذ مئات السنين، وليست سببًا للاضطراب الداخلي. فقد واجه الشاه رضا مشكلتَين كبيرتين: واحدة أدت الى تراجعه، والثانية أدت الى عزله.
ما من شك في أنَّ التوجُّه التقدُّمي للزعيم التركي مصطفى كمال قد جذب اهتمام شاه إيران في ذلك الوقت، ليس فقط لأنه قبل مشورته بتزويج ولي عهده من أميرة مصرية، كما مرَّ، إنما في الدرجة الأولى بسبب إعجابه بالإصلاحات التي قام بها أتاتورك في بلاده، ومنها بشكل خاص، التوجُّه العلماني. وعندما حاول أن يسير في هذا التوجُّه الكمالي، اصطدم بمعارضةٍ شديدة من رجال الدين الشيعة، فاضطرَّ الى التراجع.
شعر رضا شاه، بأنَّ خروجَ تركيا من مفهوم “الخلافة الإسلامية السنيَّة”، ألغى السبب التاريخي المُوجِب للتشيُّع الذي فرضه الشاه إسماعيل فرضًا على الإيرانيين، فأقبل على “معاهدة سعد أباد”، كعنوان لثقته بتوجُّهات مصطفى كمال في جواره التركي. إذ إن أتاتورك لم ينظر الى إيران في ذلك الوقت على أنها “دولة شيعية”، بل لكونها دولة مجاورة، لها مع تركيا مصالح مشتركة، وأهداف استراتيجية متوافقة.
أما السبب الآخر الأهم الذي أدَّى الى عزله في العام 1941، خلال الحرب العالمية الثانية، يتعلّق بالمصالح الغربية النفطية، خصوصًا المصالح البريطانية والأميركية، لأنَّ الشاه رضا كان يميل إلى ألمانيا النازية، وهو أمرٌ ما كان الغرب ليتساهل فيه، لأنَّ تلك الميول في زمن الحرب العالمية لم تكن موضعية في بلد واحد، بل شملت بلدان عدة للغرب فيها مصالح حيوية، مثل العراق حيث وقع انقلابٌ عسكري في تلك السنة، قمعه الإنكليز وأسقطوه بالقوة، وكذلك في مصر التي كان فيها عدد من الضباط المصريين ينتظرون نتيجة المعارك في ليبيا، بين الجنرال البريطاني برنارد لول مونتغُمري، والجنرال الألماني إرفين رومل، لينقلبوا على النفوذ البريطاني، ومن أولئك الضباط الفريق عزيز المصري، والبكباشي أنور السادات.
صحيح أنَّ تركيا الكمالية، في عهدة الرئيس عصمت إينونو، خليفة أتاتورك، اتخذت موقف المحايد بين المتحاربين، الحلفاء والمحور، لكنها تاريخيًا كانت حليفًا لألمانيا من أيام السلطان محمود الثاني، (في مطلع القرن التاسع عشر)، وفي أيام السلطان عبد الحميد الثاني دخلت في الحرب العالمية الأولى (1914–1918)، الى جانب ألمانيا، ودفعت الثمن الأكبر من جراء ذلك التحالف، فانهزمت وتفكّكت إمبراطوريتها العثمانية. وبالتالي يمكن القول بأنَّ المزاج الشعبي التركي في الحرب العالمية الثانية، كان إلى جانب ألمانيا النازية، على الرُغم من كون حكومته اتخذت موقف الحياد.
*****
لأسبابٍ سياسية مختلفة، نُسِجَ زواج ولي العهد الإيراني، محمد رضا شاه، من الأميرة فوزية شقيقة الملك المصري فاروق، بينها في المقام الأول، اعتباره زواجًا شيعيّاً سنيًا يخفف من الحساسيات التاريخية، ومن هذه الناحية كان حالة خاصَّة. من الجانب المصري، لم يكن الزواج متكافئ، لأنَّ شاه إيران (والد العريس) كان فلاَّحًا بسيطًا، وليس من سلالة ملكية، بل هو مجرَّد عسكري نفر، ترقَّى الى رتبة جنرال مع الوقت وقاد انقلابًا عسكريَّا في العام 1921، ونودي به ملكًا بعد أربع سنوات، بينما الأميرة فوزية من سلالة محمد علي الملكية منذ أكثر من قرن (1805). لذلك قوبل عرض الزواج بفتور ملحوظ في البداية، في البلاط المصري، لولا مخطط نسجه في رأسه علي ماهر باشا، مستشار الملك فاروق المسموع الكلمة.
أرادَ علي ماهر أن تُصبحَ مصر القطب الأول في الشرق الأوسط من خلال المُصاهرة مع البيوت الملكية في إيران، والعراق، والأردن. فوزية لشاه إيران المقبل، وشقيقتاها لملك العراق المقبل فيصل الثاني، والثالثة لنجل الملك عبد الله في شرق الأردن. لكن هذا لم يحصل، وزواج فوزية من شاه إيران المقبل لم يدم. الشاه لم يكن يتكلم العربية أو التركية، وفوزية لم تكن تتكلم الفارسية، فكان التخاطب بينهما بلغة رابعة هي الفرنسية!
كانت ثمرة هذا الزواج الوحيدة ابنة اسمها شاهناز بهلوي.
تطلقت فوزية من الشاه محمد رضا بهلوي بعد عشر سنوات من الزواج (1949)، وقبل ثلاث أو أربع سنوات فقط من الزلزال السياسي الذي ضرب عرش الشاه في إيران، وعرش سلالة محمد علي في مصر، في وقت واحد تقريبًا من بداية خمسينيات القرن العشرين. سقط الشاه في طهران (1953)، بعد سنة فقط من سقوط فاروق في القاهرة (1952).
أما الشاه، فقد وجد من يُعيده الى “عرش الطاووس” في “قصر المرمر”، في انقلابٍ مُضاد نسجته المصالح النفطية الأنكلو–أميركية، ونفَّذته أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية. أما فاروق فقد فارق الحياة منفيَّاً، عزَّ عليه الصديق أو المعين. بل إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، هي عادت ففرضت الشاه من جديد على الإيرانيين، لأنَّ رئيس حكومة الثورة الوطنية (محمد مصدق)، أمّمت شركات النفط الأجنبية، بينما قدَّمت لقائد الثورة المصرية التي أطاحت فاروق، الرئيس جمال عبد الناصر حقيبة محشوَّة بسبعة ملايين دولار، لم يأخذها لنفسه، كما توخَّت الوكالة، بل تبرَّع بها لبناء برج القاهرة!
هناكَ سببٌ آخر لنفور الأميركيين من الملك فاروق، لم يتطرّق إليه المؤرّخون لتلك الحقبة، في غمرة تركيزهم على خلاعته وفساد إدارته. ذلك أنَّ فاروق قام بمقابلة الرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت مرتين: مرة في طريق الرئيس الأميركي الى مؤتمر يالطا مع الزعيم البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفياتي جوزف ستالين، ومرة في طريق العودة على ظهر البارجة الحربية “كوينسي”، في قناة السويس. ويبدو أنَّ الملك فاروق لم يترك انطباعًا حسنًا لدى روزفلت ومعاونيه. ففي خلال توقفه في قناة السويس، كان فاروق آخر ثلاثة استقبلهم روزفلت في بارجته، بعد الملك السعودي عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وبعد إمبراطور الحبشة هيلا سيلاسي.
*****
في مجيئه الثاني الى العرش، بعد إسقاط حكومة محمد مصدق الوطنية، أصبح الشاه أسيرَ الغرب بقيادة الولايات المتحدة، وإلى جانبه، أو فوقه دولة إسرائيل. لكن الوقت لم يطل حتى انقلب عليه هؤلاء وأولهم إسرائيل. واللافت أنَّ بداية تطلعات الشاه “الاستقلالية”، كانت باتجاه مصر من بداية حكم أنور السادات.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المصالح النفطية، حيث كان الشاه أول من انتهجَ سياسةً نفطية مستقلة، عدَّلت في الميزان النفطي بين الدولة المالكة لحقول النفط والشركات الأجنبية المشغّلة لها. وقد تزامن ذلك مع انتصار الجيش المصري على الاحتلال الإسرائيلي في سيناء، في حرب تشرين (أكتوبر) من العام 1973.
استبشر الشاه خيرًا بمجيء أنور السادات إلى الحكم في مصر، لأنه كان على طرفَي نقيض مع جمال عبد الناصر، خصوصًا بعد الوحدة مع سوريا، ودوره في إسقاط النظام الملكي في العراق المجاور له، ثم بسبب سياساته الاشتراكية الراديكالية، وفوق هذا وذاك، مناصرته لثورة ظفار اليسارية ضد سلطان عُمان سعيد بن تيمور، مما اضطرَّ الشاه الى التدخل بقواته لدحر تلك الثورة في منطقة محاذية لإيران عند مضيق هرمز الحيوي (الى جانب قوة بريطانية ومستشارين إسرائيليين).
من ذلك الوقت أخذت تتوسّعُ مداخلات الشاه محمد رضا بهلوي في الشؤون العربية، حيث أقدم في الوقت ذاته على مساندة التمرُّد الكردي في شمال العراق، بقيادة الملا مصطفى البارزاني، بالتعاون مع إسرائيل أيضًا. كما إنه أقامَ علاقات وثيقة مع النظام البعثي السوري بقيادة حافظ الأسد، وأمدَّه بقروضٍ مالية، وهو النهج ذاته الذي سارت عليه الجمهورية الإسلامية في نظام “ولاية الفقيه”، من بعده، مع نظام نجله بشار الأسد، لكن على نطاق أوسع، مما انتهى بسقوطه تاليًا.
لكن العلاقة المُميزة للشاه في العالم العربي كانت مع الرئيس أنور السادات في مصر. وهذا من الأسباب الجوهرية التي جعلت السادات يستقبله في حِماه، بعد نفيه من إيران في العام 1979، وحين وفاته هناك أقام له الرئيس المصري جنازة رسمية لائقة، وتم دفنه في مدافن جامع الرفاعي في القاهرة، وهو مسجد أثري أمرت ببنائه هوشيار خانم والدة الخديوي إسماعيل في العام 1869.
يقول الباحث الأميركي-الإيراني فالي (والي) نصر في كتابه الأخير الصادر هذه السنة (2025)، عن مطبعة جامعة برينستون الأميركية، بعنوان “الاستراتيجية الإيرانية الكبرى”، إنَّ الشاه أراد النجاح لهذا النمط الجديد من السياسات العربية المعتدلة، وإنَّ الرئيس المصري والشاه الإيراني كانت لهما النظرة الاستراتيجية ذاتها، فنشأت بينهما على الفور صداقة شخصية.
لم تقتصر تلك العلاقة بين قاهرة السادات وطهران الشاه على الصداقة الشخصية، بل كانت لها في حياتهما ترجمة سياسية ملحوظة. وبين 1971 و1973، كما يقول نصر في كتابه، كان الشاه المنافح الأول عن السادات في واشنطن، دافعًا الرئيس ريتشارد نيكسون ومستشاره هنري كيسنجر للاعتراف بأهمية الفرصة النادرة التي أتاحها السادات لقيام وضع إقليمي أكثر توازنًا. ولعلَّ الشيءَ العملي الأهم الذي فعله الشاه خلال حرب 1973، بين مصر وإسرائيل، أنه “فتح المجال الجوي الإيراني أمام الطائرات السوفياتية لنقل العتاد والإمدادات العسكرية الى الجيش المصري. وعندما انتهت الحرب حثَّ الشاه الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل عقد اتفاق مع مصر”. كانت هذه أول خطوة لابتعاد الشاه عن إسرائيل، وابتعاد إسرائيل عن الشاه.
بل إن الشاه، في خطوة نادرة، هدَّد واشنطن علنًا، بأنه في حال عدم التوصل الى اتفاق بين مصر وإسرائيل، فإنَّ الحرب سوف تُستأنف، قائلًا للأميركيين، “هذه المرة سوف تكون حربنا، ولن يكونَ لأيٍّ منّا خيار آخر”، قاصدًا دخول إيران في الحرب ضد إسرائيل، ما يكفل لها مقعدًا على طاولة المفاوضات لتقرير مستقبل الشرق الأوسط!
*****
عندما أطلق الإمام روح الله الخميني، قائد الثورة الإسلامية في إيران، والمرشد الأعلى الأول للجمهورية الوليدة، لقب “الشيطان الأكبر” على الولايات المتحدة، اكتسبت إسرائيل تلقائيًا لقب “الشيطان الأصغر”. ولأنَّ هذا “الشيطان الأصغر”، هو الإبن المدلل لذاك “لشيطان الأكبر”، نشأ في أذهان كثيرين في المحيطين العربي والإسلامي انطباع بأنَّ الشيطان الصغير المُدلّل بات على المسرح العالمي، أو على الأقل في الشرق الأوسط هو الأكبر، مع أنه ليس من المنطق أن يكونَ الصغيرُ أكبر من الكبير.
لكن “المقاومة الإسلامية” في لبنان، وهي البنت المُدَلَّلة للثورة الإسلامية في إيران، حسمت هذه الجدلية بلسان قائدها السيد حسن نصر الله، بأنَّ أميركا هي التي تقودُ إسرائيل، وليس العكس، وبالتالي، فإنَّ إسرائيل مخلوقٌ هزيل، أَوهَى من بيت العنكبوت، حسب تعبيره، لولا الدعم الأميركي شبه المطلق الذي تستند إليه في حروبها التوسّعية. إذن، الكبير كبيرٌ والصغير صغيرٌ، ولا مجال للتأويل.
في ضوءِ ذلك، وبالرُغم من الشعارات الدعائية والتعبوية، خصوصًا في فترة الحرب العراقية–الإيرانية، وفي الوضع الجيوبوليتيكي الذي وجدت الثورة الإسلامية نفسها فيه، بين الاتحاد السوفياتي المتغلغل في جوارها الأفغاني، وبين الولايات المتحدة الداعمة في بداية الحرب لصدام حسين، رأت قيادة الخميني، من تحت الطاولة، أنَّ التعاطي السري مع الشيطان الأصغر هو “أهوَن الشرَّين”!
استحوذت صفقة السلاح، التي اشترت إيران بموجبها أسلحة وقطع غيار أميركية في العام 1985، على المسرح الإعلامي العالمي، بسببٍ من كونها شكَّلت فضيحة لإدارة الرئيس رونالد ريغان، في ما سُمِّي “فضيحة إيران–كونترا”، حيث قامت الاستخبارات الأميركية باستخدام الأموال المتحصِّلة من إيران، بموجب تلك الصفقة، لتمويل العمليات المضادة للشيوعين في نيكاراغوا.
لكن تبيّن لاحقًا أنَّ سكة السلاح من إسرائيل إلى إيران انفتحت قبل ذلك التاريخ بسنوات، وقُدِّرت قيمة السلاح الذي اشترته إيران من إسرائيل قبل العام 1985، بأكثر من 100 مليون دولار. وحسب المصادر الغربية، فإنَّ سفن الشحن الدانماركية التي استأجرتها الحكومة الإسرائيلية، وتلك التي استأجرها تجار السلاح، قد قامت قبل 1985 بنحو 600 رحلة محمّلة بالأسلحة الأميركية الصنع، وقطع الغيار للطائرات الأميركية التي اشترتها طهران في زمن الشاه، من الموانئ الإسرائيلية عبر الخليج الى ميناء بندر عباس الإيراني. وتدَّعي تلك المصادر أنَّ قطع الغيار تلك هي التي أبقت على سلاح الجو الإيراني شغَّالًا خلال الحرب مع العراق.
ظهرت أيضًا إشارات إسرائيلية مبكرة على ذلك التعاون مع إيران خلال الحرب، منها تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي المعروف آرييل شارون في العام 1982، (فترة احتلال الجيش الإسرائيلي للبنان حتى العاصمة بيروت)، قال فيه إنَّ إسرائيل سوف تُواصِلُ تزويد إيران بالسلاح بالرُغم من المعارضة الأميركية. هذا مثالٌ آخر على تحدّي “الشيطان الأصغر” لمربيه “الشيطان الأكبر”!
في التحليلات الإسرائيلية للخطابات المتشدّدة التي كان يلقيها الإمام الخميني ضدَّ إسرائيل، أنَّ تلك المواقف العالية النبرة، هي “من قبل الدعاية التعبوية العاطفية”، أكثر منها مواقف مبدئية في السياسة الخارجية. وظلَّ بعضُ الدوائر الإسرائيلية، خلال مرحلة الإمام الخميني، حتى وفاته في العام 1989، يعتبرُ إيران “حليفًا مُحتَمَلًا” حتى عندما اعتبر إسرائيل “غدّةً سرطانية” يجب اقتلاعها!
بل إنَّ وسائل إعلام أميركية، في العام 1989، (سنة وفاة الإمام الخميني، وبعد سنة من توقّف الحرب مع العراق)، كشفت أنَّ إسرائيل اشترت من إيران ما قيمته 36 مليون دولار من النفط، لقاء إطلاق سراح ثلاثة من الجنود الإسرائيليين كانوا محتجزين في لبنان.
*****
دوائر عديدة في الغرب، خصوصًا تلك التي كانت تسعِّر نار الحرب بين العراق والجمهورية الإسلامية في إيران، اعتبرت أنَّ التوجُّهَ العام للدولة الإيرانية، في الشأن الإقليمي، من المُستبعد أن يتغيَّرَ تغيُّرًا جذريًا عمّا كان عليه في أيام الشاه. أي إنَّ ما حدث هو استبدالٌ لتاج الشاه بعمامة الإمام… “إمام الأئمة” في مقام الشاهنشاه، “ملك الملوك”!
هناك أدلّةٌ ظرفية عديدة تدلُّ على تلاقي المصالح بين إيران، من جهة، والغرب وإسرائيل، من جهة ثانية، خصوصًا في الجوار الجغرافي المباشر لإيران. أول تلك التطوّرات إقدام إسرائيل في السابع من حزيران (يونيو) 1981، بعد أقل من سنة على اندلاع الحرب مع العراق، بتدمير المفاعل النووي العراقي. هذا التطوُّر كان لمصلحة إيران، لأنه شكل ضربة موجعة للنظام العراقي.
من تلك الأدلة الظرفية أيضًا، أنَّ الرئيس الإيراني محمد خاتمي، بعد تفجيرات نيويورك يوم 11 أيلول (سبتمبر) 2001، بعث ببرقية استنكار وتعزية للرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، فاتحًا بذلك باب التعاون مع الولايات المتحدة في منطقة الاحتكاك المباشر، والمحتقن بين إيران وأفغانستان، الى درجة التهديد بحرب بينهما. ويمكن القول بأنَّ التوجُّه الأميركي، في بداية عهد الرئيس جورج دبليو بوش، والمحافظين الجدد الداعمين له في واشنطن (ومعظمهم من مؤيدي إسرائيل)، نحو احتلال أفغانستان وإسقاط حكم طالبان فيها، ثم احتلال العراق وإسقاط نظام صدام حسين أيضًا، كان فيه شبه تطابق تام مع المصالح الإيرانية في ذلك الوقت.
لقد كان تقدُّم حركة طالبان في أفغانستان قبل ذلك، دافعًا لإيران نحو تأييد ودعم “تحالف الشمال” بقيادة أحمد شاه مسعود، حصوصًا بعد إقدام مقاتلي طالبان على احتجاز وقتل مجموعة من الديبلوماسيين الإعلاميين الإيرانيين، قيل إن عددهم 11 شخصًا، مما حمل الحكومة الإيرانية على حشد قوات على الحدود الأفغانية. لكن سرعان ما قامت حركة طالبان باغتيال أحمد شاه مسعود في مدينة مزاري شريف الشمالية، بيد إرهابي تخفَّى بصفة صحافي، لأن التخلص منه أنهى “تحالف الشمال” وأتاح لطالبان السيطرة على كامل أفغانستان.
من الواضح أنَّ الجمهورية الإسلامية في إيران كانت لها مصلحة في للتعاطي مع الولايات المتحدة بشأن تقرير مستقبل أفغانستان، وبالفعل أعطيت مقعدًا إلى جانب الولايات المتحدة في مؤتمر بون في العام 2001 لتقرير مستقبل أفغانستان. مرة جديدة تُثبتُ مقولة إنه ليست للدول صداقات أو عداوات دائمة، إنما لها مصالح دائمة تُملي الصداقات والعداوات!
(الحلقة المقبلة: “التوسُّعيَّة الإيرانية: نمطٌ ثابتٌ ونهجٌ مُتَغَيِّر”)
إشكالية السلم والحرب بين إيران والغرب (3)
مات الشاه…عاش الإمام
مات شاه إيران محمد رضا بهلوي، كما عاش، وحيداً لا عزاء له.
أُخفي مرضه بالسرطان عنه، وعن الإيرانيين، وعن بقية العالم، ظناً من مساعديه المقربين، ربما، بأن كَشْفَ سرطانه الجسدي، يُفاقم السرطان السياسي في البلاد. وهناك في التحليلات الطبية، من قال إن التكتم على مرض الشاه، كان من العوامل الأساسية التي أدَّت الى تسريع موته، لأنه لم يحصل على العلاج الصحيح في وقت أبكر.
تلك السريَّة، لأسباب سياسية، عجَّلت في وفاة الشاه وهو في الستين من العمر، ويقال إن التقارير الطبية الأولية في ربيع عام 1974، خصوصاً منها تقارير الأطباء الأجانب، قد تم تَحريفُها لإخفاء المرض عن الشاه نفسه، بحيث أن الشاه لم يعلم بحقيقة مرضه إلاَّ في عام 1978، بعد فوات الأوان طبيَّاً وسياسياً.
قبل وفاته بخمسة أشهر، وتحديداً يوم 17 كانون الثاني (يناير) من عام 1980، أجرى الصحافي البريطاني الراحل السير دايفيد فروست مقابلة أخيرة مع الشاه، اعترف له فيها “ملك الملوك” بعزلته، على النحو التالي:
فروست: أن تكون “الشاهنشاه”، لا بد أنك كنت في عزلة.
الشاه: نعم، إنها حالة خاصة، إذا جاز التعبير.
فروست: بأي معنى هي حالة خاصة؟
الشاه: أقصد، كما قلت أنت، “ملك الملوك”.
فروست: تعني، أنك كنت وحيداً لأنه ليس هناك من هو أرفع منك لترجع اليه؟
الشاه: لا… هنالك الله دائماً.
إن إدخال “الله” في معادلات السلطة، إن من الشاه، أو من خصمه الإمام العنيد، له وجهان للتفسير في هذه الحالة:
تفسير المتنبي القائل: وما يدٌ إلاَّ يدُ الله فوقها / وما من ظالمٍ إلاَّ ويُبلى بأظلمِ
وتفسير زهير القائل: وما من يدٍ إلاَّ يدُ الله فوقها / ومن شيم المولى التلطفُ بالعبدِ
يدٌ تمتدُّ بالقسوة والشدة، ويدٌ تمتدُّ باللطف واللين. أما الشاه فقد بُلي بأعظم ولم يتلطَّف به أحد!
***
يمكن القول من خلال تلك المقابلة إن الشاه وجد قاسماً مشتركاً له مع الإمام الخميني، خصوصاً أنه أعلن في تلك المقابلة أنه كان ينوي تشكيل حكومة جامعة لكل أطياف المجتمع الإيراني من غير استثناء (ربما أراد أن يقول إن حكومته تلك تتسع للخميني أيضاً). لكنه انتقد الخميني لكونه يرى أن تاريخ إيران ابتدأ به، وكل ما قبله لا قيمة له، ولا يعنيه. وقال أيضاً إنه هو يعترف بما كانت عليه إيران قبل مجيء والده الى العرش، ويعرف كيف كانت خلال حكمه، وكيف تطورت الأمور خلال مجيئه الأول بعد أبيه، ومجيئه الثاني بعد الدكتور محمد مصدق.
ما لم يقله الشاه ليس أٌقل أهمية. هو لم يقل إن هناك نقطة مشتركة بين الشاه الراحل والإمام القائم، غير سلطة الله العليا، فوق الملوك والأئمة، هي العداء للاتحاد السوفياتي والشيوعية، مما جعل سياسة إيران الخارجية في مدار شبه حتمي الى جانب الغرب. لكن مرجعية “الله” هي الأنسب، لأن الله رحمته واسعة، تتيح لمن شاء أن يستخدمها في أي أمر، خصوصاً في السياسة والحكم.
***
كان إخفاء مرض الشاه، عنه وعن الناس، فعلاً سياسياً متعمداً، أعطى نتائج عكسية على الشاه وعلى نظامه. لكن مرضه لم يبقَ سريِّاً تماماً، لأن أجهزة استخبارات الدول الغربية علمت به تباعاً، بدءاً من الفرنسيين، لأن الأطباء الفرنسيين كانوا أول من عالجوا الشاه في طهران، فعلمت بذلك الاستخبارات الفرنسية الخارجية التي كان يقودها ألكسندر دو مارانش في عهد الرئيس جيسكار ديتان.
ثم بعد ذلك بفترة من الزمن غير طويلة، علمت به أجهزة الاستخبارات البريطانية والأميركية، مما استدعى عقد قمة متأخرة بين قادة الغرب الأربعة في ذلك الوقت (4 – 7 كانون الثاني / يناير 1979)، ضمَّت الرئيس الأميركي جيمي كارتر، الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان، رئيس الحكومة العمالية البريطانية جايمس كالاهان، والمستشار الألماني هلموت شميدت، التأمت في جزيرة غواديلوب الكاريبية قبل أيام قليلة من مقابلة دايفيد فروست مع الشاه في طهران. وقد رشح يومها أن غاية المؤتمر بحث إمكانية إنقاذ نظام الشاه في اللحظة الأخيرة، وربما كان هذا من قبيل التضليل، لأن مداولات المؤتمر تشير الى أنهم قدَّروا، بما لديهم من معلومات، أن إنقاذ الشاه بات مستحيلاً، على الأقل بسبب مرضه. كما أن موضوع إيران والشاه لم يكن الموضوع الوحيد على بساط البحث، بل كان أهمها مسألة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية مع الاتحاد السوفياتي.
تبين لاحقاً أن قادة الغرب الأربعة توصلوا في مؤتمر غواديلوب الى قرار بأن البلدان الغربية لا يجوز أن تقطع علاقاتها مع حكومة إيران الجديدة، واتفقوا على طريقة تسمح لهم بإقامة علاقات طيبة، وتعاون اقتصادي مثمر، مع النظام الجديد.
أهمية مؤتمر غواديلوب، أنه أول مؤتمر لقادة الغرب لوحدهم منذ الحرب العالمية الثانية، لبحث قضايا استراتيجية عالمية النطاق. واللافت أيضاً أن فرنسا هي التي نظَّمت المؤتمر، في وقت كان الإمام الخميني لاجئاً فيها. واللافت أكثر أن الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان أعلن أمام نظرائه في المؤتمر، أنه لا يُصدِّق بأن الشاه لم يعد له مكان ٌ في إيران!
كذلك اعتبر ديستان أن تقارير سفيره في طهران (فرانسوا بيديل) عن حتميَّة مغادرة الشاه لبلاده “نذير شؤم”، مع أن هذا السفير بالذات هو الذي نسَّق عودة الخميني الى طهران، بما في ذلك استئجار الطائرة الفرنسية التي أقلته مع مرافقيه في تلك الرحلة.
لكن يبدو أن الرئيس الفرنسي كان بالفعل مشوشاً من تقارير سفيره في طهران، فأوفد الى العاصمة الإيرانية مبعوثاً خاصاً، هو ميشال بونياتوفسكي، الذي تربطه صداقة مع الشاه. والثابت أن جيسكار ديستان دعا الى المؤتمر الرباعي في غواديلوب بناء لتحليله المقارن بين تقارير السفير وتقرير المبعوث الخاص.
الفارق بين تقارير السفيربيديل، وتقرير المبعوث بونياتوفسكي، أن الأول نقل معايناته عما يجري على أرض الواقع في طهران، بينما تضمن تقرير بونياتوفسكي وجهة نظر الشاه، وهذا وجه فرادته.
قال الشاه لمبعوث ديستان:
“تركوني وحيداً على المسرح السياسي. تخلوا عني (يقصد زعماء الغرب). إنني أسأل نفسي ما إذا كانوا قد أداروا ظهورهم لي في السياسة الخارجية أيضاً. ألا يعلمون أنني تجاوزت نقطة اللارجوع؟ هل قرروا التخلي عني؟ إذا كان هذا هو الحال، فإنه من الأفضل أن تبلغني ذلك الآن وفوراً، لكي أتخذ القرارات اللازمة وأبني على الشيء مقتضاه. أبلغني الأميركيون أنهم معي، ويدعمونني في كل الأحوال، إنما لدي شكوكٌ حولَ هذا الزعم”.
كان حدس الشاه في محله، فقد أداروا له ظهرهم في السياسة الخارجية أيضاً، لأن مؤتمر غواديلوب بحث مطولاً في الدخول مع الاتحاد السوفياتي بمحادثات جديدة للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية
(سولت 2) SALT II 1979
من الواضح أن كلام الشاه هذا يبدو مشوَّشاً، ومنقطعاً عن الواقع. وربما كان ذلك تحت وطأة تفاقم المرض في جسده، لأن هناك تقارير طبيَّة أفادت فيما بعد، بأن الدواء الذي وصفه له الأطباء في البداية لوقف تفشي السرطان، له مفعول سلبي وأعراض جانبية، مثل الغثيان، والتشوش الذهني، وتعكُّر المزاج.
مع ذلك، شجَّع الرئيس الفرنسي زعماء الغرب على دعم الشاه، معتبراً أن سقوط الشاه من شأنه أن يحفِّزَ التدخل السوفياتي في إيران، وهو ما يجب على قادة الغرب أن يأخذوه في الحسبان، مفصحاً لهم بأن الشاه طلب منه اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة التدخل السوفياتي. وأعلن أمامهم كذلك، بأن عليهم أن يوجهوا تحذيراً لموسكو، لكي يُشعروا السوفيات بجدية قلقهم من الوضع في إيران.
نقل ديستان الى قادة الغرب الثلاثة الآخرين، ما تبلَّغه من مبعوثه بونياتوفسكي، بأن الشاه يجد نفسه وحيداً في الساحة، وقال لهم: “إن الشاه هو أيضاً الوحيد القادر على مواجهة الحركة الدينية”.
***
الدليل على أن جيسكار ديستان كان مشوَّشاً بين تقارير سفيره وتقرير مبعوثه الخاص، أنه استهل مؤتمر غواديلوب بالطلب الى رئيس الحكومة البريطانية، جايمس كالاهان، بأن يقدم الى المؤتمر عرضاً بآخر المستجدات، حول وضع الشاه وإيران، كما استقاها من سفيره وأجهزته، فقال كالاهان في الخلاصة التي قدَّمها:
“الشاه لم يعد قادراً على ضبط الوضع، وليس من بديل حقيقي له (بالنسبة الى الغرب). الشخصيات السياسية الأخرى محدودة القدرة والهيبة. وفوق ذلك فإن معظمهم كانت له ارتباطات مع نظام الشاه، ومنهم من كان موالياً له تماماً”.
ثم تساءل كالاهان ما إذا كان بمقدور الجيش أن يلعبَ دوراً انتقالياً، وبادر الى تقديم الجواب بالنفي، قائلاً:
“لا. لأن الجيش يفتقر الى الخبرة السياسية، وقادته ولاؤهم للشاه”.
الكلمة الأخيرة، والفاصلة، كانت للرئيس الأميركي جيمي كارتر الذي قال:
“إن الوضع في إيران قد تغيَّرَ كُلِّياً. الشاه لا يستطيع أن يبقى بعد الآن أبداً. الشعب الإيراني لم يعد يريده. ليس هناك أي رجل دولة مقتدر في إيران يرغب في التعاون معه. لكن علينا ألاَّ نقلق. القوات العسكرية جاهزة، ويستطيعون الاستيلاء على السلطة. معظم القادة العسكريين الإيرانيين درسوا في مدارسنا، وهم يعرفون قادتنا العسكريين جيداُ. إنهم ينادون بعضهم البعض بأسمائهم الأولى”.
آخر ملحق عسكري إسرائيلي في طهران، اسحق سيغيف، الذي كانت تربطه علاقة وثيقة مع الرئيس كارتر وإدارته، قال إن الرئيس الأميركي، عندما تخلى عن الشاه، كان يعتقد بأن ذلك سوف يساعد على إقامة حكم ديموقراطي في إيران. وقد وصف سيغيف الموقف الأميركي في حينه بأنه “ساذج”، لتصوره بأن كون الخميني معادياً للشيوعية، فإنه سوف يراعي المصالح الأميركية!
***
في تلك المرحلة، تداخلت عوامل سريَّة، واستخباراتية عديدة، حول الواقع الإيراني، والمواقف الضِمْنيَّة غير المعلنة للدول الغربية الرئيسية. فعلى سبيل المثال، ادعى ألكسندر دو مارانش (مدير الاستخبارات الفرنسية الخارجية) لاحقاً، بأنه حذَّرَ الشاه بأن الرئيس الأميركي جيمي كارتر مصممٌ على عزله. وقال دو مارانش، متذكراً، إنه أبلغ أسماء الأميركيين الذين “نيطت بهم مسؤولية الإشراف على إخراجه واستبداله”. وقال أيضاً، إنه أبلغ الشاه عن مشاركته في اجتماع موضوعه كيفية إدارة مغادرة الشاه، وتقرير من هي الجهة التي سوف تحلُّ محلَّه.
هذا التوجه الأميركي أكده أيضا الجنرال ويسلي كلارك، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، بقوله في مقابلة معه، إن الرئيس كارتر أوفد الجنرال الجوي روبرت هوايزر الى طهران مطلع كانون الثاني (يناير) من عام 1979، لإقناع قادة الجيش الإيراني بعدم التدخل لدعم الشاه.
وقال الجنرال كلارك أيضاً، إن الجنرالات الإيرانيين حذروا الأميركيين بوجوب التروِّي، لأنهم “يلعبون بالنار”، وبأنهم بذلك يسمحون بعودة الخميني. لكن الجنرال هوايزر أقنع زملاءه الإيرانيين بالتراجع، واستطاع منعهم من التدخل لمدة 60 يوماً (ما يعني أن القادة العسكريين في إيران كانوا عازمين على القيام بانقلاب عسكري، كما كان يتوجس الخميني المنتظر في فرنسا). الرئيس كارتر نفسه أكد ذلك بقوله: “استطاع هوايزر أن يمنع الجنرالات الإيرانيين من محاولة الانقلاب”.
فماذا عن المقلب السوفياتي، وكيف عرفت موسكو بالنوايا الغربية في إيران؟
الضابط السابق في الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي)، فلاديمير كوزيكين في مذكراته عن عمله في طهران أيام الشاه، وفي السنوات الأولى من عهد الجمهورية الإسلامية، اتهم إدارة كارتر بتسهيل قيام الجمهورية الإسلامية، وقال إن المحللين في الاستخبارات السوفياتية، وصلوا الى قناعة بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كانت تدعم الخميني، بما في ذلك تشجيع الإيرانيين الأميركيين على دعم الثورة الإسلامية.
إذا كان التحليل الاستخباراتي السوفياتي صحيحاً، ومن المرجح أن يكون كذلك، فإنه يُفسر قرار القيادة السوفياتية في عام 1979 بإرسال جيشها الى أفغانستان لدعم الحكم الشيوعي فيها بقيادة نجيب الله، خوفاً من تمدُّد الحركات الإسلامية المتطرفة الى الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي وزعزعة استقرارها.
***
من أبرز الإيرانيين الأميركيين الذين كانت للأجهزة الأميركية اتصالات سريَّة معهم، إبراهيم يزدي (يحمل أيضاً الجنسية الأميركية)، وقدعيَّنه الخميني وزيراً للخارجية في أول حكومة بعد سقوط الشاه برئاسة مهدي بازركان. وكان أول نشاط له على المسرح العالمي بعد تسلمه وزارة الخارجية، حضوره في شهر أيلول (سبتمبر) من عام 1979، مؤتمر قمة دول عدم الانحياز التي انعقدت في العاصمة الكوبية هافانا، حيث أبلغ وزير الخارجية العراقي سعدون حمادي رغبته في مقابلة الرئيس صدام حسين الذي كان يرأس الوفد العراقي. لكن الرئيس العراقي تردد في البداية، ثم عاد فوافق على مقابلة الوزير الإيراني، بناءً على مداخلة من جانب سفيره لدى الأمم المتحدة، الراحل صلاح عمر العلي، الذي قال لي، عندما زرته في نيويورك ربيع عام 1981، إنه سأل صدام: ما المانع من أن تستمع اليه وتعرف ما عنده أو ما وراءه؟ فوافق.
المرجح أن الأميركيين أبلغوه بأن صدام حسين يستعد لشن حرب قريبة على إيران، قبل أن يستتب نظامها الجديد، فكلفه الخميني بأن يحاول طمأنة الرئيس العراقي كسباً للوقت. لكن صدام حسين كان مصمماً على الحرب، ولا أحد يستطيع ثنيه عنها، وهذا ما أكده لي أيضاً صلاح عمر العلي.
الشخص الآخر المقرب جداً من الخميني، وكان ساعده الأيمن في باريس، صادق قطب زاده، الذي تولى الشؤون الإعلامية للإمام الخميني منذ أن كان مرافقه في فرنسا، كانت له هو الآخر اتصالات مع إدارة كارتر. وأثناء وجوده في باريس جاء قطب زاده الى لندن، وقام بزيارة لنا في مجلة “الدستور” اللبنانية الصادرة من العاصمة البريطانية، وكنت يومها نائباً لرئيس تحريرها. وقد استغربت تلك الزيارة، لأن مجلة “الدستور” كانت لها ميول عراقية معروفة، قبل رئاسة صدام حسين وبعدها، وفي بيروت كما في باريس ولندن لاحقاً.
في الاجتماع مع صاحب المجلة ورئيس تحريرها علي بلوط، أبلغنا قطب زاده أن الثورة الإيرانية سوف تعلن انتصارها قريباً، وسيعود الإمام الخميني الى طهران لقيادة البلاد، وأن النظام الجديد يريد أن يفتح صفحة جديدة مع الدول العربية، مشيراً الى أهمية التفات الإعلام العربي بإيجابية الى التحوُّل المنتظر. وبعد رجوعه الى إيران تولى إدارة الإذاعة والتلفزيون، ثم عُيِّن وزيراً للخارجية، وفي السادس من نيسان (أبريل) من عام 1982 جرى اعتقاله بتهمة الاشتراك بمؤامرة انقلابية للإطاحة بالنظام، فحوكم وأدين وأعدم. وفي غالب الظن، كانت التهم الموجهة اليه ملفقة، أو مبالغاً فيها، وربما كان أن الخميني خلال الحرب مع العراق، أراد أن ينهج منهجاً يقتضي تصفية بعض معاونيه السابقين، من الذين يعرف ارتباطهم السابق بأجهزة أجنبية.
لكن تهمة اتصال قطب زاده بالاستخبارات الأميركية، قد لا تكون بعيدة عن الواقع، ومن المستبعد أن يكون قد أجرى تلك الاتصالات من غير علم الخميني، أو من وراء ظهره. وما يثير الحيرة في هذا الموضوع، أن رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية الداخلية السابق إيف بونيه DST، قرأ أمام قادة الغرب في مؤتمر غواديلوب (حيث سبق له أن كان حاكماً لها)، رسالة بالفاكس من قطب زاده الى الرؤساء الأربعة شكرهم فيها على دعمهم للمعارضة ضد الشاه. وبعد عزل الشاه، التقى قطب زاده سراً مع رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض هاملتون جوردان، الذي ادعى بأن قطب زاده فاتحه بإمكانية أن تقوم وكالة الاستخبارات المركزية باغتيال الشاه في منفاه الأولي في جمهورية بناما!
***
بعد خروج الشاه من إيران في “إجازة”، كما سمَّاها كارتر، وجد صعوبة في إيجاد مكان يقضي فيه تلك الإجازة، وقد اشتد عليه المرض، فلجأ مؤقتاً الى بناما، ثم الى المكسيك، على مقربة من الولايات المتحدة ظناًَّ منه، ربما، بأن كارتر سوف يأويه، كلاجئ سياسي، لكن الرئيس الأميركي لم يكن في هذا الوارد. ثم عاد كارتر فقبل بإدخاله الى الولايات المتحدة مؤقتاً للعلاج، بعد ضغوط شديدة مورست عليه من قبل هنري كيسنجر ودايفيد روكفلر.
وجد الأطباء أن حالة الشاه لا شفاء منها، وأن أيامه معدودة، فطلبت منه السلطات الأميركية أن يجد مكاناً آخر، فاختار أن يموت في مصر، وقبل أنور السادات استقباله. ولعلاقة الشاه الراحل بالرئيس المصري أنور السادات حيثيات وجيهة جعلته يتعامل معه بعد سقوطه تعاملاً لائقاً، كما سيلي في الحلقة المقبلة.
بخروج الشاه في “إجازته” الأخيرة، خلت الساحة للإمام الخميني، فعاد الى طهران على متن طائرة فرنسية رافعاً راية النصر المؤزر، ومعه راية الجمهورية الإسلامية.
مات الشاه … عاش الإمام.
وانفتحت صفحة جديدة في تاريخ إيران والشرق الأوسط، فكانت، مع الأسف، صفحة دامية من الحروب المتواصلة حتى الساعة.
(الحلقة المقبلة: أهون الشرين… “الشيطان الأصغر”)
إشكالية السلم والحرب بين إيران والغرب (2)
آيةُ الله والشيطان
سليمان الفرزلي*
لم يُوفَّق أحدٌ من القادة السياسيين حول العالم في توصيف الولايات المتحدة بكلمتين، كما وُفِّق آية الله الخميني، قائد الثورة الإسلامية في إيران، ومؤسس النظام الجمهوري في تلك البلاد التي لم تعرف سوى حكم الطغاة، والملوك، والإقطاع، لقرون عديدة. فقد وصفها الخميني بأنها “الشيطان الأكبر”، وأهمية هذا الوصف أنه يحمل معاني دينية، باعتبار أن الشيطان، كبيراً كان أم صغيراً، ما هو إلاَّ العدو الأول لله والبشر. ترك الخميني لقب “الشيطان الأصغر” لإسرائيل باعتبارها، في نظره، محميَّة أميركية. لكن الباحث الإيراني عباس أمانات يقول في كتابه الصادر في لندن (توريس) عام 2009، إن عبارة “الشيطان الأكبر”، المسجلة حصراً باسم الإمام الخميني، استعارها الإمام من أدبيات الدعاية التي نادى بها الشيوعيون في مطلع خمسينيات القرن الماضي!
قبل الخميني أطلق زعماء في العالم توصيفات لأميركا، لها صفة كاريكاتورية، أبرزها وأبقاها وصف الزعيم الصيني ماو تسي تونغ للولايات المتحدة بأنها “نمرٌ من ورق”. طبعاً، ماو تسي تونغ استحضر صورة “النمر”، كحيوان مفترس، ليعطي انطباعاً بأن البشرية في ظل الهيمنة الأميركية تعيش في غابة، وقوانين الغابة ليست بحاجة الى برهان، أبسطها أن القوي يأكل الضعيف، أو “المستضعف”، بلغة الإمام الخميني. لم يخطر للزعيم الصيني أي توصيف ديني، لأنه كان من كبار القادة الشيوعيين الثوريين في العالم، الذين يعتقدون بأن “الدين هو أفيون الشعوب”، وبالتالي فهو سلاحٌ في أيدي المستكبرين!
لكن وصف الخميني للولايات المتحدة بأنها “الشيطان الأكبر” هو أيضاً وصفٌ حمَّالُ أوجهٍ، منها وجهٌ يُشبه الدعابة طلباً للود، كما يصف الأهل أولادهم، تحبُّباً، بأنهم “شياطين”. ويبدو، من الوثائق الأميركية السرية، التي نُشرت جزئياً في عام 2008، ومعظمها ما زال تحت غطاء السرية الى اليوم، كان أكثر تودُّداً الى الشيطان الأكبر مما هو ظاهر للعيان، وأن اتصالاته مع واشنطن قديمة العهد تعود الى ستينات القرن الماضي.
***
قبل أسبوعين من اغتيال الرئيس الأميركي جون كنيدي في دالاس بولاية تكساس، يوم 22 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1963، بعث الإمام الخميني برسالة ودية الى كنيدي، في وقت كان فيه الإمام معتقلاً بالإقامة الجبرية في إيران، بسبب تصريحات عنيفة له ناقدة للشاه. في تلك الأيام كان الشاه محمد رضا بهلوي يتبرَّم من ضغوط إدارة كنيدي عليه للقيام بإصلاحات جذرية، فقد كان الرئيس الأميركي المغدور يعتقد بأنها تسعف في تثبيت استقرار الأوضاع الداخلية في إيران والشرق الأوسط. وقد قام الشاه بالفعل بإطلاق ما سُمِّيَ في حينه “الثورة البيضاء”، من أبرز ملامحها الإصلاح الزراعي، الذي نادى بتوزيع أراضي كبار المالكين على صغار الفلاحين. على أن تلك الخطوة لم تكن، في غالب الظن، جديَّة أو جذرية، بقدر ما كانت محاولة تجميلية. لكن الشيء الذي ترك بصمة فعلية في سجلِّ تلك الإصلاحات، منح المرأة الإيرانية حق الانتخاب والمشاركة في الحياة السياسية. تلك المرحلة شهدت بداية ظهور الخميني على المسرح السياسي الإيراني كمعارض عنيد للشاه، مما أدى الى فرض الإقامة الجبرية عليه لأول مرة.
أطلق الشاه ثورته البيضاء المزعومة، وسط اضطرابات عمالية وشعبية، قمعها الجيش في أيام قليلة فكانت تلك فرصة الإمام الخميني لإطلاق عنان لسانه الحاد ضد “ملك الملوك”. في ذلك الوقت بعث الخميني برسالته الوديَّة السريَّة الى الرئيس جون كنيدي، قبل أسبوعين من اغتياله في مدينة دالاس بولاية تكساس. وليس معلوماً الى اليوم ما إذا كان كنيدي قد أتيح له أن يقرأ رسالة الخميني قبل اغتياله بأيام، لكن وكالة الاستخبارات المركزية نشرت مؤخراً مقاطع منها وأبقت النص الكامل تحت غطاء السرية.
***
إن الجزء الذي أفرجت عنه وكالة الاستخبارات المركزية من رسالة الخميني الى الرئيس كنيدي، ينبىء بحالة من التضعضع في طهران وفي واشنطن، بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية في داخل إيران، والشدة المفرطة والإعدامات الفورية التي قامت بها الأجهزة الأمنية، اختلطت بتوجه الشاه الى مغازلة الاتحاد السوفياتي، بدعوته الرئيس السوفياتي ليونيد بريجنيف وزوجته لزيارة إيران حيث لقي ترحيباً استثنائياً. ومما أعطى زيارة بريجنيف تلك مزيداً من الوزن، أنها استمرت لمدة أسبوع كامل سمحت له بأن يزور مناطق عديدة في إيران.
إن مجرد نظرة كرونوليجية الى تلك المرحلة تلقي ضوءاً كاشفاً على كثافة واختلاط الأمور في إيران والعالم خلال أيام معدودة فقط، يمكن تبسيطها على النحو التالي:
أطلق الشاه ثورته البيضاء في أواخر عام 1963، وخلال أيام فقط اندلعت الاضطرابات الشعبية التي واجهتها السلطة بقمع شديد للغاية. كان الإمام الخميني وقتئذٍ مبتدئاً في العمل السياسي، فأطلق خطابات شديدة اللهجة ضد الشاه مما جعل السلطة تعتقله بالإقامة الجبرية ومنعه من الكلام. فور حجزه في الإقامة الجبرية بعث الخميني برسالته السريَّة الى الرئيس كنيدي، على الأرجح في 8 أو 9 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1963، قبل أسبوعين من اغتيال الرئيس الأميركي. ثم جاء الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف في زيارته، المعلن مسبقاً أنها بغاية توقيع “اتفاقية حسن جوار” مع إيران. استمرت زيارة بريجنيف من 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1963 الى 23 منه، أي أن اغتيال كنيدي في دالاس جرى أثناء وجود بريجنيف في إيران، قبل يوم واحد فقط من انتهاء زيارته.
يُفهم من مقطع الرسالة الذي أفرجت عنه وكالة الاستخبارات المركزية، أن “الطحشة” السوفياتية على إيران أثارت حفيظة الخميني، بقدر ما أثارت قلق الأميركيين. فقد أفادت تلك المقاطع المفرج عنها، أن الإمام الخميني أبلغ الرئيس كنيدي أنه “ليست له خصومة مع الولايات المتحدة”، وأنه لا يعارض المصالح الأميركية في إيران، (حسب تحليل لوكالة الاستخبارات المركزية بعنوان “الإسلام في إيران” نُشر في عام 2008). وبيت القصيد في المقاطع المفرج عنها تلك، تأكيد الخميني في رسالته أنه، على عكس ما يُشاع، يعتبر الوجود الأميركي في إيران “ضرورياً لمواجهة النفوذ السوفياتي والنفوذ البريطاني”.
إن إقران الخميني النفوذ السوفياتي مع النفوذ البريطاني لافت للنظر، وكأنه اعتبرهما طرفاً واحداً. لكن ذلك لا يستدعي التفسير المعقد، بقدر ما فيه استحضارٌ لمرحلة تاريخية سابقة، كان فيه النفوذان السوفياتي والبريطاني ثقيلان على صدور الإيرانيين. ففي العهد القيصري في روسيا، خلال الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918)، قامت جيوش روسية وبريطانية مشتركة باحتلال إيران، وكانت القوات الروسية بقيادة الجنرال نيكولاي باراتوف، والقوات البريطانية بقيادة البريغادير بيرسي سايكس، حيث تواعد القائدان الروسي والبريطاني على التلاقي في مدينة إصفهان. الجنرال الروسي انطلق من الحدود العثمانية الجبلية، حيث دحر الجيش الثالث العثماني بقيادة أنور باشا، وأنزل به هزيمة ساحقة. أما البريغادير البريطاني فقد زحف من جنوب العراق بجيش ضم جنوداً من مختلف أنحاء الإمبراطورية البريطانية.
كذلك في الحرب العالمية الثانية، احتلت الجيوش السوفياتية مناطق واسعة من شمال إيران، وفي ظل الوجود السوفياتي هناك، احتلت القوات السوفياتية منطقة أذربيجان كلها، وأقامت أول دولة كردية، أطلق عليها اسم “جمهورية مهاباد”، لم تدم طويلاً، وكان رئيسها الزعيم الكردي العراقي الملا مصطفى البارزاني لأقل من سنة، فسقطت بمجرد انسحاب القوات السوفياتية، وغادر البارزاني جمهوريته منسحباً مع تلك القوات الى موسكو، حيث بقي هناك حتى ثورة 14 تموز العراقية التي أطاحت النظام الملكي الهاشمي، وأعلنت العراق جمهورية، في 14 تموز (يوليو) من عام 1958. وبعد عودة البارزاني من موسكو الى بغداد، مرحباً به من قبل النظام الجمهوري الجديد، لم يحصل اتفاق بينه وبين الحكومة العراقية، فأعلن التمرد عليها مطالباً بحكم ذاتي للأكراد في شمال العراق.
أما بالنسبة الى النفوذ البريطاني الذي أشار اليه الخميني في رسالته الى الرئيس كنيدي، فقد نشأ قبل زمان طويل يعود الى أيام الوجود البريطاني في الهند، فكان حاضراً خلال حكم الدولة القجارية، وخليفتها الدولة البهلوية، وصولاً الى الحرب العالمية الثانية، وما بعدها، وبالشراكة مع الروس أيضاً كما في الحرب الأولى، عندما أقامت الحكومة البريطانية قيادة عسكرية للعمليات في إيران والعراق، مقرها بغداد، حدَّدت لها هدفين: أولهما، تأمين سلامة حقول النفط في البلدين برَّاً وجوَّاً. وثانيهما، تأمين خطوط الإمداد بالمؤن والمعدات للاتحاد السوفياتي من موانئ الخليج عبر العراق وإيران.
***
إن المسألة المتعلقة بالواقع الجيوبوليتيكي لإيران، إزاء تحالف وتناقض القوتين الدوليتين الأساسيتين القادرتين على التدخل في الشأن الداخلي لإيران، خلال القرنين الماضيين، وهما: بريطانيا في الجنوب وروسيا في الشمال، شكلت، قبل الهيمنة الأميركية، سياقاً تاريخياً متكرراً، يرتكز الى معادلة واضحة: تخاصم بريطانيا وروسيا يريح إيران، وتتعزز وحدتها، ويرتفع منسوب سيادتها، وإذا اتفقتا فعلى حساب إيران وصولاً الى تقسيمها، واضطراب الأمن فيها، وانتشار المجاعة.
لذلك عادت إيران لتصبح دولة شبه مستقلة بفعل الثورة البلشفية في روسيا، فانشغل الروس بشؤونهم الداخلية، وبالحرب الأهلية التي نشبت في أعقابها، وكذلك انشغلت بريطانيا بأولويات مختلفة بفعل الخطر الشيوعي، مما جعل علاقة إيران ببريطانيا تتقونن في اتفاقية بين البلدين، تم عقدها في عام 1919، ولو انها لم تكن معاهدة متكافئة.
في العام الذي انعقدت فيه الاتفاقية الأنكلو – إيرانية، برزت الولايات المتحدة كقوة قائدة للغرب، بشخص رئيسها وودرو ويلسون الذي فرض النفوذ الأميركي على العالم خلال حضوره مؤتمر الصلح في فرساي، بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وهذا العامل الجديد، كان له شأنٌ في المرحلة التالية، ما بين الحربين العالميتين، بعد خلع الشاه رضا بهلوي، على يد بريطانيا، وتنصيب ابنه الشاب محمد رضا بهلوي الذي محضته الولايات المتحدة ثقتها ودعمها لفترة طويلة (37 عاماً)، الى ما قبل الثورة الإسلامية بقيادة الخميني بأيام قليلة.
من هنا يمكن استقراء مغزى الاتصال المبكر للإمام الخميني بالأميركيين، ليس فقط من خلال رسالته الى الرئيس جون كنيدي عام 1963، لكن أيضاً من خلال اتصاله بالرئيس كارتر نفسه، قبيل انتصار الثورة الإسلامية. فقد بعث الخميني رسالته السرية الى الرئيس كارتر من منفاه في ضاحية “نوفل لو شاتو”، بالقرب من العاصمة الفرنسية، يوم 27 كانون الثاني (يناير) من عام 1979، عارضاً فيها على الرئيس الأميركي “صفقة”، مقابل أن يُقنع كارتر قادة الجيش الإيراني تمهيد الطريق له لكي يتسلم السلطة.
قال الخميني لكارتر في تلك الرسالة:
“قادة الجيش الإيراني يستمعون اليك، لكن الشعب الإيراني يستمع الى أوامري. فإذا أقنعتهم بأن يمهدوا الطريق لانتقال سلس للسلطة، فإني أستطيع أن أعيد الهدوء والاستقرار الى الأمة، ونتكفل بحماية مصالح أميركا وسلامة رعاياها”.
ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان كارتر قد ردَّ على رسالة الخميني السرية، أو ما هو ردُّه إذا كان قد ردَّ عليها. لكن المعروف هو أن كارتر هو الذي أقنع الشاه بأن يغادر إيران في “إجازة”، تمنى الخميني أن تكون إجازة دائمة. كما أرسل الى طهران مبعوثاً عسكرياً رفيع المستوى هو الجنرال روبرت هوايزر، من القوات الجوية، في مهمة سرية الى طهران، أثارت قلق الخميني في فرنسا، لأن الجنرال هوايزر كان يعقد اجتماعات يومية مع القادة الكبار في القوات المسلحة الإيرانية. ومصدر قلق الخميني من تلك الاجتماعات أنه كان على يقين تام بأن القيادات العليا في الجيش الإيراني تقف ضده بلا هوادة، ويخشى أن تقوم بانقلاب عسكري، بدعم أميركي، يسد الطريق في وجه الثورة الإسلامية.
عندئذ اتخذ الإمام الخميني قراره بالعودة الى طهران لحسم الأمور قبل فوات الأوان. وقبل سفره عائداً الى بلاده من المنفى لأول مرة منذ خمسة عشر عاما، أصدر نداءً شخصياً الى البيت الأبيض يدعو فيه الأميركيين ألاَّ يقلقوا بسبب خسارة الشاه حليفهم لنحو أربعة عقود، لأنه هو أيضا سيكون صديقهم، قائلاً: لهم: “سوف ترون أنني لا أكن عداوة للأميركيين على وجه الخصوص”، مؤكداً أن الثورة الإسلامية “سوف تكون ثورة إنسانية، تدعم السلم والاستقرار للبشرية جمعاء”.
***
عندما طالت آزمة الرهائن الأميركيين المحتجزين في إيران، لمدة 444 يوماً (من 4 تشرين الثاني / نوفمبر 1979 الى 20 كانون الثاني / يناير 1981)، شاع في أوساط إعلامية وسياسية عديدة حول العالم، أن الإمام الخميني لن يُطلق الرهائن في عهد كارتر، المشرفة ولايته على نهايتها، بل سيطلقهم كبادرة حسن نيَّة الى الرئيس المقبل رونالد ريغان. وبالفعل تم إطلاق الرهائن في اليوم التالي لتنصيب ريغان في البيت الأبيض يوم 20 كانون الثاني / يناير من عام 1981.
ربما كان الإيرانيون يريدون إعطاء مثل هذا الانطباع، لأن عملية إطلاق الرهائن تمت في مستهل ولاية ريغان، أما ترتيبات الصفقة فتعود الى المراسلة السرية بين الخميني وكارتر. والدليل الدامغ على ذلك، أن اتفاقية إطلاق الرهائن المحتجزين في إيران، وقَّع عليها كارتر فور خسارته في الانتخابات الرئاسية، قبل شهرين تقريباً من تنصيب الرئيس الجديد، أي في مطلع شهر تشرين الثاني / نوفمبر 1980، وهي تضم مقابل ذلك إطلاق أموال إيرانية محتجزة في أميركا من أيام الشاه. فليس مستغرباً أن الإمام الخميني تعمَّد إخراج الموضوع وكأنه أخذ من رئيس راحل ليعطي رئيساً مقبل. فقد كان مقتدراً من ناحية توسيع مدى مناوراته التكتيكية بسبب شعبيته الكاسحة في ذلك الوقت. هذه المناورة تشبه إقدامه على مصادرة وإغلاق السفارة الإسرائيلية في طهران، لكنه لم يسلمها الى الفلسطينيين، كما كانوا يتوقعون، مع أن ياسر عرفات في ذلك الوقت انحاز الى الجانب الإيراني في الحرب مع العراق، مستعدياً صدام حسين حليفه السابق في حرب الكويت.
في أعقاب انسحاب القوات الإيرانية من شبه جزيرة الفاو العراقية، في المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية – الإيرانية، منتصف شهر نيسان / أبريل من عام 1988، بعد سنتين من الاحتلال، سئل نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز، ما إذا كان يعتقد أن الخميني سوف يوافق على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، فقال:
“في النهاية، الخميني رجل سياسة، ورجال السياسة يتعاطون مع الواقع، حتى لو كانت النتيجة غير مؤاتية لهم”.
بعد ثلاثة أشهر فقط من معركة الفاو، قبل الخميني وقف إطلاق النار. وكلمته التي نطق بها في حينه باتت كلمة مأثورة: “لقد تجرعت كأس السم”!
(الحلقة المقبلة: مات الشاه… عاش الإمام!)
إشكالية السلم والحرب بين إيران والغرب (1)
“سدادة قنِّينة الجغرافيا”!
سليمان الفرزلي*
عشية رأس السنة الميلادية، يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) من عام 1977، أقام شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي، في قصره بطهران مأدبة عشاء عامرة للرئيس الأميركي الراحل جيمي كارتر، الذي قام بزيارة ملفتة الى العاصمة الإيرانية، بعد أقل من سنة على دخوله الى البيت الأبيض، وبعد شهر واحد فقط من زيارة رسمية قام بها الشاه الى واشنطن، حيث وافق الأميركيون على تزويده بكميات ونوعيات متقدمة من السلاح، ليكون حارس المصالح الأميركية في الخليج والشرق الأوسط.
لم تكن تلك الزيارة مقرَّرة أو مخصَّصة لإيران، لكن كارتر أدخلها ضمن جولة خارجية له، وهو في طريقه من بولندا الى الهند.
في تلك المأدبة، أثار كارتر عجب العالم في خطابه الذي وصف فيه إيران الشاه بأنها “واحة من السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”، في وقت كانت الأرض تميد تحت الشاه وعرشه، مؤذنة بانتفاضة شعبية، أشد قوة، وأوسع مدى، وأعمق جذوراً من أي انتفاضة سابقة، بقيادة آية الله الخميني من منفاه في النجف، بما فيها تلك التي أطاحته في مطلع خمسينات القرن الماضي، بقيادة الدكتور محمد مصدق، ومباركة آية الله الكاشاني من منفاه في بيروت.
قال كارتر في ذلك الخطاب كلاماً مستغرباً في إطراء الشاه، بينما الثورة الإسلامية تغلي تحت السطح:
“إن إيران بقيادة الشاه، هي واحة من الاستقرار والسلام في منطقة من أكثر مناطق العالم اضطراباً، وهذا فخرٌ عظيمٌ لكم يا صاحب الجلالة، ولقيادتكم الحكيمة، ولاحترام شعبكم وتقديره ومحبته لكم”.
وجه العجب في ذلك المشهد، ليس فقط أن كارتر، في موقفه الداعم للشاه على هذا النحو، نقض وعوده الانتخابية، خصوصاً تلك المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان، ومنع انتشار الأسلحة، والسعي الى إطفاء الحروب وإحلال السلام في العالم، بل في غفلة، أو تغافل، أجهزة الاستخبارات الأميركية عما كان يجري تحت السطح في إيران خلال تلك الفترة. والدليل على ذلك، التقرير السري الذي وضعته وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في شهر آب/ أغسطس من عام 1977 حول نظرتها الى إيران في الثمانينات المقبلة، وجاء فيه ما يلي:
“سيبقى الشاه مشاركاً فاعلاً في الحياة الإيرانية لمدة طويلة في فترة الثمانينات، ولن يكون هناك أي تغيير جذري في السلوك السياسي الإيراني للمستقبل القريب”!
***
كان واضحاً لأي مراقب عادي، أن هناك شيئاً غير عادي يجري في داخل إيران، يبدو أن الأجهزة الأميركية أرادت أن تتجاهله، لأنه من الصعب تصديق القول بأنهم لم يعلموا، أو يستشعروا به.
أنا بنفسي لمست غرابة المشهد الإيراني في تلك الفترة تحديداً، من خلال رحلة جوية لي من الكويت، عبر القاهرة، الى باريس، حيث كنت أقيم حينها. فقد اقتضت تلك الرحلة أن أطير الى القاهرة ومنها الى باريس بطائرة فرنسية. لكن الطائرة الكويتية تأخر إقلاعها قرابة الساعة، ففاتني الانتقال الى باريس بالطائرة الفرنسية. وخلال البحث عن وسيلة أخرى، أفادوني في مطار القاهرة بأن هناك طائرة إيرانية متجهة الى نيويورك عبر باريس يمكنك أن تسافر فيها، فوافقت.
وصفت رحلتي الى باريس في تلك الطائرة الإيرانية، في كتابي “علامات الدرب”، كما يلي:
“كان المشهد في تلك الطائرة الإيرانية، مطلع صيف 1977، أول مؤشر رأيته على الوضع السائد في إيران يومئذٍ، قبل أشهر قليلة من انطلاق الثورة الخمينية.
“كانت طائرة ضخمة جداً، لكنها خالية من الركاب تقريباً، باستثناء عدد قليل من الأجانب، ربما كانوا في غالبيتهم من الأميركيين، لا يتجاوز عددهم العشرة أفراد، بمن فيهم عائلة أو عائلتان، بحيث كان عدد طاقم الطائرة أكبر من عدد الركاب… ومع أنني لا أخاف من الطيران، فإنني لا أدري لماذا ساورني القلق خلال تلك الرحلة التي شعرت بأنها طالت أكثر من اللزوم، وأيقنت منذ تلك اللحظة أن الوضع في إيران غير عادي، وأن المشهد داخل الطائرة الإيرانية يدل على شيءٍ ما مختلف أو غير طبيعي، وكتبت في مفكرتي يومها أنني سافرت من القاهرة الى باريس بطائرة إيرانية أشبه ما تكون بطائرة مخطوفة”!
فإذا كان هذا مجرَّد انطباعٍ عابرٍ لملاحظٍ من بعيد مثلي، فهل من المعقول أن أجهزة استخبارات دول كبرى كانت غافلة عما كان يجري، أو يغلي، داخل إيران؟
هناك رأي متداول في الأوساط الإعلامية الأميركية، بأن أجهزة الاستخبارات الغربية لا تبالي بما يجري في البلدان الأخرى من تحركات شعبية، أو نقابية، وما الى ذلك، بل تركز اهتماماتها على مراكز القوى الحاكمة، السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، وفي مدار أدنى على النخب المؤثرة سياسياً وفكرياً، وتعتبر أن هذه الفئة، وغالبيتها في الأوساط الأكاديمية، والثقافية، والعلمية، هي الميزان الأدق لقياس تحولات الرأي العام والمزاج السائد في البلاد.
***
إن العوامل الثلاثة الأهم التي جعلت واشنطن، في مرحلة ما بعد رئاسة جون كنيدي، تعتمد سياسة تعزيز وتقوية إيران الشاه على رقعة الشطرنج العالمية، هي التالية:
أولاً: الانسحاب البريطاني من شرق السويس عام 1968، فلم تعد هناك قوة قادرة على حماية المصالح النفطية الغربية في الخليج، سوى إيران، فاعتمدت واشنطن شاه إيران وكيلاً عنها في تلك المنطقة الحيوية، وحارساً لمصالحها هناك. ولهذا الاعتبار قرَّر الرئيس ريتشارد نيكسون زيادة تسليح إيران، وبمعزل عن رقابة الكونغرس. واستمرت هذه السياسة، وعلى نطاق أوسع وأكثر تطوراً، في عهد الرئيس كارتر من بدايته، بحيث أصبحت إيران السوق الأول للسلاح الأميركي، فبلغت نسبته قبل انتصار الثورة الإسلامية نحو 60 في المئة من مجموع مبيعات السلاح الأميركي حول العالم. على أن الهدف الاستراتيجي الأساس وراء خطة التسليح هذه، محاولة سدِّ الطريق أمام الاتحاد السوفياتي لمنعه من الوصول الى آسيا والشرق الأوسط، وهو ما أطلق عليه بعضهم، من باب توصيف دور إيران في تلك اللعبة، “سدادة قنينة الجغرافيا” لمنع التدفق السوفياتي باتجاه منابع النفط في الشرق الأوسط.
ثانياً: النظرة الأميركية الى العجز السعودي عن القيام بمثل هذه المهمة في حينه، حيث كانت المملكة السعودية ضعيفة عسكرياً، وغير مستقرة سياسياً.
ثالثاً، اشتباك إسرائيل مع جيرانها من الدول العربية، الأمر الذي حرمها من أن تلعب دوراً فاعلاً ومقبولاً في منطقة الخليج.
هذه العوامل، حسب تحليل إدارة كارتر، جعلت إيران الحليف الأوثق، والشريك الأقوى للولايات المتحدة في المنطقة.
الملفت في الأمر، أن الأدبيات السياسية والإعلامية تحدثت مطولاً عن التسليح الأميركي لشاه إيران، حتى من باب حنث كارتر بوعوده الانتخابية، إلاَّ أنها لم تذكر سوى القليل وبالتلميح فقط عن موافقته على بيع طائرات “أواكس” للإنذار المبكر الى إيران.
طلب الشاه تزويده بأسطول من عشر طائرات “أواكس”، لكن كارتر وافق على سبع طائرات، فتحرَّك الكونغرس لمناقشة الصفقة، وبالنتيجة وافق على عدد أقل وبشروط مشدَّدة، لكن الاضطرابات الإيرانية تسارعت فطويت الصفقة مع سقوط الشاه. وهناك رواية أخرى تفيد بأن كارتر هو الذي أحال الموضوع الى الكونغرس، الذي أبدى تحفظات جديَّة على الصفقة، بدعوى أنه من غير الممكن ضمان أمن أدوات إلكترونية متقدمة في بلد مثل إيران. واحتج آخرون بأنه من الممكن أن تتسرب أسرار “الأواكس” إما بالتجسس التقليدي، أو بمحاولة خطف طائرة منها، على غرار محاولة خطف طائرة “ميراج” الفرنسية من لبنان!
الباحثان الأبرز في هذا الموضوع، كريستيان آمري ولوقا ترنتا، لم يتطرقا الى صفقة “الأواكس” إلاَّ بأقل من فقرة واحدة، الأول في كتابه الصادر عام 2013 بعنوان: “السياسة الخارجية الأميركية والثورة الإيرانية”، والثاني في بحثه بعنوان: “بطل حقوق الإنسان يقابل ملك الملوك: جيمي كارتر والشاه، والأوهام الإيرانية الغاضبة”، لكن بعد أن وضع الكونغرس يده عليها لمناقشتها وإقرارها، بعد تغييبه عن الموضوع في عهد نيكسون، كان قد تأخر الوقت لبحثها في العمق بسبب الثورة الإسلامية وسقوط الشاه. وقد صدر في منتصف هذا الشهر، أغسطس 2025، كتاب للصحافي سكوت أندرسون، الكاتب في “مجلة نيويورك تايمز” بعنوان “ملك الملوك: سقوط الشاه وثورة 1979 وتفكيك الشرق الأوسط الحديث”، لم أقرأه بعد لإسناد هذا الموضوع. والمعروف أن “مجلة نيويورك تايمز” خصصت عددا كاملاً لأول مرة في تاريخها الطويل عن تغطيات سكوت أندرسون للشرق الأوسط في عام 2016.
لكن ما شجَّع كارتر على السير في مشروع تسليح إيران، دراسة أعدَّها مجلس الأمن القومي، خلاصتها أن إيران هي المنطقة المحتمل أن تنفجر فيها “أزمة مواجهة” مع الاتحاد السوفياتي.
أما الأمر الأهم الذي لفه الصمت المطبق هو اللقاء الذي جرى بعد خمسة أيام فقط من دخول كارتر الى البيت الأبيض، في 25 كانون الثاني (يناير) 1977، بين سفير الشاه في واشنطن أرداشير زاهدي ومستشار كارتر للأمن القومي زبيغنيو بريزنسكي، حيث فاتحه السفير الإيراني برغبة الشاه في إقامة برنامج نووي للأغراض السلمية، وهو مشروع رفضه الرئيس جيرالد فورد، خلف نيكسون، وسلف كارتر. ويؤكد بعض المراقبين لتلك المرحلة أن الرئيس كارتر وافق على هذه الفكرة من غير تردُّد!
ما يثبت ميل كارتر الى النظر بإيجابية بشأن البرنامج النووي الإيراني المقترح من زاهدي، أن نائب وزير الخارجية الأميركي في حينه، وارن كريستوفر، أصدر مذكرة بمواضيع البحث بين كارتر والشاه قبل وصول الرئيس الأميركي الى طهران، تتضمن خمس قضايا: السلاح، الطاقة، المخاوف النفطية، التعاون النووي، واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.
***
كثيرون أنحوا باللائمة على الرئيس كارتر لتدهور العلاقات الإيرانية – الأميركية. لكن كارتر ليس الرئيس الأميركي الوحيد الذي أخطأ التقدير في هذه المسألة. فقد سبقه بعض أسلافه على هذا الطريق، أبرزهم الرئيس ريتشارد نيكسون. لكن ما ميَّز كارتر عن أسلافه، أن سوء تقديره كان فاقعاً، ومن بداية رئاسته اليتيمة، واستمر حتى تخليه عن الشاه في اللحظة الأخيرة.
مع ذلك، فإن كارتر لم يشذّ عن السياق التاريخي للعلاقات الأميركية – الإيرانية خلال قرن من الزمن، كما وصفها المؤرخ والديبلوماسي الأميركي السابق جايمس بيل في كتابه “الأسد والنسر: مأساة العلاقات الأميركية – الإيرانية (مطبعة جامعة يايل 1988 )، بقوله:
“قلة من العلاقات الدولية انطلقت من منطلق إيجابي مثل الاتصالات التي تميزت بها الاتصالات الإيرانية – الأميركية”.
يمكن تصنيف العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وإيران في ثلاث مراحل:
الأولى، من 1830 الى 1940 هي مرحلة استكشافية غير رسمية، قامت على محاولة من المؤسسات البروتستانتية للتبشير في أوساط معينة من الإيرانيين، استهدفت في الدرجة الأولى الطائفة المسيحية النسطورية (الأشورية)، واستهدفت أيضاً تحويل الطائفة الزرادشتية، وهي أقلية في المجتمع الإيراني، لتحويلها الى المسيحية، وهذه البداية نجحت قليلاً بين النساطرة ولم تنجح قط بين الزرادشتية. هي أشبه بمحاولة الإرساليات الأميركية الأولى الى لبنان لتحويل الدروز الى مذهبها، وفشلت.
قامت البعثة البروتستانتية الأولى الى إيران على مبشرين مرموقين كان لأحدهما تأثير ثقافي عميق في لبنان تاليا، هو الدكتور إيلي سميث، الذي كان يتقن اللغة العربية شفاهاً وكتابةً، وهو من أدخل أول مطبعة بالحروف العربية الى سوريا عام 1834. أما الثاني فهو هاريسون غراي أوتيس وايت، وقد قطعا معاً مسافة 2500 ميل من أرمينيا، الى جورجيا، الى شمال غرب إيران (أذربيجان).
لم تنجح الإرساليات الأولى الى إيران بالتبشير، فانتقل سميث الى بلدة عبيه في لبنان، حيث راح يُصدر شتى أنواع الكتب باللغة العربية، ثم عكف على ترجمة “الكتاب المقدس” (العهد القديم، والعهد الجديد، وأعمال الرسل) الى اللغة العربية، لكنه توفي قبل أن ينجز هذه الترجمة، فتولى إكمالها مبشر بروتستانتي آخر هو الدكتور كرنيليوس فان دايك، الذي عمل أستاذاً في الكلية الإنجيلية التي أصبحت تالياً “الجامعة الأميركية في بيروت”. لكن الإرساليات البروتستانتية التالية، وإن لم تنجح في التبشير المسيحي، فقد نجحت نجاحاً باهراً في إنشاء المدارس والكليات العصرية، بما فيها مدارس البنات. وحققت نجاحاً باهراً في الحقل الطبي، حيث أقامت مستشفيات حديثة في معظم المدن الإيرانية الكبرى، وكلية لتدريس الطب الحديث، فاستقطبت تلك المؤسسات التعليمية والصحية كثيرين من النخب الذين صار لهم شأن بعد تخرجهم منها في الحياة السياسية، والثقافية، والاقتصادية. وكان هذا التوجه أنجح وأنسب للحكومة الأميركية من تحويل بعض الإيرانيين الى المسيحية البروتستانتية.
الثانية، من 1945 الى 1979، وهي حقبة تقررت فيها التوجهات السياسية لإيران الحديثة، بعد جلاء الجيوش السوفياتية والبريطانية من إيران في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فحل النفوذ الأميركي، لأسباب جيو استراتيجية تتعلق بالحرب الباردة بين موسكو وواشنطن، ولكون إيران مصدراً عالمياً مهماً من مصادر الطاقة النفطية، وعلى مقربة من حقول النفط العربية في الخليج التي تديرها الشركات الأميركية والبريطانية بالدرجة الأولى.
كان النفوذ الأميركي في إيران خلال هذه المرحة (مرحلة الحرب الباردة) شبه مطلق، بالرغم من وجود حزب شيوعي، هو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط (حزب توده)، وبالرغم من وجود حوزات دينية شيعية نافذة في الأوساط الشعبية. وعندما نجحت الحركة الوطنية الإيرانية، بقيادة محمد مصدق، في عزل الشاه مطلع الخمسينات من القرن الماضي، قامت الولايات المتحدة، من خلال وكالة الاستخبارات المركزية، بترتيب انقلاب على الانقلاب، وأعادت تنصيب الشاه المخلوع على “عرش الطاووس”، ومعه ضمانات واسعة للمصالح النفطية الأميركية والبريطانية. ولخلع الشاه، وإعادة تنصيبه بوصاية خارجية، نظير في التاريخ الإيراني القديم سوف نتناولها في حلقة مقبلة.
الثالثة، من 1979 الى اليوم، وهي ما يمكن وصفه، حتى الآن، بأنها “مرحلة الفراق”. ذلك أن الحرب الأميركية – الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، ما زالت غامضة، حتى في هدفها المعلن، وهو تعطيل البرنامج النووي الإيراني. هذا الهدف المعلن يبدو مجرد حجة تخفي هدفاً آخر غير معلن، لإن إدارة كارتر قبل تخليها عن الشاه في اللحظة الأخيرة، كانت تنظر بإيجابية الى مطلب الشاه، الذي أفصح به سفيره في واشنطن الى المستشار بريزنسكي (كما مرَّ)، بالمساعدة على إقامة برنامج نووي للأغراض السلمية.
نتائج هذه المرحلة، لا يمكن البحث فيها بالتكهنات، لأنها ما زالت جارية، وقد تطول المدة الزمنية لجلائها، لكنها ستكون، متى انجلت، مرحلة حاسمة في التاريخ الإيراني الحديث.
(الحلقة المقبلة: “آية الله والشيطان”)